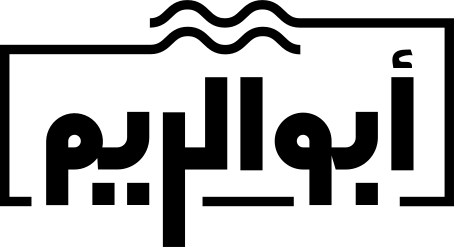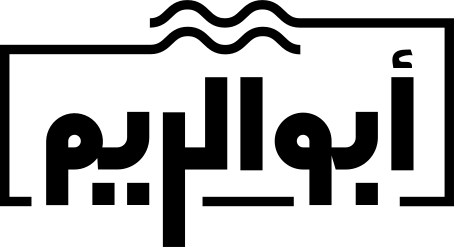[vc_row][vc_column][vc_column_text]عثرتُ قبل بضعة أيّامٍ على مذكرة استخباريّة أعدّها مُحللو وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة عن قطاع غزّة عام 1965، أي حين كان القطاع لا يزال تحت سلطة حكومة القاهرة. المُذكّرة التي صُنّفت كمادّة سريّة لا تنطوي في الحقيقة على أي معلوماتٍ حسّاسة، بل هي أقرب ما يكون لورقة حقائق مُكثّفة تتناول جوانب مُختلفة من الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للقطاع في ذلك الوقت. وقد أُجيز نشر المذكرة في بدايات العام 2000 تطبيقا لمبدأ حريّة المعلومات التي تعمل به أجهزة الأمن الأمريكيّة.
جريا على نمط التقارير الاستخباريّة الكلاسيكيّة، فقد بدأت المذكّرة بتقديمٍ مُختصرٍ للموقع الجغرافيّ للقطاع ولوضعه القانونيّ منذ النكبة، ولهيكل الإدارة العسكريّة المصريّة فيه، بالإضافة لأهمّ المؤشّرات السكانيّة، مع تركيزٍ خاص على اللاجئين والخدمات التي تُقدّمها وكالات الأمم المتحدة لهم. قدّمت المذكرة بعد ذلك عرضا ثريّا بالأرقام عن قطاع التعليم، قبل أن تُعطي لمحة عن اقتصاد قطاع غزّة وأهمّ موارده الماليّة وأبرز قطاعاته التشغيليّة، مع شرحٍ مُركّز عن القطاع الزراعيّ وطبيعة التربة وموارد المياه وتأثيرهما على مواسم الحصاد.
قراءة المذكرة لا تخلو من طعم المرارة الممزوج بالأسى. فرغم أنّ عمرها يقترب الآن من ستّة عقود، إلا أنّ قارئها سيتملّكه بلا ريب، شعورٌ قويّ بأنّها تتحدّث عن غزّة الحاضر بمقدار ما تتحدّث عن غزّة الأمس: المشكلات ذاتها، والإحباطات ذاتها، والآمال الزائفة بأن يكون لهذا الشريط الساحليّ الضيّق بوّابة حرّة مفتوحة على العالم الواسع هي ذاتها أيضا. سيكتشف المرء أنّ الجريمة الكبرى التي لحقت بهذا المكان هي أنّ الزمن وُضع في زجاجة مُحكمة الإغلاق أُلقيت في البحر… إنّه ليس متوقفا عن الدوران فحسب بل ضائعٌ أيضا.
لقد ارتأيتُ ترجمة بعضٍ من أقسام المذكرة لسببين رئيسيين. الأوّل هو أنّ الحقبة المصريّة من تاريخ القطاع كانت ولا تزال نقطة عمياء، المواد المكتوبة عنها شحيحة للغاية، ولذلك فإنّ أي إضافة مهما كانت صغيرة في هذا الصدد يمكن لها المُساهمة في سدّ فجوة كبيرة عن فترة امتدّت لحوالى عقدين من الزمن ولا نعرف عنها الكثير. أمّا السبب الثاني فهو أنّ استخلاصات مُحللي وكالة الاستخبارات المركزيّة بشأن آفاق التنمية في القطاع تبقى صالحة حتّى في يومنا هذا، وهي ترتكز إلى حقيقة لا نحبّ أن نواجهها كثيرا تقول بأنّ القطاع حتّى في أحسن أحواله على مستوى الموارد لن يكون قادرا على توليد العدد الكافي من الوظائف التي تكفل معيشة لائقة لسكّانه. يمكن الحصول على المذكرة بالإنجليزيّة من هُنا.
السكّان والأونروا
في عام 1946، قدّرت إدارة الإحصاء في فلسطين أن حوالى 72,000 شخص، بما في ذلك 500 بدويّا، يعيشون في المنطقة المعروفة الآن بقطاع غزة. وبحلول نهاية عام 1949، زاد تدفق اللاجئين إلى المنطقة ليصل إجمالي السكّان إلى 280,000 شخص. وفي نهاية يونيو 1964، كان هناك أكثر من 400,000 شخص يعيشون في القطاع، وكان حوالى 290,000 شخص، أو حوالى 72 في المئة من إجمالي السكان لاجئين. معظم السكّان يتركزون في تجمّعات مكتظّة نسبيّا، بما في ذلك مخيمات اللاجئين. حوالى 100,000 شخص يعيشون في خان يونس، وحوالى 50,000 في مدينة غزة، بينما يعيش 7,000 شخصا في قرية رفح، وأعداد أصغر في التجمعات الأخرى. أكثر من 183,000 شخص، أي 45 في المئة من إجمالي السكان، يعيشون في ثمانية مخيمات للاجئين ممتدة على طول القطاع. على الرغم من كثافة السكان التي تصل إلى حوالى 2,900 شخص في الميل المربع، إلا أن هناك مناطق توجد بها أعداد قليلة من السكان. وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض مناطق الكثبان الساحلية وأجزاء من القطاع جنوب شرق خان يونس.
البلدات والقرى القديمة لا تزال بدون كهرباء أو صرفٍ صحّي وهي تحتفظ بنكهة الشوارع الضيّقة والمتسخة للمجتمع العربيّ. أما بناء المساكن السكنيّة الجديدة بين مدينة غزّة والشاطيء، فهو مخططٌ بنمطٍ مستطيل من أجل كثافة سكّانية منخفضة. تقع في هذا الحيّ الجديد الفيلات المريحة لملاك الأراضي التقليديين وشقق موظفي الأمم المتحدة وأصحاب المتاجر المحليّة. تمتد الأندية والكازينوهات والمطاعم على طول الشاطيء على مسافة قريبة من مخيّم الشاطيء الذي يضمّ 28,000 لاجئا.
في البداية، سعى اللاجئون للحصول على ملجأ في المساجد والثكنات والأماكن المؤقتة. وتلا ذلك تأسيس مخيمات الخيام قبل أن تُعطى الأفضلية للهياكل الدائمة المُخطط لها بنمطٍ مستطيل مميّز على الأراضي الرمليّة أو المواقع غير الصالحة للزراعة. تُشيّد المساكن القديمة من الطين والقصب، ولكن المساكن الأحدث جرى بناؤها باستخدام كتل الخرسانة المُصنّعة محليّا. المدارس المستطيلة ذات الطابق الواحد والعيادات والمكاتب والمستودعات تملأ المناطق المفتوحة في محيط المخيّمات. وتزخر صفوف الأكشاك الصغيرة في المخيمات بالأشخاص الذين يُسمح لهم بالتجوّل والتعامل بحريّة مع العامّة، ولكنهم ممنوعون من مغادرة قطاع غزّة بدون إذن من السلطات المصريّة.
السمة البارزة لسكان قطاع غزّة هي زيادتهم السريعة. من بين الأشخاص البالغ عددهم 240,624 شخصا، والذين كانوا مُستحقين للرعاية الأساسيّة في يونيو 1964، كان 3 في المئة منهم تحت سن عام واحد، ونسبة 41 في المئة من سنة واحدة إلى 15 سنة، ونسبة 56 في المئة من فوق سن الخامسة عشرة. إن التوقعات لعدد السكّان حتى عام 1980، استناداً إلى زيادة طبيعية مقدرة بنسبة 2.5 في المئة سنوياً، تشير إلى إن إجمالي السكّان سيزيد على 600,000 نسمة، حيث سيكون 430,000 نسمة منهم من اللاجئين المسجّلين في عام 1964. حالياً، يمكن دعم حوالي 80,000 نسمة فقط من السكان بالموارد المتاحة في القطاع.
بحلول نهاية يونيو 1964، ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة إلى 289,155 لاجي، منهم 240,624 لاجيء يتلقون مساعدات أساسية، و48,531 لاجيء يتلقون خدمات أخرى. وكان اللاجئون المسجلون في غزة يشكلون 23 بالمئة من إجمالي عدد اللاجئين العرب الذين يتلقون مساعدات من “الأونروا” من جميع البلدان.
إحدى أهم مسؤوليات الأونروا هي إدارة ثماني مخيمات لللاجئين، تتراوح في حجمها بين 7,000 لاجيء وأكثر من 43,000 شخص. ومع ذلك، يتضمن إجمالي سكان المخيمات أكثر من 183,000 شخص، ومع ذلك يشكلون فقط 63 بالمئة من اللاجئين المسجلين. بينما عثر البقية على أماكن للعيش في القرى والبلدات في جميع أنحاء القطاع. يتضمن كل مخيم خدمات مثل العيادات ومراكز التغذية والمدارس لخدمة كل من سكان المخيم والمسجلين الذين يعيشون في أماكن أخرى في القطاع.
كانت ميزانية “الأونروا” لقطاع غزة في عام 1963 أكثر من 7.6 مليون دولار أمريكي. تُخصص الأموال لثلاثة مجالات رئيسية من النشاط – 45 بالمئة للإغاثة، و42 بالمئة للتعليم والتدريب، و13 بالمئة للصحة. العائلات التي دخلها أقل من 15 جنيهًا مصريًا في الشهر مؤهلة للحصول على مساعدات أساسية. النفقة على الطعام للاجئ واحد ليوم واحد تقل عن 4 سنتات، والنفقة الإجمالية لكل مسجل تقدر بحوالي 7.5 سنتات في اليوم. ثلاث منظمات تطوعية – CARE، والبعثة البابوية لفلسطين، ولجنة مجلس الشؤون المسيحية في الشرق الأدنى للعمل مع اللاجئين – تتعاون مع موظفي الأونروا في أنشطة الإغاثة لللاجئين وتعمل أيضًا بالتعاون مع جمهورية مصر العربية لمساعدة الأشخاص المحتاجين والذين ليسوا مسجلين في سجلات “الأونروا”.
المساعدات الأساسية، التي يتم توزيعها مرة كل أسبوعين على المسجلين المؤهلين، تشمل ما يكفي من الطحين والبقول والسكر والأرز والزيوت والدهون لتوفير 1500 سعرة حرارية يوميًا. يتم زيادة تخصيصات البقول والطحين خلال شهور الشتاء من نوفمبر إلى مارس ليصل إجمالي عدد السعرات الحرارية في المساعدة إلى 1600 سعر حراري. الأفراد يتلقون أيضًا قطعة واحدة من الصابون شهريًا، وبطانية واحدة كل ثلاث سنوات، و3-3.75 باوند من الملابس المستعملة سنويًا، و0.35-0.45 من الكيروسين شهريًا خلال فصل الشتاء. الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين في حاجة إلى تغذية إضافية يُخدمون في مراكز توزيع الحليب ومراكز التغذية الإضافية. العديد من هؤلاء الأشخاص يتلقون كوبًا من الحليب يوميًا أو وجبة ساخنة تحتوي على 700 سعر حراري يوميًا. التداول النشط للمساعدات في الأسواق المحلية يسمح بإضافة بعض الفواكه والخضروات والأسماك أو التمور إلى النظام الغذائي للعديد من الأشخاص ويرفع متوسط استهلاك السعرات الحرارية إلى حوالي 2000 سعر حراري يوميًا.
إنّ الزيادة المضطردة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة تفرض ضغطًا شديدًا على قدرة “الأونروا” في الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها. حاليًا، هناك حوالي 20,000 طفل في قطاع غزة مسجلون على قوائم الانتظار للحصول على المساعدات الغذائية، ويزيد هذا الرقم بمعدل حوالي ألف شخص إضافي في الشهر. يتم إضافة الأطفال المستحقين عادة إلى قوائم المساعدات من قائمة الانتظار بينما يتم حذف الأشخاص غير المستحقين من القوائم، وهذه مهمة لا يمكن تنفيذها بشكل عادل دون تعاون الحاكم العام المصري واللاجئين أنفسهم. تقدر الأونروا أن حوالي 34,500 من الأسماء على قوائم المساعدات تم تضمينها بشكل غير قانوني، لأنها تمثل أشخاصًا قائمين بأنفسهم أو مسجلين بشكل كاذب أو متوفين. وُتشير التقديرات التي أعدتها السفارة الأمريكيّة في بيروت بشكلٍ مستقبل إلى أنّ عدد مثل هذه الحالات غير المستحقة للدعم قد وصلت إلى 37,500 شخصا.
التعليم
تُدعم مرافق التعليم والتدريب بشكلٍ رئيسيّ من الأموال التي تُقدّمها الأمم المتحدة، والتي كانت كافية في نهاية يونيو 1964 لتمكين “الأونروا” من تشغيل 91 مدرسة ابتدائية ومدرسة بإجمالي تلاميذ بلغ 38,905 و13,627 على التوالي. على عكس العديد من المجتمعات العربية التي تشهد حضورًا محدودًا للفتيات في المدارس، تبلغ نسبة الفتيات في المدارس بقطاع غزة 48 في المائة من تلامذة المدرسة الابتدائية و44 في المائة من تلامذة المدرسة الإعدادية. تُعقد الدروس باللغة العربية، ولكن اللغة الإنجليزية هي مادة إلزامية لدى 7,569 طالبًا مسجلين في المدارس الثانوية (الصفوف العاشرة والحادية عشرة). تدير الحكومة في قطاع غزة جميع المدارس الثانوية، لكن الأونروا تدفع منحة دراسية لـ 4,500 من الطلاب. خلال العام الدراسي 1963-1964، كان هناك 190 طالبًا من قطاع غزة يدرسون في جامعات متنوعة بمنح دراسية من الأونروا. ومع ذلك، تظل الدول العربية التي تعاني من مشكلات اللاجئين الخاصة بها غير راغبة في قبول الطلبة اللاجئين من غزة. أما مركز تدريب المعلمين الذي تديره الحكومة، فقد سجّل فيه 229 شخصا في العام الدراسي 1964-1965.
تُدير “الأونروا” مركزين للتدريب المهني لعدد قليل من اليافعين في مدينة غزّة وبيت حانون. يمكن للمركز في غزّة استيعاب 368 طالبًا، وفي العام الدراسي 1964-1965 كان هناك 800 متقدم للحصول على أحد المقاعد الـ 150 المتاحة. بناءً على اتفاق خاص، يمكن للخريجين المتميزين من الدورة التجارية لمدة سنتين في غزة أن يقضوا سنة إضافية في المدارس الفنية أو التدريب في مصانع جمهورية مصر العربية. يتّبع مركز التدريب في بيت حانون منهجًا مصريًا في تدريب اليافعين في مجال الزراعة والتسويق. ومع ذلك، فإن مستوى التحصيل في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في المدارس العامة منخفض بما يكفي ليدفع مراكز التدريب المهني لتقديم دورات عامة لرفع مستوى الطلاب للمستوى المطلوب للتدريب. تُقدم دورات مهنية قصيرة في مواضيع مثل النجارة أو الخياطة لبعض الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم المؤهلات اللازمة للتسجيل أو لمن لا تتاح لهم أماكن في مراكز التدريب المهني. يصل فقط 25 في المائة من الأولاد والبنات في قطاع غزة إلى سن الثامنة عشرة مع تعليم ثانوي محدود أو تدريب مهني أدنى، ومعظمهم لا يجدون فرص عمل مفيدة، بينما لدى الأغلبية غير المتعلمة وغير المُدربة قليل من الأمل في دعم أنفسهم.
الاقتصاد والزراعة
كانت غزة منطقة مزدهرة نسبيا قبل اندلاع الأعمال العدائيّة بين العرب والإسرائيليين عام 1948. كانت مدينة غزة تقع على طريق القوافل التقليدية حول الجزء الشرقيّ من البحر المتوسّط، وكان لها أهمية محلية كمنفذ لحدود فلسطين، وكمركز تجاريّ على خطّ السكة الحديدية، وكمنتجع ساحلي صغير. كان العديد من سكان المنطقة يمتلكون مزارع حمضيات أو يعملون فيها، ويزرعون القمح والشعير، أو يرعون قطعانًا من الماشية في الأراضي التي تقع خارج الحدود الحالية لقطاع غزة. عندما تم فصل هؤلاء الأشخاص عن معظم الأراضي التي كانوا يعملون عليها وعن الأسواق التقليدية، تراجع اقتصاد القطاع بشكل ملحوظ. في عامي 1948 و1949، لم تكن غزّة مُستعدّة لاستقبال ودعم الجموع الهائلة من اللاجئين الذين اجتاحوا المنطقة التي لا تستطيع اليوم توفير فرص عملٍ مربحة لمعظم السكّان والذين لا يملكون أصلا مهاراتٍ متخصصة.
تدخل الإيرادات إلى قطاع غزة من خلال صادرات الحمضيات، وبيع السلع الاستهلاكية، وإنفاق القوة الدولية لإنفاذ السلام (UNEF)، وتحويلات الفلسطينيين خارج القطاع، بالإضافة للنفقات الحكوميّة. في عام 1964، حققت صادرات البرتقال حوالي 5 مليون جنيه مصري من العملة الأجنبية، وبيع السلع الاستهلاكية اليابانية للمصريين الزائرين جلب نحو 500,000 جنيه مصري. تبلغ نفقات القوة الدولية لإنفاذ السلام حوالي مليون جنيه مصري سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينيّة (1 جنيه إسترليني = 2.79 دولار أمريكي) إلى القطاع من قبل الفلسطينيين الناجحين في الكويت ولبنان ومناطق أخرى. عادةً ما يتم توجيه هذه التحويلات من خلال تجار غزة بدلاً من البنوك المصرية. تسهم جمهورية مصر العربية بنسبة تقدر بحوالي 90 في المائة من تكلفة الحكومة المحلية؛ ولمدينة غزة وحدها، يبلغ هذا الرقم حوالي 200,000 جنيه مصري سنويًا. يكون إنفاق القوة الدولية لإنفاذ السلام أساسًا بالعملة الصعبة، لكن صادرات الحمضيات تجلب كميات كبيرة من العملة المصريّة.
بحسب القانون، تدخل إيرادات الحمضيات النظام المصرفيّ المصريّ. على الرغم من أن السعر الرسمي للصرف هو جنيه مصري واحد مقابل 2.30 دولار أمريكي، وأن السعر التجاري من خلال البنوك في بيروت هو جنيه مصري واحد مقابل 1.75 دولار أمريكي، إلا أن الجمهورية العربية المتحدة تتجاهل سعر السوق السوداء البالغ جنيه مصري واحد مقابل 1.33 دولار أمريكي والذي يسود في قطاع غزة. ومع ذلك، فإنّ القليل من الأموال التي تدخل القطاع تصل إلى أيدي اللاجئين الذين يُعدّ التضخم مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. فقد زادت تكاليف المعيشة بأكثر من مرتين خلال العشر سنوات الماضية، لكن متطلبات التأهل للحصول على المساعدات بقيت كما هي بدون تغيير.
أكبر جهة تشغيل في قطاع غزّة هي الحكومة العسكرية المصرية، والتي توظف حوالى 7,000 شخص. حوالي 3,000 من الموظفين في الحكومة هم معلمون، جرى اختيار معظمهم من بين اللاجئين أنفسهم. تقدم الصناعة المحلية عددًا قليلًا نسبيًا من فرص العمل الثابتة، حيث تقتصر على عمليات صغيرة مثل تعبئة الفاكهة وصناعة الصابون وتعبئة المشروبات الغازية وصيد الأسماك. توظف الأونروا حوالي 3,600 شخص، وجميعهم، إلا عدد قليل منهم، من الفلسطينيين. وتضم القوة الدولية لإنفاذ السلام (UNEF) فريقًا محليًا يزيد على 1,500 شخص وتوظف أحيانًا ما يزيد على 6,500 شخص إضافيين لأعمال البناء ووظائف فردية. تتوفر حوالي 35,000 إلى 40,000 وظيفة في الزراعة، ولكن معظم العمل الزراعي موسمي ولا يدفع أجورًا تكفي للعيش.
كانت الزراعة وسيلة تقليدية للعيش بالنسبة للعديد من اللاجئين بالإضافة للسكّان الأصليين للقطاع، وإذا كان بالإمكان توفير المزيد من المياه، فإن عدد الأشخاص الذين يعملون في الزراعة سيرتفع بشكل كبير. التربة الطينية في النصف الشمالي من القطاع هي الأكثر إنتاجية. تربة النصف الجنوبي أكثر رملية، ولكن لديها قدرة جيدة على احتجاز الرطوبة. المناطق الساحلية تتألف أساسًا من رمال الكثبان، ولكن العديد من الأماكن المنخفضة تحتوي على ما يكفي من الرطوبة لزراعتها بنجاح. على الرغم من أن التربة في المنطقة تتعرض لتآكل شديد بفعل الرياح والمياه، إلا أنّه يُمكن زراعتها بشكلٍ إنتاجيّ إذا جرى تسميدها وريها بشكلٍ صحيح. ومع ذلك، تعتمد جميع مناطق القطاع تقريبًا على إمدادات مياه غير مستقرة.
في الجزء الشمالي من القطاع، يأتي الماء اللازم لزراعة المحاصيل المروية من الآبار. تحمل الطبقات الجوفيّة المياه من مصادر شرق وشمال القطاع، ولكن الهيكل الصخري تكوّن بطريقة تمنع من وصول طبقات الماء العذب إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لا يمكن للمياه المالحة من البحر أن تلوث هذه المصادر من المياه العذبة. على الرغم من الضخ الكثيف، إلا أن جودة المياه المتاحة في الشمال لم تتدهور كثيرًا. ومع ذلك، فإنّ مياه البحر تسربت إلى طبقات المياه العذبة في مناطق جنوب القطاع، ومعظم الآبار هناك مالحة جدا لدرجة أنها لا تصلح لريّ أي محصول باستثناء نخيل التمور. لم يتم إجراء دراسات مُكثّفة حول المياه الجوفيّة في جميع أنحاء القطاع حتى الآن، ولكن هنالك مخاوف من أنّ الضخ المُفرط من الآبار في الشمال قد يؤدي إلى تسرب المياه المالحة من المناطق الداخليّة في الجنوب.
حوالي 50,000 فدان، أو أكثر قليلاً من نصف مساحة القطاع، تُزرع في سنوات هطول المطر العادي. من هذه المساحة المزروعة عادةً ما يُخصّص حوالي 35,000 فدان للزراعة الجافة وحوالي 15,000 فدان للري. الفواكه الحمضية هي أهم منتج زراعي، ولكن يتم إنتاج كميات كبيرة من البطيخ والخضروات ويتم تخصيص مساحات كبيرة لزراعة المحاصيل الحقلية. المناخ المعتدل في المنطقة يسمح بزراعة الخضروات المروية مرتين في العام. ويُزرع العنب والتين والمشمش واللوز والموز والزيتون والذرة الشامية والتبغ وحبوب الخروع بكميات صغيرة نسبيًا للاستهلاك المحلي. لا تُربّى المواشي بكثرة لأنها تعتمد على بقايا المحاصيل أو العلف المستورد، إذ لا يتوافر العلف في القطاع.
معظم الأراضي التي تُستخدم عادة للزراعة الجافة تُزرع بالحبوب. معدل الأمطار السنوي في الشمال حوالي 15 بوصة، وفي الجنوب تقريبًا 8 بوصات، ولكن كميات الهطول تتغير بشكل كبير سواء من حيث الكمية المتساقطة أو الوقت الذي يتم فيه الهطول. يتساقط القليل جدا من الأمطار خلال فصل الصيف، وفي بعض السنوات يحدث معظم الهطول الكلي في هطول واحد أو اثنين. عندما يحدث ذلك، يضيع الكثير من المياه وتتضرر الأراضي الزراعية بشكل كبير. في السنوات الأخرى، قد لا تكون هناك أمطار تقريبًا أو قد تأتي الأمطار في وقت متأخر جدًا أو مبكر جدًا من الموسم مما يجعلها غير كافية للحصاد الجيد. في السنوات الجافة جدًا، مثل موسم 1960-1961، يتم زراعة أقل من نصف المساحة التي تُستخدم عادة للزراعة الجافة. الزراعة غير المروية تواجه صعوبة إضافية لأن أشهر الجفاف، من مايو إلى سبتمبر، هي أيضًا أكثر أشهر السنة حرارة.درجات الحرارة نهارًا في هذا الوقت من السنة قد تصل إلى حوالي 100 درجة فهرنهايت، ولكن في المتوسط، درجات الحرارة القصوى اليومية هي حوالي 86 أو 87 درجة فهرنهايت.
تقريبًا 13,500 فدان من أصل 15,000 فدان من الأراضي المروية مزروعة بمزارع حمضيات، بما في ذلك تلك التي تم زراعتها مؤخرًا على مساحة تبلغ 3,500 فدان من الأراضي الرملية والتي تُروى عبر قنوات خرسانية. يُقدّم محصول الحمضيات الفائض الوحيد الصالح للتصدير. تم تحقيق أسعار جيدة في شرق أوروبا لأفضل أنواع البرتقال، وتحقق أصناف الثمار التي لا تصل للمواصفات مبالغ تقريباً مماثلة في الأسواق العربية. ومع ذلك، لا تأتي أشجار الحمضيات بثمارٍ تجاريّة حتى تبلغ سن السابعة، وما يقرب من نصف المزارع لم تصل بعد إلى هذا العمر. نتيجةً لوسائل الرش والتسميد والري غير الفعّالة، فإن العديد من الأشجار المُثمرة لا تحقق إمكانيتها الكاملة سواء من حيث الكمية أو جودة الثمار، وحوالى 50 في المائة من الإنتاج هو من الفواكه ذات الجودة المنخفضة.
يبدو أن التخطيط من قبل وكالات الأمم المتحدة لزيادة الإنتاج الزراعي في القطاع كان ضئيلًا بسبب الآفاق المحبطة للحصول على إمدادات إضافية من المياه. تقع مواقع الخزانات مثل منبع وادي غزة وجزء كبير من الأراضي الزراعية التي كان يستخدمها سكان غزة خارج الإقليم المشمول في قطاع غزة اليوم. التوسع الحالي في الأراضي الزراعية يجري بطريقة عشوائية دون الاستفادة من تحليل التربة أو اختبارات الضخ لطبقات المياه الجوفيّة المعروفة. حيثما توفرت مياه الآبار، فقد شجعت الترب الصالحة والعمالة الرخيصة وأسعار السوق الجيدة رواد الأعمال المحليين على زراعة مزارع حمضيات جديدة بمعدل 750 فدان في السنة. يبدو أن هناك قلقًا قليلًا بشأن التهديد الناجم عن ضخ زائد لمصادر المياه الحالية. حاليًا، تهدر مياه الري بسبب عدم فهم العلاقات بين التربة والمياه في زراعة الحمضيات والمحاصيل الأخرى بشكل كاف. سيتعين تحديد ما إذا كان مشروع إسرائيلي حالي لحقن المياه في الطبقات الجوفيّة للسهول الساحلية سيكون له تأثير إيجابي على إمداد المياه للآبار في غزة.
استخلاص أخير
تفاقمت مشاكل قطاع غزّة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ولا يبدو أنّ هناك احتمالا لتطوير الصناعة والزراعة بما يكفي لتوفير المعيشة للعدد المتزايد من السكان. طابع الوضع السياسي للقطاع، الذي يعتبر وضعا اصطناعيّا، وارتباطه الوثيق بالصراع المستمر بين العرب والإسرائيليين لا يُشجع على الاستثمار في المنطقة. إن مشروع الميناء المزعوم الذي يُقال أن جمهورية مصر العربيّة ستبدأ به هذا العام (1965) قد يُشجّع على صناعة الصيد. إذا تم توفير مصدرٍ للكهرباء، فإنّه من الممكن إنشاء مصانع جديدة للتصنيع الخفيف ومرافق جديدة لصناعات الخدمات، ولكن جميع هذه الابتكارات لن توفّر سوى تقدّم رمزيّ نحو هدف خلق الوظائف. وحتى إذا جرى التوصّل إلى اتفاقٍ يسمح لسكّان قطاع غزّة بالهجرة بحريّة بحثا عن عمل، فإنّ الوضع لن يتحسّن كثيرا، لأنّ الظروف الاقتصاديّة المُسيطرة في الدول العربيّة تحدّ من قدرتها على استيعاب الآلاف من العمّال غير المؤهلين.
إن توسيع الإنتاج الزراعيّ من خلال الاستخدام المُكثّف للأرض يبدو الطريقة الأكثر قابليّة للتحقيق في مجال التنمية الاقتصادية، وأمل التقدم في هذا الصدد مرهونٌ بوجود مصدرٍ رخيصٍ وموثوق لمياه الري. مصدرٌ كهذا متاحٌ فعليّا للمزارعين الإسرائيليين شرق قطاع غزّة من خلال أنابيب مرتبطة بشبكة المياه الوطنيّة الإسرائيليّة، والتي تنقل المياه من بحيرة طبريّا إلى النقب الشمالي. قدّر المُتخصصون الزراعيّون الذين عملوا في القطاع خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي استمرّ لمدّة 125 يومًا في عام 1956-1957، بأنه إذا تم ربط القطاع بشبكة الري في إسرائيل وجرت الاستفادة من المياه بأفضل شكلٍ ممكن، فإنّه يمكن مضاعفة الجزء القادر على دعم نفسه من السكان من 80,000 إلى 160,000 شخص. بعض أجزاء القطاع مناسبة تمامًا لإنتاج الحمضيات، ولكن هناك قليل من الصدق في الإدعاءات المحلية بأنه يمكن تحويل المنطقة بأكملها إلى مزرعة حمضيات. سيتم توليد معظم فرص العمل المربحة من خلال الإنتاج الزراعي والتسويق، ولكن الزيادة في الدخل ستعزز فرص العمل الإضافية في قطاعات أخرى من الاقتصاد. ومع ذلك، حتى في حالة تطوير الإمكانات الزراعية بشكل كامل، فإنها لن تفي بالاحتياجات المطلوبة في المنطقة وستترك أكثر من 220,000 شخص يعتمدون على الآخرين.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]