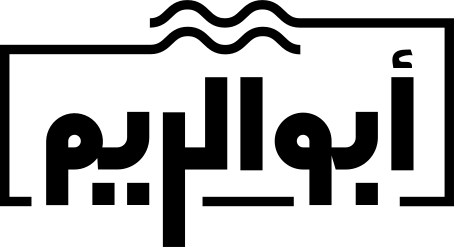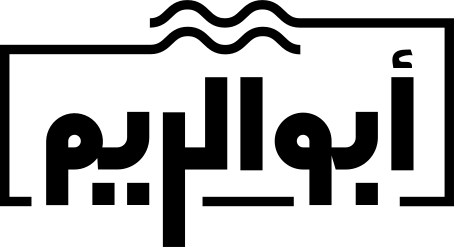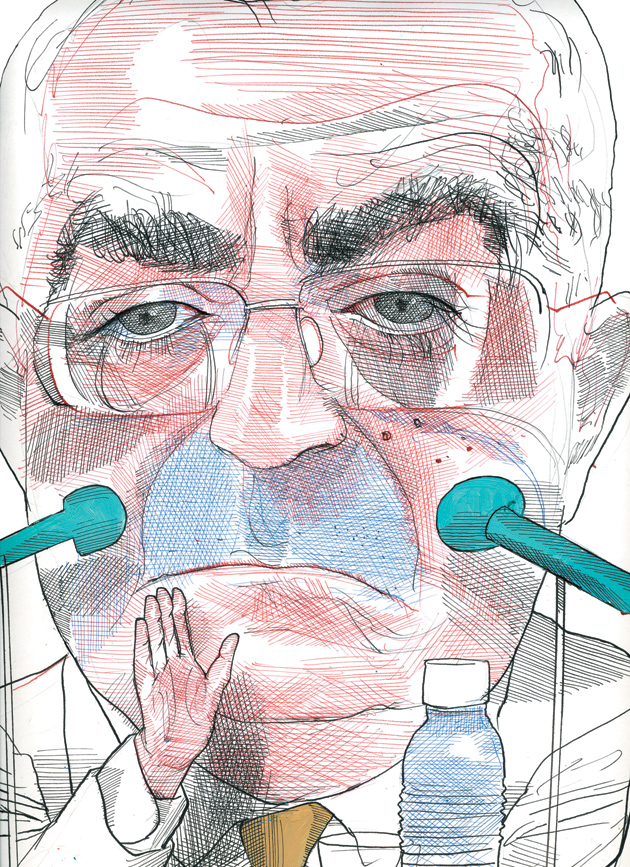[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشرت في جريدة “الأخبار” اللبنانية في 12 أيلول/سبتمبر 2012[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]في مستوطنة «غوش عتسيون» أكبر تجمّع استيطاني في الضفّة الغربيّة، يلتقي رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري مع نظيره الإسرائيلي رامي ليفي، أحد أشهر رجال الأعمال الإسرائيليين المالكين لسلسلة محال البيع بالتجزئة في إسرائيل. يتحدّث المصري إلى زبائن المحل الإسرائيليّين عن رغبته في التعاون مع ليفي لتأسيس تحالف للسلام ينهي مأساة الأمّهات الثكالى في «الجانبين»، ويعيد تجديد الزخم في «عمليّة السلام» الميّتة. ليست تجارة ليفي وحدها المزدهرة في «غوش عتسيون».
من أميركا وأماكن أخرى في العالم يصل سيّاح إلى هذه المستوطنة تحديداً لـ«يسوحوا» في معسكر تدريبي قتالي هناك، جُهّز ليضع مرتاديه في جوّ مواجهة افتراضيّة مع «مخرّبين» فلسطينيين. يُطلق سائح أميركي النار من بندقيّة على شخص يعتمر كوفيّة عربيّة. يُعبّر منيب المصري عن رغبته في السلام، ويُحدث ليفي نفسه عن اقتناص فرصة تجاريّة جديدة في الضفّة المحتلّة. ولمَ لا؟ عبر مقاربة «السلام الاقتصادي» التي تمثل جوهر أطروحات اليمين الحاكم في إسرائيل بشأن الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة، لم تعد السلطة الفلسطينية، التي قبلت كامل شروط إسرائيل السياسيّة والأمنيّة، أكثر من إدارة محليّة تنظم سوقاً استهلاكيّة ضخمة، وتعد الناس بالازدهار الاقتصادي و«حكم القانون» وبناء مؤسّسات الدولة العتيدة في أجواء هادئة بعد تصفية الأجنحة المسلّحة للفصائل الفلسطينيّة. في أجواء الهدوء هذه، حيث تغيب السياسة تماماً، يُمكن لليفي أن يفكر جديّاً في الاستثمار، وأن يجد له شركاء فلسطينيين تحت عنوان التعاون الاقتصادي والازدهار المشترك.
نموذج الضفّة الغربيّة
تُقرّ دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي في 2003 أنّ جذور الجهود الفلسطينيّة المتجدّدة للإصلاح تعود إلى الأيام الحالكة في ربيع 2002. في ذلك الربيع نفّذت إسرائيل عمليّة «السور الواقي» التي أعادت القوّات الإسرائيليّة إلى داخل المدن الفلسطينيّة المُحتلّة في الضفّة الغربيّة، وأفضت سياسيّاً إلى قرار إسرائيلي بمحاصرة ياسر عرفات في مقرّه برام الله. إن عمليّة إصلاح جادّة للسلطة الفلسطينيّة لم تكن لتنجح آنذاك، من منظور الإسرائيليّين والغرب، بدون التخلّص من عرفات المُمسك تاريخيّاً بزمام القرار المالي للفلسطينيّين. لذلك كانت واحدة من النتائج السياسيّة المباشرة لحصار عرفات إقرار خطّة إصلاح السلطة الفلسطينيّة المعروفة بخطّة «المئة يوم»، والهادفة إلى بناء مؤسّسات فلسطينيّة جديدة تنفّذ الالتزامات الواردة في «خارطة الطريق»، وأهمّها نزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة، إضافةً إلى ذلك، هدفت الخطّة التي صاغتها دول ومؤسّسات مانحة إلى تنظيم ماليّة السلطة الفلسطينيّة وحصرها في حساب واحد وإخضاعها لنظام تدقيق صارم. من هذا المدخل جاء سلام فيّاض، رئيس الوزراء الحالي، ليصبح وزير ماليّة السلطة الفلسطينيّة «التكنوقراط» الذي ستُوكل إليه مهمّة إعادة تنظيم الماليّة العامة للسلطة. بمعاني الاقتصاد السياسي. ليس فيّاض، الذي عمل في البنك الدولي سنوات طويلة، سياسيّاً فلسطينيّاً خارجاً من تفاعل القوى السياسي والاجتماعي كما في أيّ مجتمع سياسي، بل ممثّل للمؤسّسات الدوليّة في جهاز السلطة الفلسطينيّة، عهدت إليه على مدار عقد كامل تقريباً مهمّة التصرّف بأموال المانحين المتدفقة إلى الضفّة الغربيّة وغزّة وفق التصوّرات المُصمّمة في تلك المؤسّسات وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليّين. في الواقع، انتظر فيّاض حتى 2007 لتبدأ مسيرة برنامجه النوعيّة.
كانت حماس قد سيطرت على غزّة منتصف ذلك العام، وقد استطاع محمود عبّاس أن يضمن ولاء فتح بالكامل له بعد وفاة عرفات، وبالتالي وفّر غطاءً لفيّاض الذي أصبح رئيس وزراء السلطة في الضفّة الغربيّة. في نهاية ذلك العام (أي 2007)، وصل فيّاض مؤتمر باريس للمانحين وفي يده ما عُرف بـ«خطّة الإصلاح والتنمية»، التي أدت وزارة التنمية الدوليّة البريطانيّة دوراً كبيراً في إعدادها، وبدأ حشد الدعم الدولي وضخّ أموال المانحين مجدّداً لحكومته المُشكّلة حديثاً بعد التوقف الناجم عن انتخاب حماس بأغلبيّة كبيرة في البرلمان الفلسطيني.
كانت إحدى المقاربات الرئيسيّة في ضخّ المانحين الدوليّين لأموالهم تتجلى في بناء وعي فلسطيني متمحور حول صورتين: صورة غزّة «المشاغبة» وبالتالي الفقيرة والمهمّشة، وصورة الضفّة الغربيّة «المطواعة» التي ستوفّر لها كل سبل الرخاء والازدهار في ظل نموذج «الحوكمة الرشيدة» المدعوم دوليّاً. هكذا بدأ فعليّاً التحوّل النوعي لإعادة تأسيس «نموذج الضفّة الغربيّة»، الذي يمثل رجع صدى لسياسة إسرائيل في «الجسور المفتوحة» في عقد السبعينيّات. تقوم سياسة الجسور المفتوحة على فلسفة بسيطة: إمنح الفلسطينيين مزايا معيشيّة واقتصاديّة (كانت في السبعينيات فتح سوق العمل الإسرائيلي للعمالة الفلسطينيّة) وسينسون بدورهم السياسة وينشغلون بمتعهم الخاصّة. اليوم يُعاد تقديم نسخة معدّلة من هذا النموذج بوجود إدارة فلسطينيّة تضمن لإسرائيل الأمن في مناطق الضفّة المحتلّة عبر تعاون أمني وثيق ومتواصل، ووعد الناس بحياة رفاهيّة متوهمة، بعدما أغلقت إسرائيل جسورها. في شهر رمضان الفائت منحت إسرائيل تصاريخ دخول للأراضي المحتلّة عام 48 لما يزيد على 200 ألف فلسطيني. من كان يصدّق في غمرة سنوات الانتفاضة الثانية المشتعلة أنّ إسرائيل يُمكن أن تسمح في يوم من الأيّام لآلاف الفلسطينيين بالسباحة على شواطئ عكّا ويافا؟ لقد جرى تطبيع الفلسطينيين مع هذا النموذج: إمّا الهدوء أو خسارة كلّ شيء.
الإثراء الذاتي والإفقار المجتمعي
تنسجم سياسة السلطة الفلسطينيّة النيوليبراليّة على المستوى الاقتصادي مع مقاربة «الأمن أوّلاً» التي تُمثل جوهر اتفاقات أوسلو، والهادفة إلى وضع الاعتبارات الأمنيّة الإسرائيليّة فوق أيّ اعتبار سياسي آخر، ومقاربة «السلام الاقتصادي» التي تُمثّل منظور اليمين الإسرائيلي للتعامل مع الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة عبر سياسات التهدئة والتسكين الاقتصاديّين. عبر تركيزها على الإصلاح والتنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق الإطارات المؤسّسية والقانونيّة الهادفة لتمكين هذا القطاع من قيادة عمليّة التنمية، تتماهى خطط السلطة الفلسطينيّة الموضوعة في مكاتب المؤسّسات الدوليّة مع ما يُعرف بـ«إجماع ما بعد واشنطن»، الذي يمثّل النسخة المنقّحة من «إجماع واشنطن» الذي شكّلت مبادئه ركائز العقيدة الليبراليّة الجديدة التي سيطرت على السياسات الاقتصاديّة حول العالم في عقد الثمانينيات، لكن الإشكال في السياق الفلسطيني، كما يشير الاقتصادي رجا خالدي، يكمن في السيطرة الاستعماريّة الإسرائيليّة على الحيّز السياسي والاقتصادي الفلسطيني، مما يحول دون قدرة السلطة الفلسطينيّة على تبني سياسة نقديّة مستقلة (لا وجود لبنك مركزي فلسطيني) أو سياسة ماليّة فعّالة في ظل غياب الموارد الماليّة المتأتيّة من دورة الإنتاج المحليّة. فالقنوات التي تموّل الماليّة العامة للسلطة محكومة بالقيود الإسرائيليّة والدوليّة على حدّ سواء. هكذا تتحوّل النيوليبراليّة الفلسطينيّة إلى صورة وادعة، لكن مزيفة وهشّة ولا أساس لها في الواقع، وتغدو على أثرها كل السياسات الاقتصاديّة الفلسطينيّة امتداداً للسياسات الإسرائيليّة. يلخّص كل هذا صورة سلام فيّاض، الذي جلس مطمئناً في أحد فنادق القدس المحتلّة قبل بضعة أسابيع مع ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ليستمع منه إلى نصائح حول الكيفيّة التي يُمكن من خلالها معالجة أزمة السلطة الماليّة الخانقة. تتكامل النيوليبراليّة في صورتها الفلسطينيّة هنا إذن مع السياسة الإسرائيلية في التسكين الاقتصادي.
إنّ واحداً من المؤشّرات المهمّة التي يُمكن أن تولّد انطباعاً عما جاءت به سياسات السلطة للفلسطينيين يتمثّل في الارتفاع المطّرد في حجم التسهيلات الائتمانيّة التي يقدّمها القطاع المصرفي في الضفّة الغربيّة للشرائح الاجتماعيّة المتوسطة وفوق المتوسطة. رصد خالدي ارتفاعاً مطّرداً في نسبة الإقراض الخاص في السنوات الست الأخيرة بدءاً من 2006، إذ قدّمت البنوك الفلسطينيّة ما يُقارب من عشرة مليارات دولار للقطاع الخاص في صورة قروض استهلاكيّة وسكنيّة وتجاريّة، وبمعدل زيادة 13% كل عام. منحت التسهيلات الائتمانيّة الكبيرة زخماً للمظاهر الاستهلاكيّة في مدن الضفّة الغربيّة، إذ ازدهرت مراكز التسوّق الكبيرة وأنشطة الترفيه المختلفة والمجمّعات السكنيّة الحديثة. تقول التجربة عبر العالم إنّ الأزمات الماليّة تنطلق عبر انفجار الفقّاعة الناجمة عن الارتفاع الكبير في منح الائتمان في قطاع محدّد (العقارات في الأزمة العالميّة الأخيرة) الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار منتجات هذا القطاع ثمّ تهاويها مرّة واحدة. قد لا تكون عدوى القروض العقاريّة في الضفّة الغربيّة مؤشراً لأزمة ماليّة كبيرة، بالنظر إلى صغر الاقتصاد الفلسطيني ومحدوديّة ارتباطاته بالسوق العالميّة، لكن الخطورة كامنة في ما يُمكن تسميته «الإثراء الذاتي والإفقار المجتمعي»، ففيما يشعر الفلسطيني بأنّه حصل عبر القروض على أحدث سيّارة وأفضل أثاث لمنزله على المستوى الشخصي، يجري رهن اقتصاد كامل على المستوى الكلّي بنمط استهلاكي يعتمد على القروض، ويزيد من الضغوط التضخميّة على الفئات الأكثر هامشيّة، التي لا تسمح لها بدخول نادي «القروض السهلة»، وبالتالي تعرّضها للموجات القاسية لارتفاع الأسعار بسبب تزايد معدّلات الاستهلاك.
السؤال المطروح: كيف يُسدّد الفلسطينيّون قروضهم؟ إنّ الشريحة الاجتماعيّة القادرة على الحصول على القروض هي تلك المرتبطة ببيروقراطيّة السلطة الفلسطينيّة والمنظمات غير الحكوميّة العاملة بنشاط في الضفّة الغربيّة. أي إنّ هذه الشريحة تُسدد أقساط قروضها من أموال دافع الضرائب الغربي، والأموال التي تحوّلها إسرائيل للسلطة. حين يقرّر المانحون أو إسرائيل إغلاق صنبور الدعم فإنّ هذا لا يمثل تهديداً للسلطة السياسيّة فحسب، بل أيضاً لآلاف الأسر التي ترتبط معيشتها بها بشكل أو بآخر. يمكن أن يُفسر هذا الديناميّات التي جرى من خلالها تدجين ما يُمكن تسميته «الطبقة الوسطى» الفلسطينيّة، ونقلها عبر الاقتصاد من الانشغال السياسي الكامل ضمن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قبل أوسلو للتموضع في مصفوفة المسايرة السياسيّة للحل السلمي بعد أوسلو.
لماذا يريد منيب المصري السلام؟
يدرس الأكاديمي الفلسطيني في جامعة لندن آدم هنيّة تكوّن الطبقة الرأسماليّة في بلدان الخليج العربي. في دراسة تحليليّة له عالج هنيّة تكوّن الطبقة الرأسماليّة الفلسطينيّة في الشتات، كمكوّن صغير من الطبقة الرأسماليّة الصاعدة في الخليج حول قطاع النفط، الذي ازدهر على نطاق واسع في عقدي الستينيّات والسبعينيّات. في قلب هذه الطبقة الفلسطينيّة يحتل ابنا المصري، المنحدران من مدينة نابلس، منيب وصبيح، موقعاً مهمّاً. صبيح (الذي أصبح أخيراً رئيس مجلس إدارة البنك العربي بعد إقصاء عبد الحميد شومان) أسّس في 1967 شركة أسترا الصناعيّة في السعوديّة، وقد تطوّرت أعماله ليصبح المورّد الرئيسي للأغذية للجيش السعودي، قبل أن يحصل على الصفقة الشهيرة في توريد الأغذية لقوات الجيش الأميركي في الخليج في حرب الخليج الثانية، والبالغ عديدها 1.1 مليون جندي تقريباً. منيب بدوره أسّس في الخمسينيّات شركة «إيدجو» الهندسية التي استطاعت الحصول على عقود توريد معدّات هندسيّة لشركات النفط والغاز الأجنبيّة العاملة في الخليج. يحتل منيب المرتبة 34 على قائمة الأثرياء العرب حسب تصنيف مجلّة «أرابيان بيزنس» بثروة تربو على مليار ونصف مليار دولار.
المنظور المقترح لدراسة الاقتصاد السياسي للضفّة الغربيّة وقطاع غزّة لا يجوز أن ينفصل، وفقاً لهنيّة، عن عمليّة التدويل التي حصلت لرأس المال الخليجي في عصر العولمة واتفاقات السلام تحت الرعاية الأميركيّة. في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو جرت عمليّة توطين لجزء من رأس المال الفلسطيني المتكوّن في الخليج في الأراضي الفلسطينيّة على شكل استثمارات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي. تمتلك مجموعة المصري الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي تتكوّن من بنك القاهرة عمّان، أسترا، زارا القابضة، والمسيرة للاستثمار) مجموعة من الشركات القابضة النشطة في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة مثل «باديكو» و«بيديكو» وغيرها، والتي تسيطر بدورها على كل أشكال النشاط التجاري والخدمي والصناعي والمصرفي في الأراضي المحتلّة عبر شركات أصغر حجماً. تعكس هذه الصورة سيطرة فعليّة لرأس المال الفلسطيني المتكوّن في الخليج على الاقتصاد الفلسطيني.
هل يُمكن لرأس المال هذا أن يكون جزءاً من استراتيجيّة للتحرّر الوطني؟ بالطبع لا. إنّ سعي رأس المال الفلسطيني الدؤوب لتثبيت التهدئة والسعي لتفعيل عمليّة السلام، بل والتوسّط في المصالحة الفلسطينيّة المتعثرة، ينطلق من اعتبارات الربحيّة وفتح أسواق جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. وبوجود إدارة فلسطينيّة تعتنق مبادئ النيوليبراليّة، يكون رأس المال الفاعل الرئيسي حتى بالمعنى السياسي طالما أنّ عقيدة النيوليبراليّة تحصر مهمات مؤسّسات الدولة في السهر على رعاية مصالح القطاع الخاص، والمستثمرين الكبار. لذلك كلّه يزور رئيس مجلس إدارة البنك العربي الجديد السيّد صبيح المصري وزير ماليّة السلطة الفلسطينيّة، ويعده بوقوف البنك إلى جانب السلطة في محنتها الماليّة الحاليّة.
السياسة أوّلاً وأخيراً
يستدخل الاقتصاد الجديد مفاهيمه الخاصّة التي تُهيمن على الجدل السياسي في أيّ مجتمع. في حالة السياسات النيوليبراليّة فإنّ السياسة تُطبع بطابع تقني، فتنتقل من معناها الحقيقي كصراع اجتماعي يدور على مختلف المستويات مع السلطة السياسيّة إلى مسائلة تقنيّة حول شفافيّة هذه السلطة في تنفيذها لسياساتها ومحاولة تحسين عوائد هذه السياسات، والتقليل من أضرارها. هل يُمكن أن تطمح سلطة، أيّ سلطة، بأفضل من جدل سياسي يمسّ هوامش فعلها دون أن يُحاكم جوهره وانحيازاته والسياق الذي يعمل فيه؟ في موجة الاحتجاج الأخيرة الأكبر من نوعها ضدّ سياسات سلام فيّاض تستطيع أن ترى صوتين من الاحتجاج: صوتٌ ينتقد السياسة بحد ذاتها، فيحاكمها بالمعنى التقني ويحاول، على هذا الأساس، أن يجد لها حلولا من نفس السلّة التفنيّة، أي إعادة تقديمها على نحو أفضل دون المسّ بجوهرها. وصوت آخر، ينتقد السياق كلّه، السياق السياسي الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينيّة أصلاً، فيصوّب على اتفاقيّة باريس، النسخة الاقتصاديّة من أوسلو، ويطالب بإنهائها. الصوت الأخير هو الصوت السياسي الحقيقي، الصوت الجذري الذي يستعيد السياسة من الهامش ليضعها في قلب المتن ويسائل جدوى وجود سلطة فلسطينيّة لا تمتلك مقوّمات الدولة وتعتاش على المال الأجنبي وتصر في نفس الوقت على أداء دور الدولة التي تستطيع أن ترسم وتقرّر.
لا حلّ اقتصاديّاً فلسطينيّاً بدون حلّ سياسي. حلّ يستوعب أن المشكلة في فلسطين تكمن في طبيعة علاقات القوّة الاستعماريّة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتي لبست لبوس الشرعيّة عندما جرى تَمثّلها في الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، ثمّ في خلق إدارة فلسطينيّة محدودة، أثبتت تجربة العقدين الأخيرين أنّ مآلها النهائي هو أن تعمل كوكيل محلّي للقوّة الاستعماريّة العسكريّة. كل قناطير الدولارات في خزائن البنك الدولي، وكل خططه الطموحة ووصفاته البرّاقة لا يُمكن أن تحل مشكلة الفلسطينيّين. الفلسطينيّون يحتاجون اليوم، أكثر من أيّ يوم مضى، إلى تجاوز السياق كلّه، سياق أوسلو، لأفق مشروع تحرّر وطني بدون أوهام. الفلسطينيّون يحتاجون باختصار إلى استعادة السياسة أوّلاً وأخيراً.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]