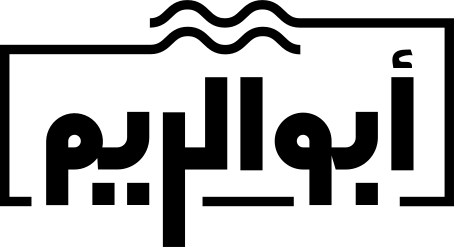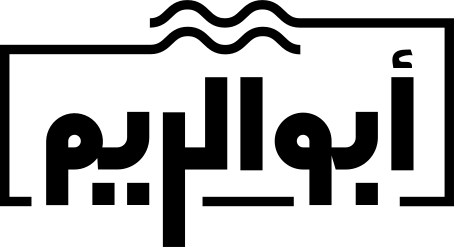[vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”80″ accent_color=”#7d89aa”][vc_column_text]
تُفيد المعلومات المتوفرة من المصادر الصحافيّة بأنّ الجيش الإسرائيلي قام ليلة أمس بإنزال العشرات من جنوده، في ما يبدو أنّها عمليّة خاصّة، في ثكنة عسكريّة تقع في سفوح بلدة الكسوة بريف دمشق. قد يمر اسم الكسوة مرور الكرام على الكثيرين بسبب غمرة الأخبار الحربيّة المتزاحمة في منطقتنا، وربما لأنّ مستوى الاستباحة الإسرائيليّة لجغرافيّات متعدّدة في آن واحد لا يترك للمرء دائما ترف التأمّل في تفاصيل صغيرة قد تبدو هامشيّة أو غير ذات صلة للوهلة الأولى. لكنّني أعتقد شخصيّا أنّ فهم شيء عن هذه البلدة الريفيّة الصغيرة يمثّل مفتاحا لفهم ما جرى بالأمس ولِما قد يجري لاحقا في سوريا، بل وربما لفهم جانب من التفكير العسكريّ والأمنيّ الإسرائيليّ في هذه الساحة بالذات.
ولمن لا يعرف، فالكسوة، والتي كان من حُسن حظّي أنني قضيت فيها أصيافا كثيرة في الماضي، تقع على بُعد حوالى 20 كم فقط من العاصمة السوريّة. وقد اكتسبت البلدة أهميّتها عبر العصور من كونها عقدة على الطريق التاريخيّ بين دمشق وحوران والأردن وشمال الحجاز، ما جعلها محطّة رئيسيّة للقوافل التجاريّة، ومنحها مكانتها المستحقّة كبوابة جنوبيّة لدمشق. ولهذا السبب، لم يكن من الغريب أنّ الفرنسيّين حين بنوا سكّة حديد بيروت – دمشق في نهايات القرن التاسع عشر وضعوا الكسوة محطّة على ذلك الخط، وأنّه حين بنى العثمانيّون من بعدهم سكّة حديد المدينة المنوّرة – دمشق في مطالع القرن العشرين وضعوها أيضا محطّة على الخطّ الحجازي الجديد.
هذه المزايا اللوجستيّة والمكانيّة للبلدة لم تكن لتغيب عن أذهان العسكريّين السوريّين منذ حقبة ما بعد الاستقلال (1946). فبحكم وقوعها، هي وبلدة قطنا إلى الشمال منها، على الواجهة الجنوبيّة الغربيّة التي تقطع الطريق القادم من الجبهة في الجولان إلى العاصمة، فقد رابطت فيها أوائل ألوية المدرّعات في الجيش السوري. لكن هذه الوضعية سرعان ما تحوّلت إلى عامل إشكاليّ، إذ غدت القطعات العسكريّة المنتشرة على خط الكسوة – قطنا مركزا من مراكز الاضطراب في الحياة السياسيّة السوريّة لما يزيد على عقدين من الزمن، ذلك أنّه حتى انقلاب البعث (1963)، انبثقت غالبية الحركات الانقلابيّة في سوريا من ضبّاط كانوا يخدمون في ألوية المدرّعات المرابطة في تلك المنطقة.
وفي أعقاب انقلاب الحركة التصحيحيّة (1970)، وبدء تنظيم الجيش السوريّ إداريّا على مستوى الفرقة، لم يكن حافظ الأسد، الذي خاض تجربة ثلاثة انقلابات متتالية في أقل من عقد من الزمن، ليتجاهل أمرا حسّاسا من هذا القبيل. وهكذا راحت الكسوة تتحوّل مع الوقت إلى حصن منيع من حصون النظام الجديد. فقد جُعلت البلدة مقرّا رئيسيّا للفرقة المدرّعة الأولى التي أوكلت إليها مهمّة حماية العاصمة (وبالتالي النظام)، وقد حرص الأسد على أن يرأس هذه الفرقة على الدوام قادة موثوقون إلى أبعد درجات الثقة. ولم يكن غريبا تبعا لذلك أن تلعب الفرقة دورا رئيسيّا في إخماد التمرّد الذي قام به أخوه رفعت عليه أثناء مرضه (1983).
وبعد تشظّي الجيش السوريّ في العقد الأخير، ورثت الميليشيات الإيرانيّة ثكنات الفرقة الأولى في الكسوة وتلالها، ولهذا السبب كانت البلدة من بين أكثر المواقع تعرّضا للهجمات الإسرائيليّة في سوريا على مدار أكثر من عشر سنوات ضمن ما عُرف إسرائيليّا بنهج «المعركة بين الحروب».
قد يبدو للوهلة الأولى أنّ التشديد الإسرائيليّ على ضرورة أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح تمتد من الجنوب السوريّ إلى تخوم دمشق مسألة استجدّت بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكن هذا غير صحيح، إذ إن هذا المفهوم الأمنيّ أقدم من ذلك بكثير، وأتمنى أن تأتي الفرصة لأكتب عن الأمر بشكل موسّع لاحقا. حتى ذلك الحين، يمكن القول إنّه بحكم تأهيلهم وتكوينهم، فإن العسكريّين قد يكونون أقدر منّا دائما على فهم الحتميّات الجغرافيّة في الحرب وفي السياسة. وإذا كانت الأجيال المختلفة من العسكريّين السوريّين قد أدركت منذ النصف الأوّل من القرن العشرين الأهميّة الكامنة في الكسوة، فلا شك أنّ نظراءهم الإسرائيليّين قد أدركوا هذه الأهميّة بدورهم. ومن هنا، فإن الإسرائيليّين بإنزالهم يوم أمس في البلدة إنما رسموا على الأرض وبشكل مباشر حدود منطقتهم الأمنيّة في سوريا، وأوحوا لكل من يعنيه الأمر بأن من استطاع الوصول إلى الكسوة بهذه الطريقة أصبح بشكل ما ممسكا بمفتاح من مفاتيح دمشق.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”50″ accent_color=”#7d89aa”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4712″ img_size=”165.094*114.6486″ alignment=”center”][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”50″ accent_color=”#7d89aa”][/vc_column][/vc_row]