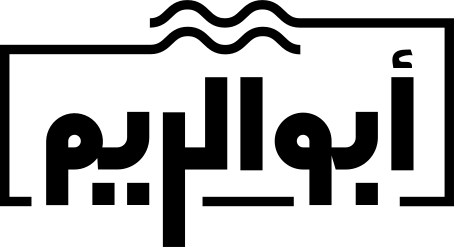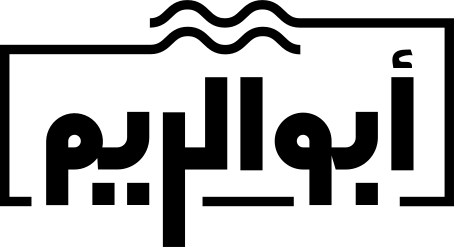[vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”80″ accent_color=”#7d89aa”][vc_column_text]لم أقرأ مقالا تحليليا ممتعا منذ فترة طويلة، حتى وقعتُ قبل أيام قليلة في مجلة “الشئون الخارجية” على هذا المقال الذي كتبه البروفيسور مايكل كيماج، أحد المؤرخين الأمريكيين البارزين لتاريخ الحرب الباردة والعلاقات الروسيّة الأمريكيّة. يحاول هذا المقال فهم وتحليل ظاهرة الترامبيّة السياسيّة في الإطار التاريخي الأمريكيّ، فينظر إليها كامتداد لحركات وأفكار اليمين المعادي للشيوعيّة في عقد الخمسينيّات الماضي في الولايات المتحدة. وهو يرى أن ترامب يعدّ في جوانب كثيرة وريثا للتركة السياسيّة لتلك المرحلة ولقيمها ولتصوّراتها عن مكانة أمريكا ودورها العالميّ. يعرض كيماج في هذا الصدد لبعض الكتب التي شكّلت الأفكار الرئيسيّة للسياسة المحافظة التي يمثّلها ترامب اليوم، وهي أفكارٌ قامت على رسم صراع بين الغرب وأعدائه، واستندت إلى رموز دينية، وأبدت ريبة دائمة تجاه الليبرالية الأمريكية، معتبرةً إياها ضعيفة، ومتجاوزة للأطر الوطنية، وعلمانية للغاية بحيث لا يمكنها حماية البلاد. ومن جانب آخر، يتناول كيماج الظاهرة في نطاقها العالمي، فيرى أن صعود ترامب إلى مسرح السياسة الدولية هو جزء من تيار عالمي عريض عنوانه ظهور قادة جدد مهجوسين بفكرة القوّة والأمة العظيمة والحضارة الفخورة بنفسها، وأن أبرز سمات هؤلاء القادة هو أنهم لا يعيرون اهتماماً كبيراً للأنظمة القائمة على القواعد أو التحالفات، وأن استراتيجياتهم السياسية تعتمد على عناصر محافظة، حيث يتجاوزون النخب الليبرالية الحضرية العالمية، ويخاطبون شرائح اجتماعية مدفوعة بتوق إلى التقاليد والرغبة في الانتماء.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة الخاصة بي على تطبيق “تليغرام” من هُنا.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”80″ accent_color=”#7d89aa”][vc_column_text]
الترجمة:
في العقدين اللذين أعقبا نهاية الحرب الباردة، اكتسبت العولمة زخماً على حساب القومية. وفي الوقت نفسه، أدت هيمنة الأنظمة والشبكات المعقدة – المؤسسية والمالية والتكنولوجية – إلى تهميش دور الفرد في السياسة. لكن في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأ تحوّل جذري. فمن خلال تعلم استغلال أدوات هذا العصر، أعاد عدد من الشخصيات الكاريزمية إحياء نماذج من القرن الماضي: القائد القوي، الأمة العظيمة، الحضارة الفخورة.
يمكن القول إن هذا التحول بدأ في روسيا. ففي عام 2012، أنهى فلاديمير بوتين تجربة قصيرة ترك فيها الرئاسة ليشغل منصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات، بينما تولى حليف مطيع منصب الرئيس. عاد بوتين إلى منصبه الأول وعزز سلطته، وقضى على كل أشكال المعارضة، وكرّس نفسه لإعادة بناء “العالم الروسي”، واستعادة مكانة القوة العظمى التي تلاشت مع سقوط الاتحاد السوفيتي، ومقاومة الهيمنة الأمريكية وحلفائها. بعد ذلك بعامين، وصل شي جين بينغ إلى قمة السلطة في الصين. كانت أهدافه شبيهة بأهداف بوتين، ولكن على نطاق أوسع بكثير – وكانت الصين تمتلك قدرات أكبر بكثير. وفي عام 2014، أكمل ناريندرا مودي، الرجل ذو الطموحات الواسعة للهند، صعوده السياسي الطويل إلى منصب رئيس الوزراء، وكرّس القومية الهندوسية كأيديولوجيا مهيمنة في بلاده. وفي العام نفسه، أصبح رجب طيب أردوغان، الذي أمضى أكثر من عقد كرئيس وزراء تركيا القوي، رئيساً للجمهورية. وسرعان ما حوّل أردوغان المشهد الديمقراطي التركي المنقسم إلى نظام استبدادي يعتمد على رجل واحد.
وربما كانت اللحظة الأكثر حسماً في هذا التحول هي فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة عام 2016. وعد ترامب بـ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” وبتقديم “أمريكا أولاً” – شعارات جسّدت الروح الشعبوية والقومية والمعادية للعولمة التي كانت تختمر داخل الغرب وخارجه، حتى مع توسع النظام الليبرالي الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لم يكن ترامب مجرد راكب لموجة عالمية، بل استمد رؤيته لدور أمريكا في العالم من مصادر أمريكية بحتة، رغم أنها لم تكن مستوحاة كثيراً من حركة “أمريكا أولاً” الأصلية التي بلغت ذروتها في الثلاثينيات، بقدر ما تأثرت بالحركة اليمينية المعادية للشيوعية في الخمسينيات.
لبرهة، بدا أن خسارة ترامب أمام جو بايدن في انتخابات 2020 تمثل استعادة للمسار القديم، حيث أعادت الولايات المتحدة اكتشاف موقفها ما بعد الحرب الباردة، متأهبة لدعم النظام الليبرالي وكبح المد الشعبوي. لكن مع عودة ترامب الاستثنائية، يبدو الآن أن بايدن، وليس ترامب، هو من مثّل استراحة مؤقتة عن المسار العام. أصبح ترامب ونظراؤه من دعاة “العظمة الوطنية” هم من يحددون الأجندة العالمية اليوم. إنهم رجال أقوياء، لا يعيرون اهتماماً كبيراً للأنظمة القائمة على القواعد أو التحالفات أو المنتديات متعددة الأطراف. إنهم يحتضنون مجد بلادهم الماضي والمستقبلي، ويؤكدون على تفويض شبه مقدّس لحكمهم. وعلى الرغم من أن برامجهم قد تتضمن تغييرات جذرية، إلا أن استراتيجياتهم السياسية تعتمد على عناصر محافظة، حيث يتجاوزون النخب الليبرالية الحضرية العالمية، ويخاطبون شرائح اجتماعية مدفوعة بتوق إلى التقاليد ورغبة في الانتماء.
بطرق عدة، تعكس هذه القيادات ورؤاها ما وصفه عالم السياسة صامويل هنتنغتون في أوائل التسعينيات بـ”صدام الحضارات”، وهو الصراع الذي توقع أنه سيشكل المحرك الرئيسي للنزاعات العالمية بعد الحرب الباردة. لكنهم يفعلون ذلك بأسلوب استعراضي ومرن أكثر منه قاطعًا ومتعصبًا. إنه “صدام الحضارات المخفّف: “سلسلة من الإيماءات وأسلوب قيادة يعيد تشكيل التنافس حول المصالح الاقتصادية والجيوسياسية – وأحيانًا التعاون بشأنها – في صورة مواجهة بين دول حضارية ذات رسائل أيديولوجية عابرة للحدود”.
هذا الصراع يكون خطابيًا في بعض الأحيان، حيث يسمح للقادة باستخدام لغة الحضارة وسردياتها دون الالتزام التام برؤية هنتنغتون أو بالتقسيمات المبسطة التي تنبأ بها (روسيا الأرثوذكسية في حالة حرب مع أوكرانيا الأرثوذكسية، وليس مع تركيا المسلمة). على سبيل المثال، قُدِّم دونالد ترامب خلال المؤتمر الجمهوري لعام 2020 بوصفه “حارس الحضارة الغربية”. أما القيادة الروسية، فقد طورت مفهوم “الدولة الحضارية”، مبررةً من خلاله محاولاتها للهيمنة على بيلاروسيا وإخضاع أوكرانيا. وفي قمة الديمقراطية لعام 2024، وصف ناريندرا مودي الديمقراطية بأنها “شريان الحياة في الحضارة الهندية”. في خطاب عام 2020، أعلن رجب طيب أردوغان أن “حضارتنا هي حضارة الفتح”. أما في عام 2023، فقد أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال خطابه أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بمشروع بحثي وطني حول أصول الحضارة الصينية، واصفًا إياها بأنها “الحضارة العظيمة الوحيدة غير المنقطعة التي لا تزال قائمة في شكل دولة حتى يومنا هذا”.
في السنوات القادمة، سيعتمد الشكل الذي ستتخذه هذه المنظومة الدولية إلى حد كبير على فترة ولاية ترامب الثانية. فالنظام الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة هو الذي عزز تطوير الهياكل فوق الوطنية. لكن الآن، بعد أن انضمت أمريكا إلى “رقصة الدول” في القرن الحادي والعشرين، فإنها ستحدد إيقاعها في كثير من الأحيان. مع ترامب في السلطة، ستترسخ القناعة السائدة في أنقرة وبكين وموسكو ونيودلهي وواشنطن (وفي العديد من العواصم الأخرى) بأنه لم يعد هناك نظام عالمي واحد ولا مجموعة قواعد متفق عليها.
في هذا المناخ الجيوسياسي، ستتراجع الفكرة الهشة أصلًا لـ”الغرب” بشكل أكبر – ومعها مكانة أوروبا، التي كانت تمثل مع واشنطن “العالم الغربي” في حقبة ما بعد الحرب الباردة. فقد اعتادت الدول الأوروبية على الاعتماد على القيادة الأمريكية في شؤون القارة، وعلى وجود نظام عالمي قائم على القواعد (ليس بالضرورة مستوحًى بالكامل من أمريكا) خارجها. لكن مهمة الحفاظ على هذا النظام المتداعي منذ سنوات ستُترك لأوروبا وحدها – وهي قارة تمثل اتحادًا فضفاضًا من الدول، بلا جيش موحد، وبقدرة محدودة على فرض القوة الصلبة، بينما تعاني العديد من دولها من ضعف حاد في القيادة.
يمكن لإدارة ترامب أن تحقق نجاحًا في نظام عالمي معدل ظل قيد التشكيل منذ سنوات. لكن الولايات المتحدة لن تزدهر إلا إذا أدركت واشنطن خطر تعدد الخطوط الفاصلة الوطنية المتشابكة، وعملت على تحييد هذه المخاطر عبر دبلوماسية صبورة ومنفتحة على الحلول طويلة الأمد. يجب على ترامب وفريقه أن ينظروا إلى إدارة الصراعات كشرط أساسي لعظمة أمريكا، وليس كعائق أمامها.
الجذور الحقيقية لترامبية السياسة الخارجية
غالبًا ما يخطئ المحللون في إرجاع أصول سياسة ترامب الخارجية إلى سنوات ما بين الحربين العالميتين. عندما ازدهرت حركة “أمريكا أولًا” الأصلية في ثلاثينيات القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة تمتلك جيشًا متواضعًا ولم تكن قوة عظمى. وكان أنصار الحركة يسعون، قبل كل شيء، إلى الحفاظ على هذا الوضع، متجنبين الدخول في أي صراعات.
على النقيض من ذلك، يُقدّر ترامب مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى، وهو ما أكده مرارًا في خطاب تنصيبه الثاني. من المؤكد أنه سيزيد الإنفاق العسكري، وقد أثبت بالفعل استعداده للمواجهة من خلال تهديده بالاستيلاء على غرينلاند وقناة بنما. يريد ترامب تقليص التزامات واشنطن تجاه المؤسسات الدولية وتضييق نطاق التحالفات الأمريكية، لكنه لا يسعى إلى انسحاب أمريكي من الساحة العالمية.
يمكن العثور على الجذور الحقيقية لنهج ترامب في الخمسينيات، وتحديدًا في الموجة اليمينية لمعاداة الشيوعيّة التي اجتاحت ذلك العقد. لكن هذه النزعة لم تكن مستوحاة من النسخة الليبرالية لمعاداة الشيوعية التي دافعت عن نشر الديمقراطية والكفاءة التكنوقراطية والنشاط الدولي القوي – وهي الرؤية التي تبناها رؤساء مثل هاري ترومان ودوايت أيزنهاور وجون كينيدي لمواجهة التهديد السوفيتي. بل إن رؤية ترامب تنبع من حركات اليمين المعادي للشيوعية في الخمسينيات، والتي رسمت صراعًا بين الغرب وأعدائه، استندت إلى رموز دينية، وأبدت ريبة تجاه الليبرالية الأمريكية، معتبرةً إياها ضعيفة، متجاوزة للأطر الوطنية، وعلمانية للغاية بحيث لا يمكنها حماية البلاد.
يمكن تلخيص هذا الإرث السياسي في ثلاثة كتب رئيسية. أولها كتاب “الشاهد” (Witness) للصحفي الأمريكي ويتاكر تشامبرز، وهو جاسوس سوفيتي سابق انشق عن الحزب الشيوعي وأصبح مفكرًا محافظًا بارزًا. في كتابه، وصف “خيانة الليبراليين الأمريكيين”، مدعيًا أن مواقفهم شجعت الاتحاد السوفيتي ومكنته من التوسع. أما الكتاب الثاني، “انتحار الغرب” (Suicide of the West) لجيمس بورنهام، وهو أبرز مفكري السياسة الخارجية المحافظين في حقبة ما بعد الحرب، فقد انتقد نخبة السياسة الخارجية الأمريكية، متهمًا إياها بأنها نخبوية وغير وفية لمصالح الأمة، وأنها تتمسك بمبادئ دولية وعالمية أكثر من كونها محلية أو وطنية. دعا بورنهام إلى سياسة خارجية مرتكزة على الأسرة، والمجتمع، والكنيسة، والوطن، والحضارة – ولكن ليس الحضارة بشكل عام، بل الحضارة الخاصة التي ينتمي إليها الفرد. هذا الإرث الفكري، الذي يدمج القومية المحافظة، والتوجس من الليبرالية، والعداء للأممية، هو ما يُشكل اليوم الركيزة الفكرية لترامبية السياسة الخارجية.
أحد الخلفاء الفكريين لبورنهام كان صحفيًا شابًا يُدعى بات بوكانان. دعم بوكانان باري غولدواتر في الانتخابات الرئاسية لعام 1964، وكان مساعدًا للرئيس ريتشارد نيكسون، وفي عام 1992، شن تحديًا أوليًا قويًا ضد الرئيس الجمهوري حينها، جورج بوش الأب. تعد أفكار بوكانان الأقرب إلى التنبؤ بظهور عصر ترامب. في عام 2002، نشر بوكانان كتابه “موت الغرب” (The Death of the West)، حيث لاحظ أن “البيض الفقراء يتحركون نحو اليمين”، واعتبر أن “الرأسمالي العالمي والمحافظ الحقيقي هما كقابيل وهابيل”. وعلى الرغم من عنوان الكتاب، لم يكن بوكانان فاقدًا للأمل تمامًا في مستقبل الغرب (بالمعنى الذي يراه قائمًا على “نحن وهم”)، وكان واثقًا من أن العولمة ستتفكك قريبًا. كتب قائلًا: “لأنها مشروع للنخب، ولأن مهندسيها مجهولون وغير محبوبين، فإن العولمة ستتحطم على الحاجز العظيم للوطنية”.
لم يستوعب ترامب هذا التقليد المحافظ الممتد لعقود عبر دراسة هذه الشخصيات، بل من خلال غريزته وارتجاله على منصة الحملة الانتخابية. مثل تشامبرز وبورنهام وبوكانان، الذين كانوا جميعًا غرباء مفتونين بالسلطة، يعشق ترامب تحطيم الأيقونات وإحداث القطيعة مع الماضي، ويسعى إلى الإطاحة بالوضع الراهن، ويكره النخب الليبرالية وخبراء السياسة الخارجية. قد يبدو ترامب وريثًا غير متوقع لهؤلاء الرجال وللحركات التي شكّلوها، والتي كانت مشبعة بالأخلاقيّة المسيحية وميلٍ إلى النخبوية في بعض الأحيان. لكنه استطاع بذكاء ونجاح أن يصور نفسه ليس كنموذج مثقف للفضائل الثقافية والحضارية الغربية، بل كأشد المدافعين عنها في مواجهة الأعداء من الداخل والخارج.
التنقيحيون
يتماشى رفض ترامب للعالمية ذات الطابع الشمولي مع مواقف بوتين وشي ومودي وأردوغان. يشترك هؤلاء القادة الخمسة في إدراكهم لحدود السياسة الخارجية، إلى جانب عدم قدرتهم على البقاء في حالة من الجمود. إنهم جميعًا يسعون إلى التغيير، لكن ضمن معايير يفرضونها على أنفسهم. بوتين لا يسعى لجعل الشرق الأوسط روسيّا. شي لا يحاول إعادة تشكيل إفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط على الصورة التي تريدها الصين. مودي لا يحاول بناء نسخ مصغرة من الهند في الخارج. وأردوغان لا يدفع إيران أو العالم العربي ليكونا أكثر تركية. وبالمثل، لا يهتم ترامب بجعل “الأمركة” هدفًا لسياساته الخارجية. بل إن فهمه للتميز الأمريكي يقوم على فكرة أن الولايات المتحدة كيان منفصل عن عالم خارجي غير أمريكي بطبيعته.
يمكن أن يتعايش التنقيح مع هذا التخلي الجماعي عن بناء نظام عالمي ومع تآكل النظام الدولي القائم. بالنسبة إلى شي، فإن التاريخ والقوة الصينية – وليس ميثاق الأمم المتحدة أو تفضيلات واشنطن – هما الحكمان الحقيقيان على وضع تايوان، لأن الصين هي ما يقول إنها عليه. وعلى الرغم من أن الهند لا تقع بجوار نقطة توتر عالمية مثل تايوان، فإنها لا تزال تخوض نزاعات حدودية مع الصين وباكستان لم يتم حلها منذ استقلالها عام 1947. تنتهي الهند حيثما يقول مودي إنها تنتهي.
أما التنقيحية لدى أردوغان، فهي أكثر وضوحًا. سعيًا لتعزيز موقف حلفائه في أذربيجان، سهلت تركيا طرد الأرمن من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، ليس من خلال التفاوض، بل بالقوة العسكرية. لم تشكل عضوية تركيا في الناتو –التي تتطلب التزامًا رسميًا بالديمقراطية واحترام الحدود – عائقًا أمام أردوغان. كما أن تركيا رسخت وجودها العسكري في سوريا. هذا ليس بالضبط إعادة إحياء للإمبراطورية العثمانية، فأردوغان لا يسعى إلى الاحتفاظ بالأراضي السورية إلى الأبد، لكن المشاريع العسكرية-السياسية لتركيا في جنوب القوقاز والشرق الأوسط لها دلالات تاريخية بالنسبة له. بالنسبة لأردوغان، فإن إثبات عظمة تركيا يعني أن تكون تركيا في أي مكان يرى أنه يجب أن تكون فيه.
وسط هذا المد التصاعدي للتنقيحية، تبقى حرب روسيا ضد أوكرانيا القصة المحورية. باسم “العظمة الروسية”، وبقيادته لدولة لا حدود لنطاقها في نظره، يمتلئ خطاب بوتين بالإشارات التاريخية. ذات مرة، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزحة قائلًا إن أقرب مستشاري بوتين هم “إيفان الرهيب، وبيتر الأكبر، وكاترين العظمى”. لكن ما يشغل بوتين حقًا ليس الماضي، بل المستقبل. كان الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نقطة تحول جيوسياسية شبيهة بتلك التي شهدها العالم في أعوام 1914 و1939 و1989. لم يشن بوتين الحرب فقط لتقسيم أوكرانيا أو استعمارها، بل أراد أن يؤسس سابقة يمكن أن تبرر حروبًا مماثلة في مناطق أخرى، وربما تشجع قوى أخرى، مثل الصين، على تبني مغامرات عسكرية مماثلة.
لقد أعاد بوتين كتابة القواعد، ولم يتوقف عن ذلك رغم فشل الغزو في تحقيق أهدافه لروسيا. ومع ذلك، لم يؤدِّ هذا الفشل إلى عزل روسيا عالميًا. لقد أعاد بوتين تطبيع فكرة الحرب واسعة النطاق كوسيلة للغزو الإقليمي، وفعل ذلك داخل أوروبا نفسها، التي كانت يومًا ما النموذج الأبرز للنظام الدولي القائم على القواعد.
ومع ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا لا تنذر بموت الدبلوماسية الدولية، بل يمكن القول إنها أطلقت شرارتها من جديد. فعلى سبيل المثال، توسّع تجمع “بريكس”، الذي يربط رسميًا بين الصين والهند وروسيا (إلى جانب البرازيل وجنوب إفريقيا ودول غير غربية أخرى)، ليصبح أكبر وأكثر تماسكًا إلى حد ما. في المقابل، أصبح تحالف دعم أوكرانيا أكثر من مجرد كيان عابر للأطلسي، حيث يضم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. لا تزال التعددية قائمة، لكنها لم تعد شاملة للجميع.
في هذا المشهد الجيوسياسي المتغير، العلاقات متقلبة ومعقدة. بنى بوتين وشي شراكة، لكنها ليست تحالفًا. ليس لدى شي سبب يدعوه إلى تقليد القطيعة المتهورة التي أحدثها بوتين مع أوروبا والولايات المتحدة. ورغم أنهما خصمان، إلا أن روسيا وتركيا قادرتان على تجنب التصادم في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز. تنظر الهند إلى الصين بريبة. وعلى الرغم من أن بعض المحللين يصنفون الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا على أنها تشكل “محورًا”، إلا أن هذه الدول الأربع مختلفة تمامًا، وتتباين مصالحها ورؤاها للعالم بشكل متكرر.
تتمحور سياسات هذه الدول الخارجية حول التاريخ والتفرد القومي، وفكرة أن القادة الكاريزميين يجب أن يحملوا راية المصالح الروسية أو الصينية أو الهندية أو التركية بشجاعة. وهذا يعقّد أي تقارب حقيقي بينهم، مما يجعل تشكيل محاور ثابتة أمرًا صعبًا. فالمحور يتطلب تنسيقًا مستمرًا، في حين أن العلاقات بين هذه الدول مرنة، مصلحية، وشخصية الطابع. لاشيء هنا مطلق، لا شيء محسوم، ولا شيء غير قابل للتفاوض.
هذا المشهد يناسب ترامب تمامًا. فهو لا يتقيد كثيرًا بالحدود الدينية والثقافية، وغالبًا ما يفضل الأفراد على الحكومات، والعلاقات الشخصية على التحالفات الرسمية. رغم أن ألمانيا حليف في الناتو، وروسيا عدو دائم للولايات المتحدة، إلا أن ترامب اشتبك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال ولايته الأولى، بينما عامل بوتين باحترام. الدول التي يتصارع معها ترامب أكثر من غيرها هي تلك التي تنتمي إلى الغرب. لو عاش هنتنغتون ليرى هذا، لوجده محيرًا تمامًا.
رؤية للحرب
في الولاية الأولى لترامب، كان المشهد الدولي هادئًا نسبيًا. لم تكن هناك حروب كبرى. بدا أن روسيا قد تم احتواؤها في أوكرانيا. بدا أن الشرق الأوسط يدخل فترة استقرار نسبي، ساهمت فيها جزئيًا اتفاقيات أبراهام التي روجت لها إدارة ترامب لتعزيز النظام الإقليمي. أما الصين، فقد بدت مرتدعة عن غزو تايوان، ولم تقترب أبدًا من القيام بذلك. وعلى الرغم من خطاباته الحادة، فقد تصرف ترامب فعليًا كرئيس جمهوري تقليدي، إذ عزز التزامات الدفاع الأمريكية تجاه أوروبا، ورحب بانضمام دولتين جديدتين إلى الناتو، ولم يبرم أي صفقات مع روسيا، وواجه الصين بخطاب متشدد، وناور لتحقيق المكاسب في الشرق الأوسط.
لكن اليوم، تعصف حرب كبرى بأوروبا، والشرق الأوسط يعيش في حالة فوضى، والنظام الدولي القديم بات ممزقًا. يمكن أن تؤدي مجموعة من العوامل إلى كارثة: تآكل القواعد والحدود بشكل أكبر، تصادم مشاريع “العظمة الوطنية” المتباينة التي يغذيها قادة متقلبون والتواصل السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصاعد إحباط الدول المتوسطة والصغيرة، التي تشعر بالسخط تجاه النفوذ غير المقيد للقوى العظمى وتخشى عواقب الفوضى الدولية.
من المرجح أن تندلع كارثة في أوكرانيا أكثر من تايوان أو الشرق الأوسط، لأن إمكانات الحرب العالمية والحرب النووية هي الأكبر في أوكرانيا. حتى في النظام القائم على القواعد، لم تكن قدسية الحدود مطلقة أبدًا، خاصة في المناطق المجاورة لروسيا. لكن منذ نهاية الحرب الباردة، التزمت أوروبا والولايات المتحدة بمبدأ السيادة الإقليمية. استثمارهم الضخم في أوكرانيا يعكس رؤية مميزة للأمن الأوروبي: إذا أمكن تغيير الحدود بالقوة، فإن أوروبا، التي لطالما أنتجت حدودها بؤرًا للصراع، ستنحدر إلى حرب شاملة. إن السلام في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت الحدود غير قابلة للتعديل بسهولة.
في ولايته الأولى، شدد ترامب على أهمية السيادة الإقليمية، متعهدًا ببناء “جدار كبير وجميل” على الحدود الأمريكية مع المكسيك. لكن خلال تلك الولاية، لم يكن عليه التعامل مع حرب كبرى في أوروبا. ومن الواضح الآن أن إيمانه بقدسية الحدود ينطبق بالدرجة الأولى على حدود الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، تبدي الصين والهند تحفظات بشأن حرب روسيا، لكنهما، إلى جانب البرازيل والفلبين والعديد من القوى الإقليمية الأخرى، اتخذتا قرارًا واسع النطاق بالإبقاء على علاقاتهما مع موسكو، حتى مع استمرار بوتين في تدمير أوكرانيا. سيادة أوكرانيا مسألة غير ذات أهمية بالنسبة لهذه الدول “المحايدة”، مقارنة بقيمة روسيا المستقرة تحت حكم بوتين وأهمية استمرار صفقاتها في مجال الطاقة والتسلح.
قد تقلل هذه الدول من مخاطر قبول التنقيحية الروسية، والتي قد لا تؤدي إلى الاستقرار، بل إلى حرب أوسع. إن مشهد أوكرانيا مقسمة أو مهزومة سيكون كابوسًا لجيرانها. إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا أعضاء في الناتو، ويعتمدون على التزام المادة 5 من الميثاق، التي تنص على الدفاع المشترك. لكن المادة 5 مدعومة أساسًا من الولايات المتحدة – والولايات المتحدة بعيدة. إذا استنتجت بولندا وجمهوريات البلطيق أن أوكرانيا على وشك الهزيمة، وأن ذلك قد يهدد سيادتها الخاصة، فقد تختار التدخل مباشرة في الحرب. وقد يكون رد روسيا هو توسيع نطاق القتال ليشملها.
يمكن أن يحدث سيناريو مماثل إذا تم التوصل إلى تسوية كبرى بين واشنطن ودول أوروبا الغربية وموسكو، تؤدي إلى إنهاء الحرب بشروط روسية، ولكنها تؤدي إلى تطرف مواقف جيران أوكرانيا. فمع الخوف من العدوان الروسي من جهة، والشعور بالتخلي عن الحلفاء من جهة أخرى، قد تختار هذه الدول الهجوم بدلًا من الانتظار. حتى لو بقيت الولايات المتحدة على الهامش وسط حرب أوروبية شاملة، فمن غير المرجح أن تظل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة محايدتان.
إذا اتسعت الحرب في أوكرانيا بهذا الشكل، فستكون تداعياتها حاسمة على سمعة ترامب وبوتين. وكما هو الحال غالبًا في الشؤون الدولية، سيلعب الغرور دورًا كبيرًا. بوتين لا يستطيع تحمل خسارة حرب ضد أوكرانيا، تمامًا كما لا يستطيع ترامب تحمل “خسارة” أوروبا. سيكون التفريط في النفوذ والازدهار اللذين تجنيهما الولايات المتحدة من وجودها العسكري في أوروبا بمثابة إذلال لأي رئيس أمريكي. ستكون الدوافع النفسية للتصعيد قوية. وفي نظام دولي شخصيّ بشدّة، ومضطرب بفعل دبلوماسية رقمية غير منضبطة، يمكن أن تنتشر هذه الديناميكية إلى مناطق أخرى، مما قد يفجر صراعات بين الصين والهند، أو بين روسيا وتركيا.
رؤية للسلام
إلى جانب هذه السيناريوهات الأسوأ، يمكن النظر إلى كيف يمكن لولاية ترامب الثانية أن تحسّن الوضع الدولي المتدهور. مزيج من علاقات أمريكية براغماتية مع بكين وموسكو، ونهج دبلوماسي مرن في واشنطن، وقليل من الحظ الاستراتيجي قد لا يؤدي بالضرورة إلى اختراقات كبرى، لكنه قد يخلق وضعًا أفضل. ليس إنهاءً للحرب في أوكرانيا، ولكن تقليلًا لحدّتها. ليس حلًا لمعضلة تايوان، ولكن إرساء ضوابط تمنع اندلاع حرب كبرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ليس تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن انفراجًا أمريكيًا مع إيران الضعيفة، وظهور حكومة قابلة للحياة في سوريا. قد لا يصبح ترامب صانع سلام غير مشروط، لكنه قد يساهم في خلق عالم أقل تمزقًا بالحروب.
في ظل إدارة بايدن وسابقيه باراك أوباما وجورج دبليو بوش، واجهت روسيا والصين ضغوطًا ممنهجة من واشنطن. وقفت موسكو وبكين خارج النظام الليبرالي العالمي، جزئيًا باختيارهم، وجزئيًا لأنهما لم يكونا ديمقراطيتين. بالغ القادة الروس والصينيون في تصوير هذه الضغوط، وكأن تغيير الأنظمة كان هدفًا أمريكيًا صريحًا، رغم أن واشنطن كانت تميل بالفعل إلى التعددية السياسية، والحريات المدنية، والفصل بين السلطات.
لكن بعودة ترامب إلى السلطة، تلاشت هذه الضغوط. ترامب غير مهتم بطبيعة الحكومات في روسيا والصين، إذ يرفض رفضًا قاطعًا بناء الدول وتغيير الأنظمة. رغم استمرار مصادر التوتر، سيكون المناخ العام أقل احتدامًا، وستصبح الدبلوماسية أكثر احتمالًا. قد يكون هناك مجال للمقايضات داخل مثلث بكين-موسكو-واشنطن، ومزيد من التنازلات الصغيرة، وانفتاح أكبر على التفاوض وبناء الثقة في مناطق النزاع والتوتر.
إذا تمكن ترامب وفريقه من ممارسة دبلوماسية مرنة – إدارة بارعة للتوترات المستمرة والصراعات المتنقلة – فقد تكون العوائد كبيرة. ترامب هو أقل الرؤساء الأمريكيين تمسكًا بالمبادئ الويلسونية منذ وودرو ويلسون نفسه. فهو لا يرى جدوى من الهياكل الشاملة للتعاون الدولي مثل الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بدلًا من ذلك، قد يتعامل ترامب ومستشاروه – وخصوصًا القادمون من عالم التكنولوجيا – مع السياسة العالمية بعقلية الشركات الناشئة: كيان تم إنشاؤه للتفاعل بسرعة وإبداع مع الظروف الراهنة، دون أن يكون بالضرورة دائمًا.
ستكون أوكرانيا أول اختبار مبكر. بدلا من السعي إلى سلام متسرع، ينبغي على إدارة ترامب أن تركز على حماية سيادة أوكرانيا، وهي مسألة لن يقبل بها بوتين أبدًا. السماح لروسيا بتقليص سيادة أوكرانيا قد يخلق استقرارًا ظاهريًا، لكنه قد يؤدي إلى حرب جديدة. بدلا من سلام زائف، ينبغي على واشنطن مساعدة أوكرانيا في تحديد قواعد الاشتباك مع روسيا، ومن خلال هذه القواعد، يمكن تهدئة الحرب تدريجيًا.
عندها، يمكن للولايات المتحدة أن تفصل نزاعها مع روسيا عن ملفات أخرى، كما فعلت مع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، بحيث تتفق على عدم الاتفاق بشأن أوكرانيا، لكنها تبحث عن نقاط تعاون محتملة في مجالات مثل الحد من الانتشار النووي، ومراقبة التسلح، والتغير المناخي، والأوبئة، ومكافحة الإرهاب، والقطب الشمالي، واستكشاف الفضاء. إن فصل الصراعات عن بعضها البعض مع روسيا يخدم مصلحة أمريكية جوهرية، وهي منع اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي أولوية عزيزة على ترامب.
إن أسلوبا دبلوماسيّا لائقا يمكن أن يسهل الاستفادة من الحظ الاستراتيجي. توفر الثورات التي شهدتها أوروبا عام 1989 مثالًا جيدًا على ذلك. غالبًا ما يُنظر إلى انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي على أنه نتيجة لتخطيط أمريكي محكم، لكن سقوط جدار برلين لم يكن مرتبطًا كثيرًا بالاستراتيجية الأمريكية، كما أن تفكك الاتحاد السوفيتي لم يكن متوقعًا من قبل الحكومة الأمريكية؛ لقد كان كل ذلك نتاج الصدفة والحظ. تميّز فريق الأمن القومي للرئيس جورج بوش الأب ليس في التنبؤ بالأحداث أو التحكم بها، ولكن في الاستجابة لها بذكاء، دون القيام بالكثير (استفزاز الاتحاد السوفيتي) أو القليل جدًا (السماح لألمانيا الموحدة بالابتعاد عن الناتو). بنفس هذا النهج، ينبغي أن تكون إدارة ترامب مستعدة لالتقاط الفرص عند ظهورها. ولتحقيق أقصى استفادة مما قد يأتي في طريقها، يجب ألا تنشغل بالهياكل والأنظمة البيروقراطية.
لكن الاستفادة من الفرص العشوائية تتطلب الاستعداد بقدر ما تتطلب المرونة. في هذا الصدد، تمتلك الولايات المتحدة أصلين استراتيجيين رئيسيين. الأول هو شبكة تحالفاتها، التي تمنح واشنطن قوة تأثير هائلة وقدرة أوسع على المناورة. والثاني هو الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية، التي توسع قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى الأسواق والموارد الحيوية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحافظ على النظام المالي الأمريكي كنقطة ارتكاز أساسية في الاقتصاد العالمي. يمكن أن يكون للحمائية والسياسات الاقتصادية القسرية دورها، لكنها يجب أن تكون خاضعة لرؤية أوسع وأكثر تفاؤلًا حول الازدهار الأمريكي، وهي رؤية تعطي الأولوية للحلفاء والشركاء التاريخيين.
لم يعد أي من الأوصاف التقليدية للنظام العالمي ينطبق على الوضع الراهن؛ فالنظام الدولي لم يعد أحادي القطب، ولا ثنائي القطب، ولا متعدد الأقطاب. لكن حتى في عالم يفتقر إلى هيكل مستقر، لا تزال إدارة ترامب قادرة على استخدام القوة الأمريكية، والتحالفات، والدبلوماسية الاقتصادية لتهدئة التوترات، وتقليل النزاعات، ووضع حد أدنى من التعاون بين الدول الكبرى والصغرى. يمكن أن يخدم ذلك رغبة ترامب في أن يترك الولايات المتحدة في وضع أفضل في نهاية ولايته الثانية مما كانت عليه في بدايتها.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”50″ accent_color=”#7d89aa”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4712″ img_size=”165.094*114.6486″][vc_separator color=”custom” style=”dashed” border_width=”2″ el_width=”50″ accent_color=”#7d89aa”][/vc_column][/vc_row]