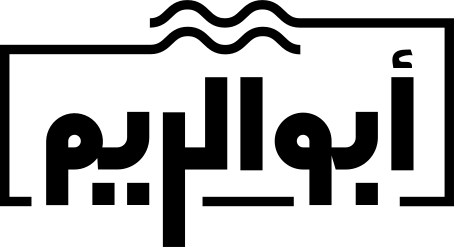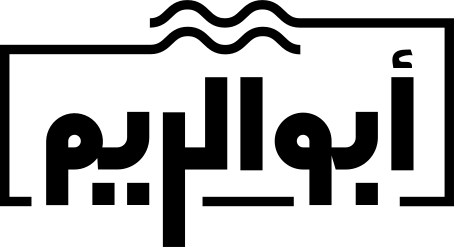[vc_row][vc_column][vc_column_text]
في أعقاب الهجوم على منشآت شركة “أرامكو” في شرق السعوديّة في أيلول 2019، دقّت أجراس الإنذار في أروقة المؤسسة العسكريّة والأمنيّة الإسرائيليّة كما لم تدق في أيّ يومٍ آخر خلال العقود الأخيرة، فقد مثّل الهجوم في حينه عرضا بالذخيرة الحيّة للقدرات الصاروخيّة الإيرانيّة وللنتائج التي يُمكن أن تترتّب على هجومٍ مُشابه، ولكن بأعداد أكبر من الصواريخ والطائرات المُسيّرة، على المواقع الحسّاسة في إسرائيل.
منذ ذلك الهجوم، صكّ صنّاع السياسة الدفاعيّة في إسرائيل مصطلح “سيناريو أرامكو” ليكون بمثابة مفهومٍ عمليّاتيّ يجري في إطاره تصميم الاستعدادات الهادفة لمنع تحقّق هذا السيناريو أو تحجيم آثاره إن وقع. وفي نهايات العام 2020، أي في غضون عام واحد تقريبا من الهجوم، قامت منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيليّة بالتعاون مع نظيرتها الأمريكيّة، بإجراء اختبارٍ لمنظومة الدفاع الجويّ مُتعدّد الطبقات لأوّل مرة في تاريخ إسرائيل، حيث شُغّلت في ذلك الاختبار منظومات “السهم” و”مقلاع داود” و”القبة الحديديّة” و”باتريوت” بشكلٍ مُتزامن لمحاكاة هجوم شبيه بهجوم “أرامكو” ودراسة مدى تكامل هذه المنظومات مع بعضها البعض في ظروف الحرب.
وعلى المستوى النظريّ، فقد استرعى هجوم “أرامكو” اهتمام كبار المُنظّرين العسكريين والتقنيين الإسرائيليين، وكان على رأس هؤلاء البروفيسور عوزي روبين، الذي كتب في صيف عام 2020 مقالا مهمّا، جادل فيها بأنّ استحواذ أعداء إسرائيل على صواريخ دقيقة يُمثّل تحوّلا في تاريخ الحرب، لأنّها منحتهم الأدوات التي تُمكّنهم من تحقيق التفوّق الجوي من دون أن يكون لديهم طائرة مُقاتلة واحدة، وذلك من خلال تعطيل أو إضعاف قدرة إسرائيل على استخدام قوّتها الجويّة عبر ضرب مطاراتها في اللحظة الأولى من الحرب.
قمتُ في أعقاب نشر مقال روبين بترجمته، وقد كتبتُ أيضا هوامش مطوّلة له لشرح الكثير من التفصيلات التاريخيّة التي وردت فيه، وهي تفصيلاتٌ أعتقد أن غياب هوامش شارحة لها قد يمنع القاريء غير المتخصّص من فهم المقال على نحو جيّد، وعلى رأسها التفصيلات المُتعلّقة بعمليّة “موكيد” (البؤرة) التي افتتحت بها إسرائيل هجومها على المطارات المصريّة صبيحة الخامس من حزيران 1967، وعملية “الصرّار 19” التي دمّر خلالها الطيران الإسرائيليّ الدفاعات الجويّة السوريّة في سهل البقاع في حزيران في 1982. ومع الأسف، فقد أضعتُ الهوامش المطوّلة التي كتبتها بخطّ اليد ولم يتبق لدي سوى الترجمة التي لم أنشرها منذ ذلك الوقت.
في أعقاب الهجوم الصاروخيّ الإيرانيّ الأخير على إسرائيل، والذي سنحتاج لبعض الوقت لفهم الكيفية التي سيؤثر فيها على العقليّة الإسرائيليّة وتحديدا في مسألة الدفاع الجويّ، تذكّرت مقال روبين، وقد قلتُ لنفسي أن الوقت قد يكون مناسبا الآن للإفراج أخيرا عن هذه الترجمة ومشاركتها هُنا رغم قِدمها، وذلك في محاولة لإلقاء الضوء على جانبٍ من طريقة التفكير الإسرائيليّة إزاء مسائل الدفاع في مواجهة الصواريخ الدقيقة والمسيّرات الانتحاريّة والحلول المقترحة للمعضلات التي يمثّلها هذا التهديد بالنسبة لإسرائيل.
وبرأيي المتواضع، فإن عوزي روبين هو من بين أفضل الإسرائيليين الذين يُمكن لهم مقاربة هذا النوع من القضايا. فالرجل مهندس طيرانٍ مُتخصّص، حصل على لقبه الدراسي الأوّل من معهد “التخنيون” بحيفا وعلى لقبه الثاني من معهد “رينسلر” التقني في نيويورك. وهو أيضا رجلٌ عسكريّ خدم في وحدة مضادة للدروع خلال حرب يونيو/حزيران 1967 وحرب أكتوبر/تشرين أوّل 1973. لكنّ الأهم من ذلك كلّه، أن روبين كان الشخص الذي اختاره إسحق رابين وزير الدفاع الإسرائيليّ في الثمانينيّات ليتولّى المكتب المسئول عن تنسيق التعاون مع الجانب الأمريكيّ في “مبادرة الدفاع الاستراتيجي” (وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس رونالد ريغان والتي يمكن اعتبارها الأساس وراء إنتاج كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيليّة). وعلاوة على ذلك، فقد كُلّف روبين في مطلع التسعينيّات بتأسيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيليّة التابعة لوزارة الدفاع، لذا فهو يعدّ بحق أب برنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيليّ والمهندس الرئيسي وراء منظومة “السهم” (حيتس)، أي يمكن القول أنّه المكافيء الإسرائيلي لحسن طهراني مُقدّم أب برنامج الصواريخ الإيراني.
=================================
يُمثّل ظهور الصواريخ والمقذوفات ذات الدقّة النقطيّة في ميدان المعركة، نقطة تحوّل في تاريخ الحرب، وذلك لأنّها منحت المنظّمات الإرهابيّة والميليشيّات، الأدوات التي تُمكّنها من تحقيق التفوّق الجويّ دون تشغيل أيّ طائرة مقاتلة.
يعني التفوّق الجويّ النفاذ إلى المجال الجويّ المُعادي، وفي نفس الوقت، حرمان العدو من النفاذ إلى المجال الجويّ الصديق. يمنح التفوّق الجوي صاحبه حريّة العمل في قصف العدو كيفما يشاء وحينما يشاء. حريّة العمل هذه تتحقّق من خلال القوّة الجويّة التقليديّة، أي عبر سحق القوّة الجويّة المُعادية وتحييد الدفاعات الجويّة التابعة للعدو. النقطة المحوريّة في هذا الجُهد المُكلف لا تتمثّل في تحقيق الإشباع الناجم عن إسقاط طائرات العدو أو تدمير بطّاريات الدفاع الجويّ خاصّته، بل في تفكيك قدرات العدو التي تُمكّنه من شنّ الحرب وإدارتها، وذلك عبر تدمير قوّاته البريّة والبحريّة وتعطيل اقتصاده.
بدأت كلّ حملة عسكريّة في الحرب العالميّة الثانية بمحاولة من أجل فرض السيطرة الجويّة. لقد نجحت قوّات “اللوفتفافه” (سلاح الجو الألماني خلال العهد النازي) في تحقيق هذه السيطرة في بولندا، النرويج، وفرنسا، مُلحقة هزيمة خاطفة بقوّات هذه الدولة، وفاتحة الطريق أمام “الفرماخت” لاحتلال هذه البلدان. لكن “اللوفتفافه” فشلت في فرض هذه السيطرة على بريطانيا، الأمر الذي دفع إلى إلغاء خطّة هتلر لاجتياح الجزر البريطانيّة المعروفة باسم “أسد البحر”. لقد كان للنصر الدفاعي الذي تحقّق في معركة بريطانيا آنذاك عقابيل استراتيجيّة بعيدة المدى، فقد بدأت في أعقابه العمليّة الطويلة والمريرة لهزيمة ألمانيا النازيّة.
في العام 1967، افتتحت إسرائيل حرب الأيّام الستّة بعمليّة “البؤرة” التي محقت القوّة الجويّة لمصر والأردن وسوريا. لقد كان هدف تلك العمليّة مزدوجا: الأوّل هو حرمان العدو من مُهاجمة إسرائيل وقوّاتها من الجو، والثاني هو توفير مظلّة لهجوم قوّات الجيش الإسرائيلي والذي أفضى في نهاية المطاف إلى هزيمة القوّات البريّة المُعادية. خلال عهد أنور السادات، أطلقت مصر عمليّة مشابهة عندما بدأت حرب 1973، لكن النتيجة لم تكن حاسمة، وهو ما قاد إلى فشل مصر في تحقيق أهدافها العسكريّة (رغم أنّها نجحت في تحقيق أهدافها السياسيّة). في عمليّة “الكريكيت الخلد 19” في المرحلة الافتتاحيّة لحرب لبنان 1982، حقّق سلاح الجو الإسرائيليّ سيطرة جويّة كاملة فوق سوريا ولبنان، وهو ما مكّن بشكلٍ كبير، من إخراج القوّات البريّة السوريّة من الحرب.
إنّ المعارك الجويّة المُذهلة وصفوف شعارات العدو المرسومة على أنوف الطائرات المُقاتلة المنتصرة ومقاطع الفيديو التي تُظهر بطاريّات الدفاع الجويّ المُدمّرة للعدو ترفع معنويات الأمّة وتحبط العدو وتجعل من الطيّارين نجوم الميديا. لكن، ليس هذا في الواقع الهدف الرئيسي للجهود والنفقات الهائلة التي تنطوي عليها عمليّة تأسيس سلاح جويّ حديث والمحافظة عليه، وليس هذا ما يُبرّر الخسائر في المعارك الجويّة. إنّ الهدف الاستراتيجيّ للجهد والألم هو أوّلا حرمان العدو من مجالٍ جويّ صديق والثاني هو فتح المجال الجوي للعدو أمام المقاتلات الصديقة بما يمكّنها من استهداف أراضيه كيفما وحينما تشاء.
منذ أوائل القرن العشرين، ومع تطوّر المحرّكات الطائرة من ألعاب للرجال الأثرياء إلى أسلحة فتّاكة في الحرب، قامت كلّ جيوش العالم بالاستثمار بكثافة في التصدّي للتهديدات القادمة من الجو. في البداية، تركّزت هذه الجهود على “منع الوصول”، أو بكلماتٍ أخرى، منع الطائرات المعادية من جمع معلوماتٍ استخباريّة بصريّة عن مواقع القوّات الصديقة وحظر القصف المُعادي للقوّات والمدن. تمثّلت الاستجابّة في حينه بإكمال ونشر أنظمة الدفاع الجويّ المُتكامل التي تعتمدُ على الطائرات الاعتراضيّة والمدافع المُضادة للطائرات (والتي حلّت محلّها لاحقا صواريخ أرض-جو). لقد كانت معركة بريطانيا هي أوّل انتصارٍ لاستراتيجيّة “منع الوصول”، مع نجاح بريطانيا في جمع أجهزة الرادار والطائرات المُقاتلة ومراكز على السيطرة على النيران في أوّل نظام حديثٍ للدفاع الجويّ المُتكامل.
في المراحل اللاحقة في الحرب العالميّة الثانية، وعندما أصبح نظام الدفاع الجويّ البريطانيّ المُتكامل عصيّا على الاختراق من قِبل “اللوفتفافه”، تبنّى الألمان فكرة القصف بالصواريخ بدلا من الطائرات. ولمّا كانت الدفاعات الجويّة في ذلك الزمن عاجزة عن اعتراض الصواريخ التي تندفع أسرع من الصوت، فقد بشرّت الصواريخ البالستيّة مُجدّدا بـ “الاختراقيّة” التي كانت القاذفات التقليديّة قد خسرتها. مثّل ذلك الأمر تحوّلا كبيرا. من خلال القيام بهذا التعديل، حقّقت ألمانيا جوهر السيطرة الجويّة الكلاسيكيّة، أي تحقيق حريّة قصف العدو في أي وقت وبدون خسارة طائراتٍ مُقاتلة أو طيّارين.
رغم أنّ الصواريخ البالستيّة والمجنّحة الألمانيّة عاثت الخراب وقتلت الآلاف في بريطانيا ولاحقا في بلجيكا، فإنّ افتقارها للدقّة حال دون تغيير مسار الحرب. إن عدم التكافؤ بين الجهود الألمانيّة الهائلة في تطوير وبناء وإطلاق الصواريخ -والذي يُعدّ إنجازا تقنيّا مُبهرا بحدّ ذاته- وبين تأثيرها الضئيل على الحرب، جرى استيعابه في كلّ المؤسسات العسكريّة ما بعد الحرب، بما فيها الجيش الإسرائيلي. لقد أعمت مقولة “الصواريخ لا تكسب الحرب” عيون إسرائيل لسنوات طويلة عن الخطر المُحدق للصواريخ.
بين الحربين العالميّة الأولى والثانية، عملتْ القوّات الجويّة -وتحديدا البريطانيّة والأمريكيّة- على تحقيق الهدف الثاني من السيطرة الجويّة والمتمثّل في ضمان اختراق المجال الجويّ للعدو بأساطيل من المُدمّرات الاستراتيجيّة. خلال الحرب العالميّة الثانية، أدّى القصف الاستراتيجيّ بأسراب المدمّرات الثقيلة إلى إحداث دمار لا يُمكن تخيّله للمدن الألمانيّة وقتلت ما لا يقلّ عن مليون مدنيّ، لكن تأثير كلّ هذا على مسار الحرب كان لا يزال خاضعا للجدل. لقد كانت خسائر القوّات الجويّة لقوات الحلفاء على يد أنظمة الدفاع الجويّ الألمانيّة المُتكاملة عند مستوياتٍ غير مقبولة. وفقط في مرحلة التراجع، عندما استنفذت قدرات “اللوفتفافه” بشكلٍ شبه تام، تمكّنتْ مُدمّرات الحُلفاء من اختراق المجال الجويّ الألمانيّ بخسائر مقبولة.
لاحقا، اصطدم الهجوم الجويّ والدفاع الجويّ في جنوب شرق آسيا، وذلك عندما تمكّنتْ الأنساق الكثيفة للدفاع الجويّ الفيتاميّ الشماليّ مع الاستخدام الحصيف للطائرات الاعتراضيّة، في إحباط السيطرة الجويّة الأمريكيّة وانتزاع ثمن باهظ متمثّلا في إسقاط الطائرات الأمريكيّة وخسارة وأسر طواقمها.
المَعلمُ الآخر -رغم أنّه منسي إلى حدودٍ بعيدة- في الصراع بين الهجوم الجويّ والدفاع الجويّ وقع أثناء الحرب العراقيّة الإيرانيّة 1980-1988. فمجرّد أن تلاشت خطّة صدّام حسين لهزيمة إيران عبر حملة بريّة خاطفة، تدهور الصراع إلى حرب استنزاف قامت خلالها القاذفات العراقيّة المُشتراة من الاتحاد السوفييتيّ بقصف طهران ومدنٍ إيرانيّة أخرى. كانت القوّات الجويّة الإيرانيّة في ذلك الوقت مزوّدة بأحداث طائرات الاعتراض الأمريكيّة التي تمّ شراؤها خلال فترة الشاه قبل الثورة الإسلاميّة. وقد نجحت هذه الطائرات في حينه من إسقاط العديد من القاذفات العراقيّة وهو ما دعى صدّام حسين إلى إلغاء حملة القصف الاستراتيجيّ.
دفع اليأس صدّام، مثل هتلر من قبله، إلى اللجوء إلى الصواريخ البالستيّة. لكن ترسانة صواريخ “سكود” السوفييتيّة التي كانت بحوزة العراق آنذاك كانت قصيرة المدى بطريقة تحول دون استهداف العمق الإيرانيّ. مستعينا بخبرات الشركات الجوفضائيّة في أوروبا وأمريكا الجنوبيّة، حوّل العراق معظم مخزونة من صواريخ “سكود” إلى صواريخ ذات مدى أطول، وقد سُميت النسخ الجديدة من الصاروخ باسم “الحسين” واُستخدمت في القصف الاستراتيجي.
أُطلق قُرابة الـ 200 صاروخ على طهران وعلى ثلاثة مدنٍ رئيسيّة أخرى في العمق الإيراني ممّا خلّف الآلاف من القتلى والمنازل المدمّرة وأجبر الملايين على النزوح من المدن. الفكرة السائدة لدى غالبيّة المُحلّلين هي أنّ الهجمات الصاروخيّة تلك هي التي أجبرت المُرشد الأعلى الإيرانيّ آية الله خميني على “تجرّع السم” والقبول باتفاق وقف لإطلاق النار. بعد ثمان سنوات من إراقة الدماء، خرج العراق منتصرا. ويمكن الاستخلاص بشكلٍ آمن أنه وفي تلك الحالة، فازت الصواريخ بالحرب.
اختارت مصر في عهد جمال عبد الناصر أيضا استراتيجيّة استخدام الصواريخ البالستيّة كقوّة جويّة بديلة. كان ناصر فطنا بما فيه الكفاية ليدرك تخلّف سلاح الجو المصريّ في مواجهة نظيره الإسرائيليّ في أعقاب حرب السويس 1956. عندما رُفض طلبه للحصول على صواريخ بالستيّة من قِبل السوفييت، استأجر مجموعة من الخبراء الألمان لتطوير قاعدة محليّة لصناعة الصواريخ البالستيّة التي يُمكن لها استهداف أي نقطة في إسرائيل. المنطق وراء خطوة عبد الناصر كان محاكاة لهتلر وسابقة لما سيقوم به صدّام لاحقا. ولأنّه كان عاجزا عن تحقيق السيطرة الجويّة من خلال أسطول الطائرات المُقاتلة المأهولة، فقد جاهد ناصر لتحقيق ذات الهدف عبر الصواريخ البالستيّة.
المنطق ذاته هو الذي أجبر حافظ الأسد، حاكم سوريا، بعد هزيمة سلاح الجو السوريّ في حرب لبنان 1982، للحصول على ترسانة ضخمة من صواريخ “سكود” مزوّدة برؤوس كيميائيّة مصنّعة محليّا. وزير دفاعه مصطفى طلاس أشار إلى التبادليّة بين الطائرات المُقاتلة والصواريخ عندما كتب: “حرب العام 1982 كانت حربا جويّة، لكن الحرب القادمة ستكون حرب صواريخ”.
في الوقت الحالي، تُواجه المنظّمات الإرهابيّة إسرائيل من لبنان وغزّة. حزب الله وحماس لم يكن لديهما الخيار في أيّ وقت لبناء قوّة جويّة. ولذلك، فقد زودا نفسيهما بمخزون ضخم من الصواريخ البسيطة واستخدموها لإرهاب إسرائيل وقتل المئات من المدنيين وإحداث خسائر كبيرة في الممتلكات والاقتصاد.
الصواريخ والمقذوفات كما تمّ تخيّلها بالأصل خلال الحرب العالميّة الثانية لم تكن مُتقنة بما يكفي للقيام بضرباتٍ دقيقة. ونتيجة لذلك، فقد اُستخدمتْ بشكلٍ رئيسيّ لإغراق تجمّعات القوّات بالنيران وإرهاب المراكز السكّانيّة. تحسين الدقّة كان من الممكن تحقيقه فقط من خلال أنظمة التوجيه الكهروميكانيكيّة المُعقّدة والمكلفة. لهذا السبب، ظلّت الضربات الدقيقة مجالا حصريّا للطائرات المُقاتلة المأهولة التي تستطيع الاقتراب من الأهداف وضربها بصواريخ دقيقة موجّهة قصيرة المدى.
بالرغم من ذلك، استطاعت التكنولوجيا عبر الزمن من مواكبة التطوّر. فالهواتف الذكيّة اليوم تحتوي على كلّ الوسائط الضروريّة للتوجيه الدقيق للمركبات أكانت سيارات أو طائرات “درونز” أو صواريخ. لما يقرب من العقد الآن، أصبح ممكنا إدماج هذه التقنيّات في صاروخ “غراد” وتحويله من مقذوفة غير موجّهة إلى صاروخ دقيق بتكلفة متواضعة.
هذه النقلة التكنولوجيّة جعلتْ الصواريخ فعّالة مثل القوّة الجويّة في مجال القصف الدقيق. واليوم، يجري تطوير الصواريخ الدقيقة الموجّهة على يد كلّ القوى الكبرى في العالم وعلى يد دول صغيرة أيضا. في الشرق الأوسط، تقود إيران القافلة، إذ تقوم الآن بتحويل كلّ مقذوفاتها القديمة وصواريخها إلى أسلحة دقيقة. وهي تقوم أيضا بتزويد حلفائها في المنطقة بالخبرة والمواد التي تمكّنهم من تطوير قدراتهم الخاصّة في هذا المضمار مثل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان.
لماذا إسرائيل توّاقة بشدّة لإحباط مشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة؟ لأنّه بمجرّد تحقيق هذا المشروع، فإنّه سيرفع قدرات حزب الله في شنّ الحرب إلى مرتبة قوّة عسكريّة نظاميّة. سيتمكن حزب الله عندها من الحصول على كلّ مزايا القوّة الجويّة الهجوميّة بدون الحاجة لطائرة مقاتلة واحدة. وسيكون بمقدور صواريخ الحزب الدقيقة تعطيل أي منشأة حيويّة أو إرهاب أي مركز سكّاني في إسرائيل.
واحدةٌ من أكبر مزايا المقذوفات والصواريخ هي بصمتها المتواضعة. والصواريخ الموجّهة بدقّة تتمتّع بنفس الميزة أيضا، إذ أنّ منصّات إطلاقها صغيرة وشبحيّة ومن الصعوبة تحديد أماكنها وتدميرها. على العكس من ذلك، فإنّ “كعب أخيل” القوّة الجويّة الكلاسيكيّة هو اعتمادها على قواعد ضخمة مليئة بالمدراج التي يبلغ طولها عدّة كيلو مترات وبحظائر الطائرات والورش ومراكز الاتّصالات وغيرها.
إنّ هشاشة القواعد الجويّة الضخمة والثابتة إزاء الصواريخ الدقيقة كُشفت أثناء الهجوم الإيراني في يناير/كانون ثاني 2020 على قاعدة عين الأسد الجويّة التي تُديرها الولايات المتحدة في العراق. قبل الهجوم، قام فريق أمريكي في القاعدة بإطلاق عدد من الطائرات المسيّرة للقيام بدوريّة في المنطقة المحيطة. أحد الصواريخ الإيرانيّة أصاب مركز اتصالات تحت الأرض وقطع خطوط الألياف البصريّة بين شاحنات التحكّم بالطائرات المسيّرة وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصّة بالنظام. وقد سبّب هذا الأمر خسارة طاقم التحكّم سيطرته على سرب الطائرات المسيّرة، وقد احتاج الأمر لبضعة ساعات لإعادة الاتّصال عبر الأقمار الصناعيّة وإعادة الطائرات مُجدّدا إلى القاعدة. ولا حاجة للقول أنّ الطائرات الأمريكيّة المُقاتلة الرابضة في العراق كانت بلا حول ولا قوّة أثناء الهجوم الإيراني. ولنضع الأمر بعبارة بسيطة، نقول أنّ إيران حظيت في تلك اللحظة بسيطرة جويّة فوق القاعدة بفعل تأثير الصواريخ الدقيقة.
بمجرّد أن يُزوّد حزب الله بصواريخ دقيقة، سيكون من المنطقي أن يُطلق عمليّة “البؤرة” خاصّته في المرحلة الافتتاحيّة في أيّ حرب مستقبليّة مع إسرائيل، مُطلقا رشقاتٍ من الصواريخ لتعطيل قواعد إسرائيل الجويّة. سيكون بمقدور بنية إسرائيل الدفاعيّة الفعّالة – “القبّة الحديدية”، “صولجان داود” وأي نظام دفاعٍ جويّ ليزري مستقبلي- إسقاط غالبيّة الصواريخ القادمة لكن ليس كلّها. الدفاع الفعّال لا يستطيع ضمان دفاعٍ كامل، والصواريخ البالستيّة التي ستستطيع التسرّب عبر الدرع الدفاعي بإمكانها تقليص قدرات سلاح الجو الإسرائيلي والهجمات الإيرانيّة على قاعدة “عين الأسد” شاهدةٌ على هذا الأمر.
في مواجهة الصواريخ الدقيقة، يعدّ الدفاع النشط أمرا ضروريّا لكنه ليس كافيا، إذ أنّه يحتاج إلى تدابير مُكمّلة. واحدٌ من هذه التدابير هو الدفاع السلبي والذي يعني تحصين المنشآت الحيويّة بجدران سميكة من الخرسانة التي يمكن لها أن تُقاوم الضربات المُباشرة. ورغم أنّ هذا الحل ممكن من الناحية التقنيّة، إلا أنّه مُكلف للغاية وسيستهلك الكثير من الوقت. وحتى لو تمّ تخصيص الميزانيّة المطلوبة، فليس هنالك ضمانة أن عمليّة التحصين هذه ستُنجز في الوقت المُحدّد.
أحد الحلول الأخرى يتمثّل في تنويع القدرات الهجوميّة لسلاح الجو الإسرائيليّ وذلك للتعويض عن تراجع قوّاتها الهجوميّة خلال المرحلة الأولى من الحرب المستقبليّة. إذا كان بمقدور حزب الله أن يُؤسّس “قوّة جويّة بدون طائرات مقاتلة”، فإنّ إسرائيل بوسعها القيام بالشيء نفسه.
إن عُمر مشروع إسرائيل للصواريخ الدقيقة يزيد عن عقد الآن. والصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّة طوّرت وجرّبت العديد من الصواريخ الدقيقة بمدياتٍ ورؤوس حربيّة متنوّعة. حتى وقتنا هذا، وافق الجيش على شراء الصواريخ ذات المدى القصير وبأعدادٍ محدودة. أمّا الصواريخ طويلة المدى، مثل صاروخ “لورا” الذي يبلغ مداه 400 كم، والذي جُرّب مؤخّرا، فإنّه يُباغ بنجاح إلى جيوشٍ أجنبيّة ولكن ليس للجيش الإسرائيليّ.
في مقالٍ نُشر مؤخّرا في مجلّة الجيش، كُشف النقاب عن أنّ الأمر راجعٌ إلى اعتراضات سلاح الجو الذي يرفض تزويد القوّات البريّة بقدرات قصف مستقلّة يفوق مداها 100 كم. إذا كان ما كشف في المقال صحيحا، فإنّ العقبة في طريق إنشاء “قوّة جويّة بدون طائراتٍ مُقاتلة” ليست عقبة تكنولوجيّة أو عمليّاتيّة ولكنّها مرتبطة بشكلٍ أكبر بالصراع حول المظاهر (البرستيج) والميزانيّات داخل الجيش الإسرائيليّ.
إن الحروب حول النفوذ داخل المؤسسة العسكريّة ليست أمرا خاصّا بالجيش الإسرائيليّ فقط. ففي واحدٍ من أكثر الحوادث سيئة الصيت، قاتل سلاح الجو الأمريكيّ بأسنانه وأظافره ضدّ تزويد أسطول غوّاصات البحريّة الأمريكيّة بالصواريخ البالستيّة بالنظر لأنّها ستنافس القاذفات الاستراتيجيّة الخاصّة بسلاح الجو. وقد احتاج “البنتاغون” إلى بضعة سنواتٍ حتى يحلّ هذا الخلاف.
إنّ مسألة إنشاء قوّة قصف صاروخيّ إسرائيليّة لمؤازرة سلاح الجو تمّ نقاشها قبل بضعة أعوام. وبحدود ما نعلمه، فقد رفض الجيش هذا المقترح. من المقرّر أن تقوم الصواريخ الدقيقة ذات المدى القصير التي يتم تزويد الجيش بها الآن بتوفير غطاء مدفعيّ طويل المدى لعمليّات القوّات البريّة ولكن ليس لمؤازرة سلاح الجو للقيام بضربات استراتيجيّة عندما تتعرّض قواعده للتهديد من الصواريخ الدقيقة المُعادية.
إنّ الفكرة الشائعة القائلة بأنّ “الصواريخ لا تكسب الحرب”، والتي كانت على الدوام فكرة مشكوكا فيها أصلا، أصبحت قديمة ومن الواضح أنها خاطئة. الصواريخ الدقيقة الحديثة تمتلك اليوم نفس “اللكمة” التي يُمكن أن تُوجّهها الطائرات المُقاتلة، لكنها أقل هشاشة للتهديدات، نظرا لأنها تعتمد على قواعد جويّة ضخمة وغير متحرّكة ومليئة بالأهداف التي يُمكن قصفها. بإمكان الصواريخ الدقيقة أن تُعطّل البنية التحتيّة المدنيّة والعسكريّة لبلدان بأسرها، ممهدة الطريق لهزيمتها.
واليوم، من المؤكّد أنّ الصواريخ المُوجّهة بدقّة يمكنها كسب الحرب. على إسرائيل ان تقوم بكل ما يمكن فعله ليس لمنع الهزيمة بأسلحة من هذا النوع فقط، بل ولاستخدام ذات الأسلحة لهزيمة أعدائها.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]