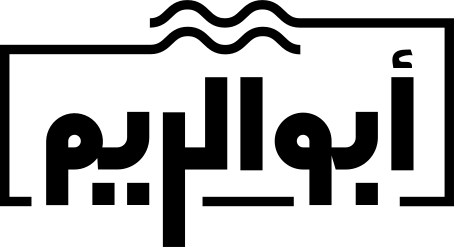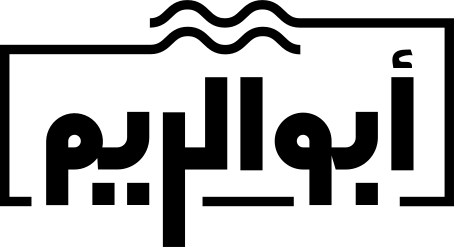[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشر في ملحق “السفير العربي” في 24 آب/أغسطس 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]بدأت الأجهزة الأمنيّة التابعة لحركة “حماس” في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عدداً كبيراً من عناصر المجموعات السلفيّة الجهاديّة الناشطة في قطاع غزّة. الحملة التي تخلّلتها عمليّات مطاردة ومداهمة ونشر حواجز لإلقاء القبض على المطلوبين، تُمثّل فصلاً جديداً من الصراع الذي يدور بين “حماس” والمجموعات السلفيّة منذ 14 آب / أغسطس 2009، حين قُتل ما يزيد عن عشرين شخصاً في اشتباكات مسلّحة بين عناصر كتائب القسّام ومسلّحي جماعة “جند أنصار الله” في أعقاب توجيه أمير الجماعة، الشيخ أبو النور المقدسي، انتقادات لاذعة لحكومة “حماس” ل”عدم تطبيقها للشريعة الإسلاميّة”، وذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها المقدسيّ في مسجد ابن تيميّة برفح بعنوان “الوصيّة الذهبيّة لحكومة إسماعيل هنيّة”.
تعرّضت الحالة السلفيّة في ذلك اليوم إلى ضربة قاسية انتهت بمقتل قادة الجماعة وتشتّتْ واعتقال أنصارها. إلا أنّ تلك الضربة لم تمنعها من النهوض مجدّداً. فقد نجح النشطاء السلفيّون في استجماع قواهم مرّة أخرى، واستنسخوا مجموعاتٍ جديدة باتت تستقطب مع الوقت عدداً أكبر من الأنصار والمتعاطفين، وتستخدم تكتيكات أكثر احترافيّة وذكاءً في التعبئة والتواصل والتخفّي. وقد منحت العودة القويّة للخطاب السلفي الجهادي على مستوى المنطقة، إثر انتكاس انتفاضات “الربيع العربي”، دفعة تعبويّة جديدة للحالة السلفيّة في غزّة، وربطتها بشكلٍ أوثق بالتطوّرات الإقليمية المشتعلة، وأضفت على فاعليّتها ملامح جديدة. وسيُفرض على “حماس” منذ ذلك الوقت مواجهة نمو هذه الظاهرة من خلال اللجوء إلى مزيجٍ متناقض ومتعدّد الأوجه من وسائل الاحتواء والقمع.
فمن جهة، كثّفتْ الحركة الإسلاميّة التي تحكم قطاع غزّة منذ العام 2007 إجراءاتها لضبط المجال الديني من خلال تشديد الهيمنة الحكومية على المساجد لمنع تسلّل “الفكر المتشدّد” إلى منابرها، وأقامت برامج لتأهيل الخطباء والدعاة لضمان اتّساق الخطب الدينية مع ما تراه خطاباً إسلامياً وسطياً. ومن جهة ثانية، سعت الحركة للتواصل مع المشايخ السلفيّين المؤثّرين في غزّة والخارج لحثّهم على إقناع الشباب السلفي المتحمّس لانتهاج سلوكٍ أكثر اعتدالاً.
وبموازاة ذلك، لجأت الحركة إلى أشكالٍ من الاسترضاء للقواعد السلفيّة عبر تسهيل عملها الدعوي وأنشطتها الاحتجاجية أحياناً، أو إلى مجاراتها فكريّاً من خلال تبنّي حملات رسمية لمحاربة “العادات الغربية الدخيلة على المجتمع” وفتح الباب أمام بناء المزيد من المساجد والمعاهد والكليات الدينية، وتسهيل عمل الجمعيات الخيرية والدعوية السلفية المرتبطة بالأوساط الوهابية في الخليج العربي. لكن هذا كلّه لم يمنع في الوقت نفسه من تجريد سيف القمع على السلفيّين الجهاديّين، وتحديداً في المحطّات التي رأت فيها “حماس” أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء.
الجديد في الحملة الأخيرة
على الرغم من أنّ سيف القمع والملاحقة ظلّ يخيّم دوما على أجواء العلاقة بين “حماس” والسلفيين الجهاديين، إلا أن الحملات الأمنية السابقة كانت تنتهي غالباً بإطلاق سراح معظم المعتقلين، والوصول إلى تفاهماتٍ غامضة معهم بوساطات سلفيّة محلية وخارجية، أو ثني جزءٍ منهم عن أفكاره من خلال عقد جلسات مناصحة مع المعتقلين أشرف عليها مشايخ من “حماس”. وقد كانت الحملات السابقة لا تستهدف في أكثر الأحيان سوى العناصر الأكثر فاعليّة منهم والمعروفة جيّداً لأجهزة الأمن.
أما الحملة الأخيرة فقد وسّعت دائرة الاشتباه إلى حدودٍ كبيرة، وطالت أعداداً أكبر من السلفيّين قُدّرت بالمئات، بما فيهم القائد الأبرز المُكنّى بأبي المُحتسب المقدسي، الذي وضعتْ الولايات المُتّحدة اسمه على قوائم المطلوبين بتُهم الإرهاب في العام 2015، والذي كانت أجهزة الأمن الحمساويّة تُطارده منذ عدّة سنوات. وقد عكس المدى الزمنيّ الطويل للحملة واتّساع نطاقها وطبيعة الإجراءات التي اتّخذتْ بحقّ المعتقلين، بما فيها عرض عددٍ منهم على المحاكم العسكريّة بتهمة “مناهضة النظام”، وإغلاق سبل التفاهم التقليديّة معهم، منسوب التوتّر الجديد بين الطرفين، والإدراك المتنامي في أوساط “حماس” للخطورة التي باتت تمثّلها نشاطيّة هذه العناصر على القبضة الأمنيّة المشدّدة للحركة في القطاع، ولتأثيراتها المحتملة على الجسم التنظيمي الحمساوي نفسه، خاصة وأن المكوّن الرئيسي في الحالة السلفيّة الجهاديّة ينحدر بالأساس من عناصر مُنشقّية عن الحركة.
وإذا كانت التوتّرات التي وقعت بين “حماس” والسلفيّين الجهاديّين قد بدت في السابق جزءاً من صراعٍ محلي محدود بين الطرفين، على خلفيّة قيام العناصر السلفية بخرق تفاهمات التهدئة مع إسرائيل عبر إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيليّة المتاخمة لحدود قطاع غزة تارة، أو القيام باستهداف بعض المصالح الأمنية والمؤسسات الأجنبية وتبني خطاب التكفير تارة أخرى، فإنّ الحملة الأخيرة كشفت كيف أنّ هذا الصراع بدأ يتّخذ بشكلٍ أوضح بعداً عابراً للحدود.
وتبرز هنا بشكلٍ خاص ظاهرة الانخراط المتزايد للسلفيين الجهاديين في غزّة في الهجمات التي يشنّها تنظيم “داعش” على الجيش المصري من خلال فرعه المعروف باسم “ولاية سيناء”. فقد قُتل شابٌ من غزّة أثناء مشاركته في الهجوم الذي نفّذه التنظيم ضد “كمين الغاز” بالقرب من مدينة العريش في تشرين ثاني / نوفمبر الماضي، وأودى بحياة 13 جندياً مصرياً. وخلال الشهور اللاحقة، قُتل ما لا يقل عن عشرة شبان غزّيين خلال مشاركتهم في المواجهات التي تخوضها الولاية مع الجيش المصري في المنطقة.
كيف نفهم هجرة الجهاديّين؟
مع أن انتقال العناصر السلفيّة عبر خطّ الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية وصحراء سيناء كان ملمحاً حاضراً على الدوام في نشاط المجموعات السلفية الجهادية منذ أواخر العقد الأول من الألفيّة الجديدة، حفّزته بالإضافة للعوامل الأيديولوجية، العلاقات التاريخية والتجارية والثقافية والعائلية التقليدية القائمة بين المنطقتين، إلا أن دوافع هذا الانتقال تبدو اليوم بالذات أكثر تعقيداً، إذ تنطوي على مزيجٍ مُركّب ومتفاعل من التأثيرات المحليّة والإقليميّة والتي تتضافر في بوتقة واحدة مع الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزّة ونمط إدارة “حماس” اليومي لها، لتُضفي أبعاد جديدة على هذه الظاهرة. ويمكن في هذا الإطار رصدُ أربعة جوانب من هذا المزيج المُركّب.
أولاً: إنّ “ولاية سيناء” ليست المحطّة الوحيدة في رحلة الجهاديّين الفلسطينيّين إلى خارج غزّة. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، هاجر شبابٌ سلفي من غزّة إلى كلّ “الساحات الجهادية” المشتعلة في سوريا والعراق وليبيا. وعلى الرغم من عدم توافر إحصائية دقيقة أو تقريبية عن أعدادهم، فإن المؤكّد أن بضعة عشراتٍ منهم قد قضوا خلال قتالهم في تلك الساحات. وبهذا المعنى، فإن الهجرة إلى سيناء تندرج في جانب منها في سياق ظاهرة الهجرة الأوسع التي تعيشها أوساط المقاتلين الجهاديين في المنطقة منذ العام 2011. وهي تُعيد تذكيرنا بواحدة من الخاصيات التاريخية البارزة للحركة الجهادية منذ انطلاقتها في أفغانستان أوائل ثمانينات القرن الماضي، أي في كونها حركة عابرة للحدود (أو “حركة منفى دائم” إذا صحّ التعبير)، وأن جزءاً من فاعليّتها ينبثق من أنّها لا تستخدم جواز سفرٍ رسمي، وأنّ أعضاءها متماهون مع حقيقة كونهم على موعدٍ دائم مع هجرة قريبة إلى ساحة جهادية قد تلوح في الأفق.
لكن هذا لا يمنع التشديد على أن حسابات الطبيعة الجغرافية التي وضعت سيناء على الحدّ الجنوبي لقطاع غزّة قد جعلتها منطقة جذابة في أعين الجهاديين الذين يعزمون على الهجرة مؤخراً، خاصة حين نأخذ بعين الاعتبار قربها الجغرافي وإمكانية الانتقال إليها من غزة عبر الأنفاق من جانب، والانكفاء الحاصل في نفوذ التنظيمات الجهادية في الساحات الأخرى من جانب آخر.
ثانياً: إذا كان من الممكن إدراج الهجرة إلى سيناء في سياق ظاهرة الهجرة الجهاديّة الأوسع في المنطقة العربيّة، فمن الممكن أيضاً النظر إليها بوصفها عرَضاً من أعراض صيرورة سياسية بدأت باحتلال العراق عام 2003 ووصلت ذروتها في العام 2011 مع اندلاع الانتفاضات العربية. وعنوان هذه الصيرورة الرئيسي تفكّك “العالم القديم” في المنطقة، وفي القلب منه التنظيم الكبير للأخوان المسلمين.
لقد بدأت الدعاوى السلفية الجهادية في غزّة ــ والتي تأثّرت بشكلٍ ما بالصعود السلفي بعد احتلال العراق ــ باكتساب وهجها وتماسكها مع مشاركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثمّ مع سيطرتها المُطلقة على غزّة في العام التالي.
وقد خلّفت تجربة “حماس” في الحكم، بتنكّرها لتطبيق الشريعة وامتثالها لمنظومة “القوانين الوضعيّة”، ندوباً عميقة على جزء كبير من أنصارها الذين جرت تعبئتهم على مدار سنواتٍ طويلة بأحلام اليوتوبيا الإسلاميّة الموعودة. ثمّ جاءت الانتفاضات العربية ووضعت أمام الأخوان المسلمين وتصوّراتهم عن العالم تحديّات لا قِبَل لهم بها، بعد أن أخرجت جسمهم التنظيمي الهائل إلى سطح المجال العربي العام لتتقاذفه أنواء العاصفة الجديدة. وكانت خيبة الأمل المصاحبة لتجربتهم في تونس، ثمّ النهاية المأساوية لحكمهم القصير في مصر، قد منحت الاتجاهات السلفية الجهادية أرضيّة خصبة للتطور، خاصة وأن القمع والبطش الدمويين الذين واجهت بهما الأنظمة العسكرية حركة الانتفاضة، قد تركا خطاب الأخوان عن الانخراط في “السياسة الحديثة” و”اللعبة الديمقراطية” خالياً من المعنى في عيون قطاعٍ متزايد من أعضائهم الذين باتوا يرون بأنّ الصراع الذي خلقته الانتفاضات في المنطقة هو صراع وحوش ضارية لا يمكن حسمه إلا بالقوّة العارية.
وعلى هذا الأساس، يمكن النظر إلى هجرة الجهاديين من غزة في جانبٍ أساسي منها كتعبير عن وصول الإحباط والخذلان من التجربة الأخوانيّة إلى حدّه الأخير، بحيث لا يعود مُمكناً معه سوى البحث عن الانعتاق الكامل. فالهجرة هنا هي المُرادف الفيزيائي للتحرّر من “العالم القديم”، وهي مثل كلّ تجربة تطهرية، عملية قاسية، لأنّ التحرّر من عالم الأفكار والمُثل يقترن فيها مع تحرّر موازٍ من مكان النشأة والعيش، بكلّ حمولته العاطفية المنغرسة في الوجدان.
ثالثاً: تعكس هجرة الشبان الجهاديين من غزة إلى سيناء جانباً من ارتفاع منسوب القمع الذي باتت تُوقِعه أجهزة “حماس” عليهم خلال حملات الاعتقال في السنتين الأخيرتين.
وتقول المصادر السلفية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كمنبرٍ إعلامي لها، أن المعتقلين السلفيين يتعرضون للشبْح لساعاتٍ متواصلة، وأنهم يُوضعون في زنازين انفرادية لأوقاتٍ طويلة ويُحرَمون علاوة على ذلك من الكثير من حقوقهم كسجناء. ومع أنّه يصعب التحقّق من هذه الادعاءات بشكلٍ دقيق، بالنظر للتكتيم الشديد الذي تفرضه “حماس” على هذه القضية، وبسبب الرفض المتكرّر من قبل أجهزتها الأمنيّة للطلبات المُقدّمة من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان لمعاينة أوضاع المعتقلين، إلا أن هذه الادعاءات نالت شيئاً من المصداقية مع خروج شهادات متفرقة لأهالي المعتقلين، تتحدّث عن قيام بعضهم بالإضراب عن الطعام مطلع آذار/ مارس الماضي احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وعلى عدم توجيه تُهمٍ محدّدة لهم.
ويُعزِّز افتراض أن القمع يلعب دوراً مُؤثّراً في خلق دوافع الهجرة، حقيقة أن غالبية الشبان المهاجرين إلى “ولاية سيناء” في الآونة الأخيرة يجمعون بين كونهم معتقلون سابقون في سجون الأجهزة الأمنية، عاشوا تجربة التعذيب وسوء المعاملة، أو مُطارَدون نجحوا في الإفلات من قبضة الأمن خلال الحملة الأخيرة.
ويتضافُ هذا القمع مع مشاعر قلّة الحيلة التي يعيشها السلفيون الجهاديون نتيجة تواضع إمكاناتهم التسليحية وغياب قدرتهم على الدخول في صدامٍ صريح مع “حماس” أو تحدّي سلطتها بشكلٍ سافر، ليُعمّق لديهم دوافع الانتقال إلى مكانٍ آخر تتحقّق فيه الذات الجهاديّة على نحو أكثر إشراقاً.
رابعاً: لا ينبغي استبعاد فرضيّة أن تكون هجرة الجهاديين من غزة إلى “ولاية سيناء” مدفوعة في جانبٍ منها باستراتيجيّة واعية لدى تنظيم “داعش” في قتاله المتواصل مع الجيش المصريّ. فعلى الرغم من أنّ التنظيم ظلّ قادراً على توجيه ضرباتٍ دامية شبه يومية لضباط وجنود الجيش المصري في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الاستخدام الكثيف لسلاح الجو والمدفعية من قِبل الجيش خلال مطارداته لعناصر التنظيم، والزجّ بعددٍ كبيرٍ من ضبّاطه وجنوده في ميدان القتال، أدّى إلى ضغوطٍ متنامية على التنظيم خلال السنة الأخيرة مع تزايد الخسائر البشرية في صفوفه.
وتبرز أهميّة قطاع غزّة عند هذا المفصل في كونه يُمثّل خزاناً بشرياً قريباً يُمكن الاعتماد عليه لتجنيد المزيد من المقاتلين وتعويض هذه الخسائر والإبقاء على الحرب مشتعلة لإنهاك الجيش المصري، وخاصة أن العزلة الجغرافية لسيناء عن وادي النيل وكثافتها السكانيّة المحدودة ربما تضعان قيوداً جدية على عملية التجنيد من بر مصر في المدى الطويل. وفي هذا السياق، يمتلك الخزّان البشري الذي تُمثّله غزة مزية فريدة كونه يرفد التنظيم بعناصر جاهزة للقتال فوراً، لأنّ العناصر السلفية القادمة من غزة لا تحتاج في الغالب إلى تأهيل أو تدريب عسكري مطوّل، لامتلاكها لهذه المهارات، ناهيك عن أن هذه العناصر قد تجلب معها خبراتٍ عسكرية جديدة ومطلوبة في ميدان القتال.
وفي واقع الأمر، يصعب افتراض نجاح مجموعاتٍ من الشبان السلفييّن في الانتقال من خلال الأنفاق إلى سيناء بدون تصوّر وجود نوعٍ من الترتيبات اللوجستية بين عناصر التنظيم على طرفي الحدود لتسهيل هذه العملية.
مشكلة تلدُ مشكلات
يُثير تنامي حالة السلفيّة الجهاديّة في غزة إشكاليّاتٍ على أكثر من مستوى بالنسبة لحركة “حماس”.
تُمثّل السلفيّة الجهاديّة على المستوى الأيديولوجي “معارضة من الداخل”، أي من المضمار الديني ذاته الذي تنشط فيه “حماس” وتعتمد أدبيّاتها وشعاراتها وتعبئتها عليه، وهو عامل إغراءٍ للعديد من عناصر الحركة للانضمام لها أو التعاطف معها، خاصّة وأنّ خطاب المجموعات السلفيّة يُركّز بشكلٍ حثيث على خيانة “حماس” لمبادئها الإسلاميّة وتقرّبها من الشيعة ومهادنتها لإسرائيل.
وتستفيد ديناميّة “المعارضة من الداخل” هذه من حقيقة أن خطاب قطاعٍ مُعتبر من كوادر “حماس” ومشايخها لا يختلف في جوهره عن ذلك الذي يعتنقه السلفيّون. ويجد الخطاب السلفيّ إجمالا بيئة خصبة في حلقات المساجد التي تُديرها “حماس” وفي المعاهد والجامعات التي تُشرف عليها. وفي هذه الأجواء من الأسلمة الفائقة، كثيراً ما تغدو الحدود الفاصلة بين الحمساويّين والسلفيّين غائمة إلى حدودٍ بعيدة.
وقد كشفت تجربة حكم “حماس” لغزة خلال عشر سنوات، باقترانها بأشكال الإقصاء الاجتماعي والممارسات الفاسدة والسياسات الضريبيّة المُجْحفة وظهور مجموعاتٍ جديدة من منتفعي السلطة ومحاسيبها. الهوّة الكبيرة بين مُثل العدل والمبدئيّة والتقشّف التي كانت تدعو لها الحركة في السابق، وبين واقع ممارساتها الحقيقيّة عندما أصبحت سلطة على الأرض، تُعطي التعبئة السلفيّة مساحة لاستقطاب عناصر “حماس” على أرضيّة المظلوميّة والخذلان الاجتماعيّين، ولكن بعد صياغة هذه المظالم في مفردات دينيّة وتصوير الانتماء للسلفية الجهادية لا كتوجه عقائدي سليم فحسب، بل وكأسلوب حياة قائم على الزهد وترك متاع الدنيا الزائل.
وعلى المستوى التنظيمي، يُمثّل السلفيون الجهاديون حالة سائلة بدون عناوين أو أعلام واضحة أو قيادات معروفة على نطاقٍ واسع أو هرمٍ تنظيميّ مُتسلسل، الأمر الذي يجعل من عملية ضبطهم والسيطرة عليهم بشكلٍ كامل مسألة عسيرة بالمعنيين الأمني والفكري. ويُعزّز من هذا التحدّي ميل المجموعات السلفية الجهادية إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال الحديثة لنشر موادها التعبوية، وللحفاظ على نوعٍ من التواصل المعنوي والملموس بين أعضاء الشبكات الجهاديّة في مناطق جغرافية مختلفة وربطهم ببعضهم البعض. وتلعب وسائط التكنولوجيا الحديثة دورا مؤثراً في عمليات الاستقطاب لاعتمادها على البعد البصري كما في أفلام الفيديو القصيرة والخطب المسجلة والرسائل القصيرة ووصايا الشهداء، وهو ما يعني أن تجنيد المزيد من الشبان لصالح الحالة السلفية قد لا يقوم دائماً على عملية تأهيلٍ ديني طويلة أو برنامج مُعمّق للتفقه في علوم الشريعة، بقدر ما يستند إلى حالة من الإبهار البصري واستثارة العواطف الجيّاشة تجاه مشروع يوتوبيّ قائم على أواصر المحبة والترابط الأخوي الإسلامي، أو دغدغة مشاعر البطولة والشجاعة لدى اليافعين.
وعلاوة على ذلك، تفسح الحالة السائلة التي يُمثّلها السلفيون المجال للمبادرات الفرديّة لتأخذ دور مميزاً في عمليات التعبئة والاستقطاب وتأسيس المجموعات الجديدة. فالسلفيون الجهاديون، وبسبب الطبيعة التاريخيّة الخاصة لحركتهم، ليست لديهم تقاليد مؤسسية أو تنظيمية محدّدة، لكنّ حركتهم تركت في المقابل إرثاً كبيراً من التجارب التاريخية والأدبيات الفكرية والعقائدية والعسكرية والسرديات الدرامية والصور النوستالجية التي يمكن الاعتماد عليها من قِبل أعضاء متحمسين كمادةٍ خام لرفع الراية من جديد بعد كل مرّة تتعرّض فيه للتنكيس.
وقد عرف المشهد السلفي الجهادي في غزة خلال العقد الأخير هذا النوع من المبادرات، إذ ظهر على الدوام رجال سلفيون مخضرمون يمتلكون ناصية العلم الديني ومهارات القيادة ليحاولوا بعث “الدعوة” من جديد وليسعوا إلى لمّ شتات المجموعات السلفية المختلفة وتوحيدها واستقطاب المزيد من الأنصار لها. ومع أن بعض هؤلاء قُتل على يد “حماس” مثل أبو عبد الله المهاجر مؤسس جماعة “جند أنصار الله”، أو على يد الإسرائيليين مثل أبو الوليد المقدسي مؤسس جماعة “التوحيد والجهاد”، إلا أن سيرتهم ومآثرتهم ظلّت مصدراً للإلهام والتأثير في الطيف المتنوع للأجيال السلفيّة التي جاءت من بعدهم.
وعلى المستوى السياسي، يلقي تواتر ظهور عناصر سلفية فلسطينيّة في سيناء بظلاله على العلاقة بين “حماس” ومصر ومحاولات التقارب بينهما. فخلال السنوات الماضية، دأبت الأجهزة الأمنية المصرية ومعها أجهزة الإعلام على تحميل “حماس” المسئوليّة عن توفير المأوى والعلاج والتدريب والتسليح للعناصر السلفية التي تُهاجم قوات الجيش المصري في سيناء. وعلى الرغم من أن “حماس” كانت تُواجه هذه الادّعاءات بالنفي وبالتشديد الدائم على حرصها على الأمن القومي المصري، إلا أن ربط مصر تقديم تسهيلاتٍ إنسانية لغزة المُحاصرة بمقابلٍ هو زيادة التعاون الأمني من قِبل “حماس” في ملف السلفيين الجهاديين، بات يضع على الأخيرة ضغوطاً أكبر لاتخاذ إجراءاتٍ أكثر عملية وحسماً إزاء هذا الملف.
وفي هذا السياق، برز تزامنٌ واضح بين اشتداد الحملة الحمساوية على العناصر السلفية وتسارع إجراءات التعاون الأمني بين القاهرة و”حماس”. فاستقبلت القاهرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في كانون ثاني / يناير الماضي وفداً من الأجهزة الأمنية لـ “حماس” لتناقش معه سبل تأمين الحدود بشكلٍ أفضل. ولاحقاً، في تطور لافت، تمخّضت لقاءات وفد “حماس” والمسئولين الأمنيين المصرييّن في أوائل حزيران/ يونيو عن اتّفاقٍ على إقامة منطقة عازلة بعمق 100 متر على طول الجانب الفلسطيني من الحدود مع سيناء. وما إن وُضعت هذه التفاهمات حيّز التنفيذ، حتى قام تنظيم “داعش” بشنّ هجومٍ كبير على كمين “البرث” في سيناء موقعاً أكثر من عشرين قتيلاً في صفوف الجيش المصري، وخرجت التقارير الصحافية بعد ذلك لتتحدث عن مقتل بضعة شبان غزيين أثناء الهجوم. كشف الحادث عن مستوى كبيرٍ من التنسيق بين السلفيين الجهاديين على طرفي الحدود، وكان بمثابة رسالة لا تُخطئها العين لقدرتهم على التأثير سلباً على أي تفاهماتٍ يتمّ التوصل إليها بين “حماس” ومصر.
ويكمن مأزق “حماس” في هذا المفصل في حقيقة أنّ سعيها للتقارب مع مصر والتعاون معها أمنيّا من أجل تخفيف الأعباء المعيشيّة التي يرزح قطاع غزّة تحتها، تُقيّده رغبتها بعدم الظهور بمظهر “طاغوت” صغير يعمل لصالح “طاغوت” أكبر، الأمر الذي قد يُعطي الدعاية السلفيّة المزيد من الجاذبيّة والصدقيّة. كما أنّ تطبيعا أمنيّا على نطاق واسع قد يُثير في ذات الوقت استنكار قواعد “حماس” التي تكنّ مشاعر شديدة السلبية تجاه النظام المصري، وهي ما زالت تستحضر في ذاكرتها الصور المأساوية لمجزرة ميدان رابعة العدوية التي تحوّلت إلى كربلاء الأخوان المسلمين الحديثة.
خاتمة
منذ أيام، كان شاب فلسطيني من قطاع غزة، يبلغ التاسعة عشرة من عمره، يحثّ الخطى للهجرة إلى سيناء للالتحاق بتنظيم “داعش”. وعندما أوقفته دورية تابعة لـ”حماس” على الحدود لتمنعه من إكمال رحلته، قام الشاب بتفجير نفسه بحزام ناسف في عناصر الدورية ليُوقعْهم بين قتيلٍ وجريح. يُقدّم الحادث صورة حيّة لجانبٍ من الصراع المتواصل بين “حماس” والسلفيين الجهاديين ولطبيعة المآلات التي قد يصل إليها مستقبلاً.
كما يكشف علاوة على ذلك كيف تضافرت عوامل الأسلمة الفائقة والتفاوتات الاجتماعيّة الكبيرة وعسكرة المجتمع مع الزلازل السياسيّة التي مرّت فيها المنطقة خلال السنوات الماضية لتُنتج جيلاً جديداً من السلفيين المتطرفين الذين يختزنون طاقة هائلة من العنف. وإذا كان وجود ساحاتٍ جهادية مفتوحة في المنطقة العربية قد أتاح جزئياً تصريف فائض العنف هذا خارج حدود قطاع غزة في أحيانٍ كثيرة، فإن تآكل نفوذ الجماعات الجهادية في تلك الساحات وصعوبة الوصول إليها من قِبل الجهاديين الغزيين بسبب ظروف الحصار المُشدّد، يعني بداهة أن احتمالية تحوّل فائض العنف إلى الداخل باتت أكبر، مُتغذية على الظروف المعيشية البائسة وأجواء الإحباط القاتمة السائدة في القطاع.
وتأتي تجربة القمع والسجون التي يُعايشها السلفيون لتصقل لديهم سرديات المظلومية ولتحفّز فيهم دوافع الانتقام إلى أقصى حد ولتخلق بينهم إحساساً عميقاً بالتضامن والتحدي والإصرار على مواصلة طريقهم. وفي ظلّ عجز “حماس” عن السيطرة على نشاطيتهم، وتُعرّض جسمها التنظيمي ذاته لعوامل التعرية بفعل الدعاية السلفية، فإنّ المخاوف تبقى قائمة من اليوم الذي تتعرّض فيه سلطة الحركة للانهيار أو الضعف بسبب الفوضى أو الحرب، إذ ستكون الظروف حينها سانحة لانفلات وحش العنف من عقاله وسيدفع الجميع الثمن الباهظ لسنوات الإنكار والتجاهل.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]