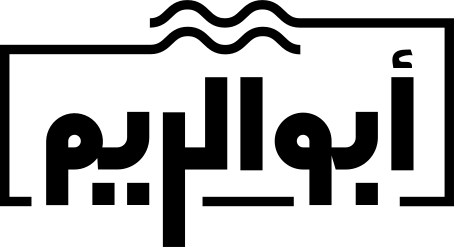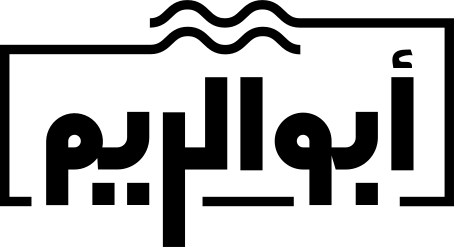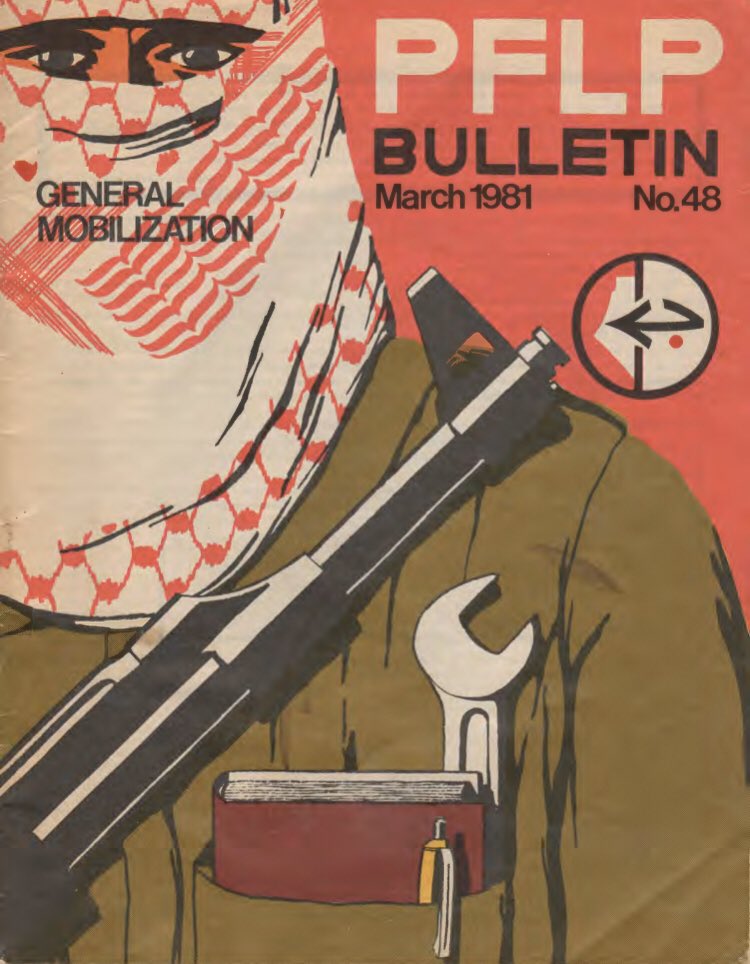[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشرت في جريدة “الأخبار” اللبنانية في 22 آب/أغسطس 2013[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]بإمكان مادّة صحافيّة («الحياة»، 5 آب 2013، «الحجاب يتسلل إلى رؤوس «الرفيقات» الفلسطينيات ولا يفسد للتحرر قضية») رديئة أن تمنح الفرصة لطرح سؤال جيّد. والحقل السياسي الفلسطيني يحتاج، بحق، إلى طرح بعض الأسئلة لمناقشة مسلّماته الكثيرة. أحد الأسئلة التي حاولت أن أطرحها دائما تخصّ اليسار الفلسطيني بدرجة أولى. هل يمثّل اليسار كتلة مُتمايزة على صعيد الأفكار والقيم السياسيّة والقواعد الاجتماعيّة في الحقل السياسي الفلسطيني؟ هناك صورة نمطيّة متداولة في الثقافة السياسيّة الفلسطينيّة تُحيل دوماً إلى تمايز اليسار ككتلة مُنفتحة بنحو أكبر على القيم العلمانيّة وتأويلات العلاقة بين الدين والسياسة وأنماط التديّن. وتخترق صورة أخرى قطاعاً أوسع لدى الجمهور لتحيل إلى تمايز المنضوين في اليسار الفلسطيني عن مُحيطهم بوصفهم أناساً يملكون نصيباً أكبر من الثقافة والاطّلاع. أجادل هُنا بأنّ المرء يحتاج الى كثير من التحفّظ ليقبل بهذه الصور.
ما دمنا نتحدّث عن اليسار، فلماذا لا نحاول قراءة الأمر من خلال منظور اليسار الفكري ذاته، الماركسيّة. في تصوّر كلاسيكي مبسّط، تقول الماركسيّة إنّ اليسار يمثّل بالأصل مصالح الطبقات الفقيرة ويناضل من أجلها، وإن موقعه هذا يحتّم عليه، بالضرورة، أن يتبنى الأفكار الأكثر تقدميّة لأن تحرّر الطبقات الفقيرة مرهون بها. لقد دخل اليسار الفلسطيني إلى ساحة العمل الفلسطيني من بوابّة الأفكار القوميّة الصاعدة في الخمسينيّات والستينيّات بالأساس، لكنّه سرعان ما تشرّب الأفكار الماركسيّة تحت وطأة تأثير صعود حركات التحرّر الوطني والأيديولوجيا الاشتراكيّة وموقع الاتحّاد السوفياتي في العالم، بالإضافة إلى الإلهام التي أحدثته ثورات الطلاب في تلك الحقبة، وبالأخص منها ثورة طلاب فرنسا في عام 1968. تطرح الماركسيّة هُنا سؤالها الآخر: مَن الطبقات الاجتماعيّة التي مثّلها اليسار إذاً؟
يواجه هذا المنظور درباً شائكاً. أفضت النكبة الفلسطينيّة، في الواقع، إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، الذي هو مجتمع فلاحين كبير بالأساس، وحوّلته إلى «شتات» متناثر يعيش ظروفاً بائسة في المنافي. أصبح لدينا «مجتمعات» فلسطينيّة بدلاً من المجتمع الواحد الذي كان قائماً في فلسطين التاريخيّة. وقد خضع كلّ مُجتمع فلسطيني لشروط اندماجه الخاصّة في بلد المنفى، وأصبح الفلسطينيّون على اختلاف مهنهم ومستوياتهم الاجتماعيّة جزءاً من الاقتصاد السياسي للبلدان التي حلّوا فيها كلاجئين. وقد تحوّلت كتلة اللاجئين الفلسطينيّين في الشتات إلى خزّان بشري للفصائل الفلسطينيّة المُقاتلة على اختلاف أفكارها. لقد نهل اليسار الفلسطيني من الخزّان نفسه الذي نهلت منه فتح والفصائل الأخرى إذاً، فهو بالتالي لم يكن يعبّر عن طبقة اجتماعيّة بعينها، رغم أن السرديّة اليساريّة كانت تُشدّد بشكل دائم على تمثيلها لـ«الفقراء والكادحين».
يبدو استخدام المنظور ذاته أكثر صعوبة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة لأنّ المجتمع هناك خضع لتحوّلات مُختلفة. فبسبب سياسة إسرائيل المُصمّمة لإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالكامل ببنية الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام 1967، تحوّل جزء معتبر من كتلة اللاجئين الفلسطينيّين إلى قوّة عمل كبيرة ورئيسيّة في الاقتصاد الإسرائيلي. ولأنّ الانتماء الطبقي يتحدّد بشروط الإنتاج أصلاً، فإنّ تموضع هذه الكتلة الطبقي وموقع اليسار منها يبقى مستعصياً على الفهم. فالعمّال الفلسطينيّون كانوا ينتجون ضمن آليات وشروط السوق الإسرائيليّة. أيّ أنّهم، في واقع الأمر، كانوا جزءاً من الدورة الإنتاجيّة الإسرائيليّة، وهو ما جعل محاولة رسم حدود وترسيمات البنية الاجتماعيّة الفلسطينيّة وتحديد الطبقات فيها مسألة شبه مستحيلة.
مع تأسيس السلطة الفلسطينيّة، أصيبت البنية الاجتماعيّة الفلسطينيّة بمزيدٍ من التشوّه. حوّل مشروع السلطة قطاعاً واسعاً من الجمهور الفلسطيني إلى بيروقراطيّة منتفعة من مشروع السلطة، أمّا قوّة العمّال الفلسطينيّين الكبيرة، فقد أحيلت إلى التقاعد بين ليلة وضحاها بعد قرار إسرائيلي نهائي للاستغناء عنها لصالح عمالة أجنبيّة مُستوردة. ومع توسّع سياسات الريع المُتمثّلة في اعتماد السلطة والفصائل على المساعدة الخارجيّة لحشد الأنصار وضمان النفوذ، فإن خطوط الفصل الاجتماعي – فقراء/ أغنياء، كادحين/ بورجوازية وغيرها من التصنيفات – أصبحت أكثر ضبابيّة واستعصاءً على التحديد. وقد أفرز تعمّق اعتماد الفلسطينيّين على الريع الخارجي ما يُمكن تسميته بـ «الهشاشة الوجوديّة» للبنية الاجتماعيّة الفلسطينيّة. فيكفي أن يُتّخذ قرار واحد في عاصمة غربيّة بعيدة يقضي بوقف المال عن السلطة الفلسطينيّة حتّى تتوقف العجلة الماليّة عن الدوران، وأن يهبط آلاف الفلسطينيّين من درجات السلم الاجتماعي ليتحوّلوا إلى كتلة مهولة من المُتعطّلين.
يعمل اليسار الفلسطيني في هذه البيئة، وهو بالتالي لا يتمتّع بقاعدة اجتماعيّة مُتمايزة يعبّر عن مصالحها بشكل مُحدّد. ويمثّل الإفراط اليساري في التأكيد على تمثيله للفقراء والكادحين مُجرّد فكرة رومانسيّة منبتّة الصلة بالواقع. فبالإضافة إلى انحسار القواعد الاجتماعيّة لليسار، بغضّ النظر عن طبيعتها، لا تترك نتائج الانتخابات الفلسطينيّة على أيّ مستوى هامشاً للتشكّك بأن «فقراء» فلسطين ليسوا مع اليسار أصلاً.
أمامنا هذه البنية الطبقيّة المشوّهة التي تجعل مهمّة اليسار عسيرة، لكن أمامنا، على الجانب الآخر، ذلك الكسل اليساري المتأصّل والافتقاد الكامل للحسّ النقدي في محاولة تقديم فهمٍ أفضل للواقع والانطلاق منه لبناء سياسة وحركة اجتماعيّة مُتمايزة في الواقع الفلسطيني. وهكذا، ففيما يُكرّر اليسار إنتاج المقولات ذاتها عن الفقراء والكادحين والمسحوقين، بدون نقد جدّي لهذه المقولات وتحديد مدى مُطابقتها للواقع، يذهب كلّ «فقراء» فلسطين وكادحيها للتصويت لفتح وحماس في أيّ انتخابات حتى إشعار آخر.
قيم اليسار، الإسلامويّة والسياسة
إذا كانت قواعد اليسار غير مُتمايزة بالمعنى الاجتماعي، فهل هي حقّاً مُتمايزة على صعيد الأفكار التي تتبنّاها؟ تستلزم الإجابة عن هذا السؤال الفصل بين اليسار كبرنامج، واليسار كتنظيم وجمهور يُمارس السياسة ويتبنّى قناعات بعينها. يُمكن القول بأريحيّة أنّ برامج اليسار الفلسطيني النظريّة لا تفارق الخطّ العام للإرث الفكري اليساري في تشديده على قيم تحرّر المرأة وضرورة الفصل بين الدين والسياسة وتأكيد طابع المواطنة في التعامل مع الفاعلين في السياسة بحيث تكون انتماءاتهم العرقيّة أو الدينيّة حياديّة في حقل العمل العام. لكنّني سأتجرّأ على القول، إنّه في الحالة الفلسطينيّة، وحين ننظر للمشهد من تحت، أي من وجهة نظر جمهور اليسار، فإنّ الفجوة بين عالم المُثل اليساريّة وقيمه من جهة، وقناعات جمهوره الأصيلة من جهة أخرى تبدو متوسّعة باطّراد، وتحديداً في العقدين الأخيرين.
إلى ماذا يُمكن أن نعزو هذه الظاهرة التي يفترق فيها جمهور اليسار عن قيم أحزابه؟ بالإضافة إلى تراجع موقع اليسار وانحسار الأفكار اليساريّة عبر العالم، والذي أسهم في ارتداد كثيرين، يُمكن أن نعزو الظاهرة لأسباب مُتّصلة بطبيعة السياسة الفلسطينيّة ذاتها. ليس هناك سياسة فلسطينيّة حقيقيّة. فمنذ أوسلو، تدور عجلة السياسة الفلسطينيّة حول عمليّة مُركّزة تستهدف دفع أكبر قطاع من القوى للتسليم بالوقائع التي فرضتها اتّفاقيّة السلام. وقد أعطى استدخالُ حماس إلى هذه التجربة دليلاً موثّقاً على كيف تتورّط حركة مقاومة في مأزق السلطة المنقوصة لتتطابق في النهاية مع أصحاب مشروع السلطة الأصليّين. هكذا ضُربت السياسة الفلسطينيّة وأُفرغت من مضمونها مع تسليم فاعليها بمنطقها الحاكم وقبولهم عدم تجاوزه. على هذا الأساس، تحوّلت هذه السياسة في السنوات الأخيرة إلى «حفلة» علاقات عامّة مملّة يُكرّر فيها فاعلوها المختلفون المقولات السياسيّة نفسها، وبعضها أصلاً غير متُصل بالواقع.
عندما تنحدر السياسة لتتحوّل إلى إطار للعلاقات العامّة، تُصبح فكرة الحشد فكرة مقدّسة لأنّها الطريقة الوحيدة لدى الفاعلين السياسيّين للإيحاء بقدرتهم على ممارسة السياسة. يتكشّف هذا الأمر بشكل بالغ الوضوح في الميل المتأصّل لدى الفصائل الفلسطينيّة للاستثمار الهائل في أدوات الحشد الجماهيري. ويكفي أن يُطلّ المرء على الفاعليّة التي تدبُّ في أوصال الفصائل الفلسطينيّة في «موسم المهرجانات» الشتوي وحجم الأموال التي تضخّ لإثبات القدرة على الحشد، حتى يقترب من الاقتناع بأن السياسة الفلسطينيّة تحوّلت إلى كرنفال شعبي وأنّ أرقام الحشود التي تنزل إلى الشارع غير مؤثّرة في مجمل القضايا التي تُحشد من أجلها.
لم يستطع اليسار أن يتمايز عن هذه الحالة، وانخرط في المنطق الذي يحكم الأشياء في الحالة الفلسطينيّة. وعبر سعيه الدؤوب، هو الآخر، لتعظيم حشده وإثبات أهليّته في اللعبة، غيّب أيّ معايير مُحتملة لعمليّة تنظيم جمهوره الخاص. وقد فتح غياب هذه المعايير الباب لاعتماد اليسار على قواعد اجتماعيّة تفترق في أفكارها تماماً عن أفكار اليسار إلى الحد الذي تُطابق فيه القواعد الاجتماعيّة لفصائل أخرى في الأفكار والقناعات. لم يعدُ الانتماء إلى اليسار أو حتّى لغالبيّة الفصائل الأخرى دليلاً على خلفيّة فكرية أو موقفٍ اجتماعي ما. وبتعطّل السياسة، غابت فكرة المشاركة العامّة بالمعنى الطوعي مع اعتماد الفصائل الفلسطينيّة على أنماط الحشد العائلي والحشد القائم على التركيز على صورة رومانسيّة عن الماضي -تبدو واضحة لدى اليسار أكثر من غيره لأسباب معروفة- فضلاً عن الحشد الذي يقف وراءه المال السياسي.
تُطرح إشكاليّة تديّن قطاعٍ مُتوسّعٍ من قواعد اليسار الجماهيريّة واعتناقها لأفكارٍ مُحافظة كواحدة من الإشكاليّات الأساسيّة في تعريف موقع اليسار كحالة مُتمايزة في فلسطين في العقدين الأخيرين. لكنّ هذه الإشكاليّة تبدو أكثر استعصاءً حين يُنظر إليها من زاوية الاستعداد العملي لليسار للإجابة عنها. صحيح أنّ الموجة الإسلامويّة قد ضربت فلسطين مع صعود الإسلام السياسي في المنطقة كلّها في نهاية السبعينيات، وأن قطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني قد تأثّر بها، إلا أن اليسار كان قاصراً عن اتّخاذ موقف كامل وحدّي تجاهها. لقد حدث ما يُشبه التواطؤ الضمني بين اليسار -ونخبته على وجه الخصوص- وجماهيره، تمّ على أساسه بناء صيغة يُمالئ اليسار فيها جمهوره الخاص والجمهور العريض أيضاً، مقابل الحصول على دعمه الدائم بدون مسائلة نقديّة لأسس هذا التعاقد. يُمكن فهم أن يسعى يسارٌ يعمل في بيئة التحرّر الوطني لبناء جبهة عريضة من الجمهور، تضمّ حتّى أولئك الذين لا يدينون تماماً بأفكاره، لكنّ هذه العمليّة تتحقّق ضمن شروط يكون فيها لليسار وقيمه موقع أساسيّ في قيادة هذا الجمهور على أساس رؤية تتضمن انحيازات سياسيّة واجتماعيّة واضحة ومتمايزة من موقع يساري، وهو ما لا يحدث في الواقع إطلاقاً.
ليست هذه رؤية نخبويّة كما تبدو للوهلة الأولى. إنّها تنطلق من اعتباراتٍ عمليّة بحتة. ما أجادل فيه دوماً هو أنّ قواعد الأحزاب الدينيّة واسعة إلى الحدّ الذي لا تحتاج فيه إلى أيّ نوعٍ من المُمالأة الأيديولوجيّة من قِبل الآخرين. كما أنّ محاولات التماهي أو التقارب مع الخطاب الديني السائد لا يُمكن أن يشكّل استراتيجيّة فعّالة لجذب الجمهور، لأنّ التأويل الدينيّ للسياسة هو انشغال أصيل لدى الإسلاميّين، أيّ أنّه حقلهم الخاص الذي لا يسع غيرهم مُنازعتهم فيه. وحتّى بالمعنى البراغماتي البحت، لم تؤدِ ميوعة اليسار على المستوى الفكري ونكوصه عن قيمه إلى إضافة معتبرة لوزنه الجماهيري، فنتائج انتخابات النقابات واتّحادات الطلبة وغيرها من الإطارات المؤسّسية تقول بشكل حاسم إن القواعد التصويتيّة لليسار لم تتغير منذ سنوات طويلة.
يحتاج الأمر إلى مُغامرة إذاً؟ بالطبع، تبدأ السياسة الحقيقيّة من خلال تأسيس حيّزك الخاص في الفضاء العام. الحيّز المُتمايز على صعيد الأفكار والممارسة والسعي لتأطير الناس داخله. حيزٌ لا يسعى إلى محاولة التطابق مع الخطاب السائد أو التصالح معه والتموضع بقربه، وإنّما يحاول شقّه بموقف حدّي مُتمايز. قد يكون قطاع كبير من الناس اليوم مُسلّماً بالخطاب الإسلاموي، لكنّ هناك طيفاً واسعاً أيضاً يسعى إلى التمايز عن هذا الخطاب، وتحديداً في ضوء التطوّرات الأخيرة في المنطقة، وهو ما يجب أن يفتح الطريق لضرورة تمثيل هذا الطيف على أرضيّة جديدة أكثر تنوّراً. تبدو المهمّة مُضنية، لكنّ تأسيس الاختلاف الجذري عبر خُطوط السياسة والمُجتمع وتثبيته ليتمحور الصراع حوله، يبقى أفضل مئة مرّة من الركون لكسل الواقع.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]