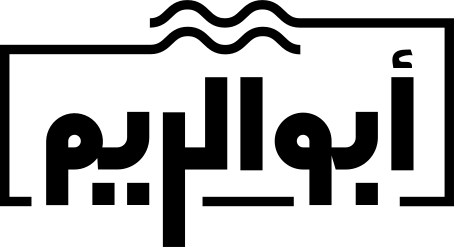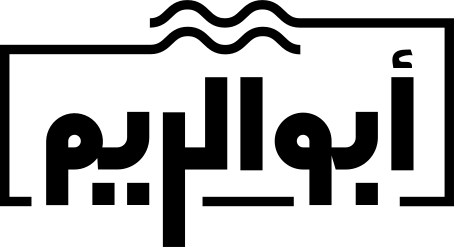[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشر في موقع “حبر” الإلكتروني في 7 نيسان/أبريل 2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]نستطيع الآن، وبمقدارٍ كبيرٍ من الثقة، القول إن العالم مُقبلٌ على أزمة اقتصاديّة طاحنة ستكون أكبر عمقًا ومدى من الأزمة الماليّة التي ضربت العالم في العام 2008. أزمة العام 2008 بدأت بالأساس من الاقتصاد الماليّ عندما انفجرت فقّاعة الرهن العقاريّ مُسبّبة انهيارًا واسع النطاق لمؤسسات ماليّة وبنوك كبرى وبيوت استثمار حول العالم، قبل أن تنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي في صورة انكماشٍ للإنتاج الصناعي والاستثمار وارتفاع معدّلات البطالة وتآكل القوّة الشرائيّة للمستهلكين. أما أزمة اليوم، وعلى العكس من ذلك، فقد بدأت من الاقتصاد الحقيقي مباشرة، إذ أدّت الإجراءات التي اتّخذتها غالبية دول العالم لاحتواء عدوى فيروس «كورونا» المستجد إلى تعطيل سلاسل القيمة المُعولمة من كلا الجانبين.
من جانب العرض، ضرب الفيروس أوّل ما ضرب، البلدان الآسيويّة التي تُعدّ «مصنع العالم»، وقد أثّر هذا الأمر على إمداد الأسواق الأوروبيّة والأمريكيّة بالسلع الإلكترونيّة الحديثة بشكلٍ خاص مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة وشاشات التلفاز المُسطّحة. وما إن بدأت هذه البلدان في احتواء الموجة الأولى من العدوى، حتّى تعرّض جانب الطلب من الاقتصاد العالميّ إلى هزّة عنيفة، إذ سرعان ما أدّى الإغلاق المُشدّد الذي فُرض على مناحي الحياة العامّة المُختلفة في أوروبا وحظر حركة الطيران عبر الأطلنطي، إلى تراجعٍ هائلٍ في الإنفاق الاستهلاكيّ، فاتحًا الباب أمام تعطّل الآلاف من الشركات وبالتالي تسريح الملايين من العمّال في قطاعاتٍ مُختلفة. نحن نتحدّث هنا عن أمرٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث: لقد دخلت منظومة الاقتصاد العالميّ الهائلة والمتشعبة في إجازة مفتوحة.
خلال السنوات التي تلت أزمة العام 2008، كانت التدابير الاقتصاديّة التي لجأت إليها الحكومات الغربيّة ذات طابعٍ نقديّ بشكلٍ يكاد يكون حصريًّا. أُعطيت دفّة القيادة للبنوك المركزيّة حتّى تتولى مسؤوليّة توفير السيولة للأسواق الماليّة وضمان عدم سقوطها تحت وطأة الاهتزاز الذي خلّفه انفجار فقاعة الرهن العقاريّ. خرجت إلى النور سياسة «التيسير الكمّي» التي كانت تعني ببساطة شراء البنوك المركزيّة للسندات الحكوميّة وسندات الشركات الكبرى والبنوك عند أسعار منخفضة للغاية أو صفريّة في بعض الأحيان. ضُخّت تريليونات الدولارات في الأسواق الماليّة العالميّة على يد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيّ بالذات، لتصدير الانطباع بأنّ كل شيء يسير على ما يُرام، بدليل أن الجميع حول العالم يستطيعون الاستدانة بسهولة وبتكاليف منخفضة لتمويل استهلاكهم واستثمارهم.
كان هذا المال الرخيص الذي أغرق الأسواق العالميّة الباب الذي دخلت منه البنوك والمؤسسات الماليّة والشركات الكبرى في بلدان المركز الرأسماليّ الغربي إلى عصر ذهبيّ جديد. فقد أمكن لهذه الإمبراطوريّات أن تحصل على المال عند أسعار فائدة منخفضة من الأسواق الغربيّة قبل أن تُعيد إقراضها بفوائد أعلى في الأسواق الأخرى مُحقّقة أرباحًا ضخمة. وليس هذا فحسب، بل إنّ هذا المال الرخيص سمح لهذه المؤسسات والشركات الكبرى بتمويل عمليّات واسعة لإعادة شراء أسهمها مُجددًا من السوق في إطار عمليّة «هندسة ماليّة» هي أقرب للاحتيال المُقونن الهادف إلى تضخيم قيمها السوقيّة من جانب، ومنح مدرائها التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارتها المزيد من الامتيازات الماليّة من جانب آخر.
إذا أردنا استعارة المصطلحات الطبيّة، فبإمكاننا القول أن سياسة «التيسير الكمّي» التي اتُبعت خلال العقد الأخير كانت أقرب للعلاج النفسي منها للعلاج الجراحي. فقد عنت عمليّات إعادة الهندسة الماليّة، والتي لم تكن ممكنة بدون توفّر الديون الرخيصة التي وفّرتها البنوك المركزيّة، أن جزءًا ضئيلًا من الموارد الماليّة سيذهب إلى الاستثمار في الأنشطة الإنتاجيّة التي يُمكن لها خلق المزيد من فرص العمل. ولهذا السبب، فقد كانت الاقتصاديّات الغربيّة خلال العقد الفائت تُحقّق مُعدّلات نموّ منخفضة للغاية، بل إنّ بعضها كان يُجاهد لعدم السقوط في دائرة الركود مُجدّدًا.
وبموازاة ذلك، فقد تمخّض عن توفّر السيولة الرخيصة في الأسواق العالميّة، اتّساع حلقة الديون إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، إذ ارتفع الدين العالميّ من حوالي 170 تريليون دولار في العام 2009 إلى ما يزيد عن 250 تريليون دولار بنهاية العام 2019، وأصبح الشغل الشاغل للشركات حول العالم خدمة هذا الدين بدلا من الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجيّة أو ترقية كفاءة العمّال ناهيك عن رفع أجورهم.
هذا المشهد كانت له تبعاته الجذريّة على المشهد السياسيّ في الغرب. فإنقاذ البنوك والشركات الكبرى بأموال دافعي الضرائب عبر انتهاج سياسة تقشّف قاسية، أزال في الواقع آخر الأقنعة عن وجه سياسات الوسط الليبراليّة التي حكمت القارّة الأوروبيّة بشكلٍ أو بآخر خلال العقود الأخيرة. بدا لجزء متعاظم من الجمهور هناك أنّه كان يعيش في خدعة كبيرة، وأنّ النخب السياسيّة التي تتشدّد ضدّ مطالب الفئات محدودة الدخل والنقابات العماليّة وتقاتلها على الفتات، مستعدّةٌ للعمل كوكيل سياسيّ للطغمة الماليّة وعن طيب خاطر حين تقع هذه الأخيرة في أزمة. وكان من الطبيعيّ لهذا التناقض أن يساعد في النهاية على تقوية التيّارات اليمينيّة المتطرفة والشعبويّة والتي تحمل توجّهات عدميّة معاديّة للمؤسسة الديمقراطيّة ولقيمها من الأساس. أما في الولايات المتحدة، حيث كانت السياسات الريجانيّة قد فعلت فعلها في بنية المجتمع والاقتصاد منذ زمن، فقد أخذ الارتداد اليميني شكل الجنون منفلت العقال بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
خلال الأسبوعين الماضيين، وجدت النخب السياسيّة الغربيّة نفسها أمام ورطة كبيرة. فإجراءات التحفيز النقديّ بمليارات الدولارات لم تعمل على النحو المطلوب، لأنّ السياسة النقديّة استنفذت ببساطة كلّ ممكناتها خلال العقد الأخير. وقد تمثلت الاستجابة لتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزيّة في أوروبا وأمريكا في انهياراتٍ جديدة في البورصات العالميّة. وعندما لجأت هذه النخب على استحياء إلى الخيار الكينزي، أي إلى الخيار النموذجي الذي لطالما أنقذت الرأسماليّة نفسها من خلاله في غالبيّة أزماتها، فقد بدا الأمر خارج السياق تمامًا، إذ أنّه من الصعب في النهاية تحفيز الطلب الكلّي عبر حزمٍ ماليّة حكوميّة إذا كانت كلّ مرافق الاستهلاك مُغلقة فعليًّا. هُنا، لم يكن من بدّ سوى اللجوء إلى سياسات تُذكّر بسياسات اقتصاد الحرب، أي في تدخّل الجهاز الحكوميّ بشكلٍ مباشر في إدارة الاقتصاد والمجتمع وتوزيع الموارد وتوجيه الصناعات الثقيلة لإنتاج سلعٍ بعينها، ناهيك عن تنامي دور الجيش وسلطاته في الحياة العامّة.
لم يكن الاقتصاد العالميّ قد تعافى بعد من هزّة أسواق المال في العام 2008 حين حلّت أزمة «كورونا»، والصحافة الاقتصاديّة الغربيّة كانت تحفلُ في العامين الماضيين بتقارير مُتشائمة تُحذّر من أزمة ماليّة وشيكة بالنظر لتراجع معدّلات النموّ الاقتصاديّ في البلدان الرأسماليّة وانتفاخ النظام الماليّ العالميّ بالمزيد من الديون. تأتي أزمة الفيروس التاجي اليوم لتعمّق الصدوع القائمة فعلًا ولتنقلها إلى درجة جديد من الحدّة على المستوى الاقتصادي.
أما على المستوى السياسي، فلا تبدو الأمور أقلّ قتامة. فبينما تميّز الرد على أزمة العام 2008 بالتنسيق المتناغم بين الحكومات والبنوك المركزيّة على جانبيّ الأطلنطي، غرقت أمريكا والدول الأوروبيّة هذه المرّة في ردود منفردة ومتخبّطة، بل ونكصت إلى سياساتٍ انعزاليّة عدائيّة ضدّ بعضها البعض من أجل الاستحواذ على ما أمكن من المعدّات الطبيّة ووسائل الحماية من العدوى. وقد حجبت حالة الطوارئ والاستنفار في هذه البلدان إجراءاتٍ قمعيّة استهدفت إسكات الأصوات الاحتجاجيّة على انعدام الكفاءة وتآكل النظام الصحّي والفشل في حماية العاملين فيه. من يضمن ألا تتحوّل عمليّات القرصنة الجديدة بين هذه البلدان إلى تحرّشات أكثر عنفًا في المستقبل القريب؟ ومن يضمن ألا تكشف الديمقراطيّة الغربيّة عن المزيد من أنيابها الخفيّة لتنحطّ بالسياسة إلى درك جديد؟[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]