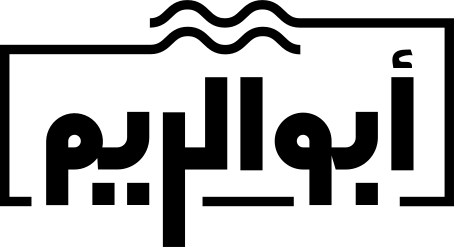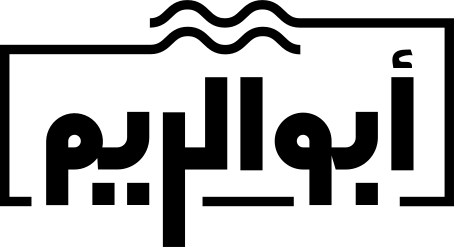[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشرت في مُلحق “السفير العربي” في 27 تموز/يوليو 2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]حين غادرتُ غزّة في العام 2011، وكان الحصار الإسرائيليّ قد أرخى بغمامة سوداء ثقيلة على الأحوال المعيشيّة والقدرة الشرائيّة للناس لبضع سنواتٍ آنذاك، كان العديد من المشاريع الصغيرة كمحال البقالة وبيع اللحوم المُجمّدة والمطاعم الشعبيّة والورش والمعامل الصغيرة التي تُنتج بعض أنواع الأغذية والحلويّات.. قد بدأت بالتكاثر كالفطر في أزقّة مخيّمات ومدن القطاع المحاصر.
لم يبدأ هذه الموجة من الاستثمارات الصغيرة عائلاتٌ ثريّة معروفة بنشاطها التجاريّ التقليديّ، بل أناس بسطاء لديهم مدّخرات متواضعة يرغبون بتشغيلها، أو موظّفون صغار يسعون لمصدر دخلٍ إضافيّ، أو متعطّلون من الفئة التي تُسمّى في غزّة بـ “عمال إسرائيل”، كناية عن الـ100 ألف عامل الذين استغنت الأخيرة عن قوّة عملهم ليُتركوا في مواجهة العوز. وقد ارتُجلت غالبيّة هذه المشاريع على عجل، من خلال اقتطاع أصحابها أجزاءً من أماكن سُكناهم وتحويلها إلى مساحة للعمل، أي أنّ رأسمالها الأساسيّ كان يتمثّل في إعادة اختراع الحيّز المكانيّ الضيّق وتكييفه للقيام بوظيفة جديدة تتعدّى وظيفته التقليديّة كمأوى فحسب.
وجاءت تجارة الأنفاق بين غزّة وسيناء، والتي بدأت بالازدهار باطّراد بعد بدء الحصار المُشدّد عام 2007، لتدفع اقتصاد المشاريع الصغيرة هذا إلى حدود جديدة من التوسّع والنمو. فقد غذّت هذه التجارة السوق المحلّي بمجموعة متنوّعة وكبيرة من السلع التي افتُقدت تماما جرّاء القيود الإسرائيليّة المشدّدة، وأعادت في الوقت نفسه الكثير من الورش الحرفيّة، مثل النجارة والحدادة والألمنيوم وغيرها.. إلى العمل مجدّداً بتوفيرها للمواد الخام التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزّة. وهو الأمر الذي مكّن في نهاية المطاف من استيعاب جزءٍ من قوّة العمل الغارقة في البطالة، أكان في شبكة الأنفاق ذاتها أو في المشاريع التي ازدهرت ارتباطاً بنشاطها. وهكذا، أصبح بالإمكان رؤية صاحب المطعم الشعبي وهو يفتتح محلا جديدا لبيع السلع المُعمّرة، أو رؤية صاحب البقالة الصغيرة وهو يُوسّع أعماله بافتتاح ورشة لإنتاج الحمص أو دكّان لبيع الوقود والمولّدات الكهربائيّة.
تجارة الأنفاق وأخلاقيّاتها الجديدة
مع أنّ تجارة الأنفاق كانت الوسيلة الإبداعيّة الأهم في محاولات الغزيّين للتفلّت من القبضة الإسرائيليّة على حياتهم، والتكيّف مع الظروف الصعبة التي خلقها الحصار، إلّا أنّ ازدهارها على نطاقٍ كبير وغير منضبط، أهدر أيّ طابع “مقاوِم” لها مع الوقت، وأبعدها كثيرا عن دورها المفترض كرافعة وطنيّة ذاتية لمشروع مواجهة الحصار. وقد وصلت هذه التجارة حدّا راحت تلتهم عنده السياسة والمجتمع في آنٍ معا، وخلقت عبر هذه الصيرورة قيماً وأخلاقيّات وأنماطاً استهلاكيّة تتناقض في مبناها ومعناها مع الظروف المأساويّة التي خلّفها الحصار.
أصبحت الحكومة الحمساويّة التي تُدير قطاع غزّة تعتمد اعتمادا رئيسيّا في مصاريفها التشغيليّة وتوسّعها البيروقراطيّ على الضرائب التي تجبيها على البضائع المُورّدة من الأنفاق، وعلى الرسوم التي تحصل عليها لقاء منح تراخيص لافتتاح أنفاق جديدة (شكّلت هيئة رسميّة لهذا الغرض تحت اسم “هيئة الأنفاق”). وراحت الثروات تتراكم لدى فئة اجتماعيّة جديدة من التجّار والسماسرة المرتبطين بهذه التجارة، والذين كانوا يعيدون ضخّ أرباحهم منها في شراء الأراضي والعقارات بغية استغلالها للبدء بمشاريع جديدة مثل الاستراحات الترفيهيّة والشاليهات وصالات الأفراح، أو لاستخدامها كمخزنٍ للقيمة. وبدأت تنتشر في غمرة هذه الحالة قيم “البزنس” و “الفهلوة” لدى أناسٍ ينتمي أكثرهم لفئاتٍ اجتماعيّة متواضعة لم يسبق لها العمل في مجال التجارة، وأصبح التديّن الظاهريّ من الإكسسوارات الضروريّة للنشاط التجاري، وازدهرت أساليب المضاربة والاحتكار وألاعيب النصب والاحتيال (في واقعة شهيرة، جمعت شبكة من أعضاء “حماس” ومُقرّبون منها أموالا طائلة قُدّرت بحوالي 20 مليون دولار من الناس عبر إيهامهم باستثمارها في الأنفاق ليكتشفوا لاحقا أنّ الأمر كان خدعة مُدبّرة لسلبهم أموالهم).
لقد أعْمت الدوامة المجنونة من الربح والمصلحة الآنيّة كلّ من غرقوا فيها بحماسة عن حقيقة أنّ تجارة الأنفاق كانت قائمة على أساسٍ هش، وأنّ تبدّل أحوال السياسة وتقلّب أمزجة الجغرافيا كان كفيلاً بإطاحتها في أيّ لحظة، وأنّه كانت هنالك حاجة ماسّة لأن تبقى هذه الحقيقة ماثلة أمام حكّام غزّة منذ البداية للعمل على أساسها. لكن الوقت كان قد فات كثيراً في صيف العام 2013. إذ أدى سقوط حكم محمّد مرسي في مصر وشروع الجيش المصريّ بعدها بإجراءات حاسمة لإغراق حدود غزّة الجنوبيّة بالمياه والقضاء على الأنفاق قضاءً شبه كامل، إلى ضرب غزّة بموجة من الركود والكساد، مع انقطاع تدفّق السلع والمواد الخام التي وفّرت الأساس لنشاط القطاعات الإنتاجيّة والمشاريع الصغيرة في السابق. وسرعان ما وصلت ارتدادات هذه الهزّة إلى حركة “حماس” نفسها التي أعلنت حكومتها أنّها عاجزة عن دفع رواتب موظّفيها البالغ عددهم 40 ألف شخص تقريبا.
وفي ربيع العام 2014، وفي خطوة رآها الكثير من المراقبين كمحاولة لمجابهة الضغوط الشديدة الوطأة عليها ماليّاً وسياسيّاً، وقّعتْ حركة “حماس” على وثيقة مصالحة جديدة مع “فتح”، عُرفت باسم “وثيقة الشاطئ” التي نصّ أهمّ بنودها على دراسة وتقنين أوضاع الموظّفين الذين عيّنتهم في أجهزة حكومتها بغزّة، كمقدّمة لإدماجهم في الجهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينيّة في ظلّ حكومة توافق وطنيّ تَجمع بين الضفّة الغربيّة وغزّة. ومع أنّ المصالحة بين الطرفين لم ترَ النور هذه المرّة (كما في مراتٍ سابقة كثيرة)، إلا أنّ الحراك الحمساويّ في الموضوع الداخلي بات يتمحور منذ ذلك الوقت على قضيّة الموظّفين خاصة، ويعتبر أنّ المصالحة غير ممكنة قبل اعتبارهم موظفين شرعيّين ودفع رواتبهم من خزينة السلطة في رام الله التي يموّلها المانحون الدوليون.
تكيّف السلطة أم تكيّف المجتمع؟
علاوة على هذا، كانت النتيجة الحاسمة لانهيار تجارة الأنفاق استعادة إسرائيل مجدّداً لهيمنتها الكاملة على اقتصاد قطاع غزّة، بطريقة أكثر فاعليّة وخبثاً. وكما استخلصت مقالة عرفات الحاج “الطور الثاني من حصار غزة.. أكثر تحديداً وفتكاً” التي نُشرت على صفحات “السفير العربي” فقد دخلت غزّة منذ تحييد اقتصاد الأنفاق، ما سمّاه “الطور الثاني” من الحصار الإسرائيليّ. في هذا الطور، أصبحت إسرائيل تلعب مع قطاع غزّة لعبة مزدوجة: إنّها من جانب تمنع وتعرقل دخول المواد المُستخدمة في الأنشطة الاقتصاديّة الإنتاجيّة إليه، لكنّها تُسهّل من الجانب الآخر إغراقه بالسلع الاستهلاكيّة من شتّى الأشكال والألوان، مُستهدفة إفراغ جيوب سكّانه من مدّخراتهم واستنزاف دخولهم في حلقة مفرغة يغيب فيها الإنتاج ويسيطر عليها الاستهلاك بالكامل. وقد اكتسبت هذه اللعبة المزدوجة دوراً أعمق تأثيرا بعد الحرب الإسرائيليّة المُدمّرة على غزّة صيف 2014 (بدأت في 7 تموز /يوليو إثر قصف صاروخي من غزة رداً على قتل المستوطنين تعذيباً وحرقاً الطفل محمد أبو خضير من مخيم شعفاط قرب القدس، في 2 تموز/يوليو، ودهس اثنين من العمال العرب. وربما يمكن اعتبار تاريخ اختتام جولتها هذه في “مؤتمر المانحين” في تشرين الأول/ أكتوبر في القاهرة). فقد بات بمقدور إسرائيل السيطرة على عمليّة إعادة الإعمار بكلّ تفاصيلها وإدارتها بالاتّجاه الذي يُناسب أهدافها، واستخدامها كأداة لابتزاز الفلسطينيّين بالطريقة التي تحلو لها.
إذا كانت حركة “حماس” قد رهنت توسّع حكمها وتعميق نفوذ سلطتها بالاعتماد الكبير على تجارة الأنفاق في الطور الأوّل من الحصار، وتساهلت مع ظواهر الإثراء الجديد التي رافقتها بكلّ ما ولّدته من استقطابات اجتماعيّة وصعودٍ لقيم الربح والاستهلاك، فإنّ استجابتها للطور الثاني منه لم تشذ عن المنطق الضيق الأفق ذاته القائل بضرورة الحفاظ على السلطة والنفوذ حتى لو جاء ذلك على حساب المجتمع وعلى حساب مناعته في مواجهة الحصار.
وبدلا من أن تستفيد الحركة من الدروس القاسية لهذا الحصار لصياغة استراتيجيّات صمود واكتفاء ذاتيّ – أو أقلّه استراتيجيّات “طوارئ” – فقد أظهرت على العكس من ذلك تكيّفاً لافتاً وغريباً مع الضرب المُتجدّد من الهيمنة الاقتصاديّة الإسرائيليّة على غزّة. وتجلّى هذا خاصة في ازدياد اعتماد حكومتها على الضرائب التي تجبيها على السلع المورّدة من المعابر الإسرائيليّة، وهو الأمر الذي مكّنها من دفع جزءٍ من رواتب موظّفيها بانتظام خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنّه ربطها بالمقابل ربطاً أوثق بآليّات التحكّم الإسرائيليّ بحركة التجارة، وأرغمها على الرضوخ للإستراتيجية الإسرائيليّة لإغراق غزّة بالبضائع الاستهلاكيّة، لأنّ هذا الأمر يصب في نهاية الأمر في مصلحة زيادة جبايتها الضريبيّة.
خلاصة: أسئلة غير بريئة!
لقد كانت سنوات الحرب والحصار الظالم على غزّة من أشنع ما تعرّض إليه هذا المكان منذ النكبة. هذه الحقيقة، على كلّ ما فيها من فظاعة، يجب ألا تمنع من الاعتراف بأنّ إدارة الفلسطينيّين لملفّ الحصار خلال السنوات السابقة كانت مليئة بالأخطاء، وأنها لم تصب في نهاية الأمر في تعزيز صمود غزّة وتحصين مناعتها الداخليّة، وأن تورّط “حماس” في لعبة السلطة وتكاسل القوى الفلسطينيّة الأخرى عن لعب دور ذي معنى في هذا الصدد قد جعل من هذا الحصار أكثر قسوة على الفلسطينيّين في غزّة، الأمر الذي يجب أن يطرح بذاته الكثير من الأسئلة اليوم: ما الذي تعنيه بالضبط القوى الفلسطينيّة حين تتحدّث عن ضرورة “إنهاء الحصار” على غزّة؟ ما الفائدة من إدخال هذا العدد من السيارات الحديثة من آخر طراز إلى غزّة فيما لا يستطيع الكثير من الناس هناك دفع ثمن مواصلات تُقلّهم إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم؟ ما الفائدة من وجود كلّ هذه السلع الاستهلاكيّة على أرفف المحال و “المولات” في ظلّ ارتفاع معدّلات سوء التغذية عند الأطفال والنساء؟ هل إنفاق الملايين على بناء مساجد فخمة ومكيّفة خير وأبقى من تأسيس “بنك طعام” يُقدّم لكلّ الأطفال الفلسطينيّين في غزّة وجبة يومية صحيّة ومتكاملة غذائيّاً ويقيهم ذل الانتظار في طوابير المؤسسات الخيريّة التي تلتقط لهم الصور المهينة لتقدّمها للمحسنين في كلّ مكان طلبا للمزيد من المساعدة؟ هل الدور الذي تقوم به كلّ هذه المؤسسات الدوليّة الإغاثيّة في غزّة إنسانيّ فعلا؟ ولماذا نُسلّمها رقابنا على هذا النحو بدون أدنى تدقيق في أجنداتها؟ ألا تستحقّ الموارد المالية والطاقات المهدورة في ورش العمل وصالونات العلاقات العامة السياسيّة المبتذلة التي يحدد عناوينها الممولون الأجانب، أن تذهب لمصلحة إيجاد تعاونيّات تطوعيّة لتحسين منظومة الصحّة العامة والنظافة والتعليم؟ وهل نستطيع أخذ زمام المبادرة والبدء بالتفكير بإمكانيّات الاعتماد على الموارد الذاتيّة وتنظيمها بما يُهوِّن ولو قليلاً من ويلات الحصار الذي قد يمتدّ لسنوات أخرى طويلة، ويوزّع أعباءها بشيء من التساوي على كلّ الناس؟[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]