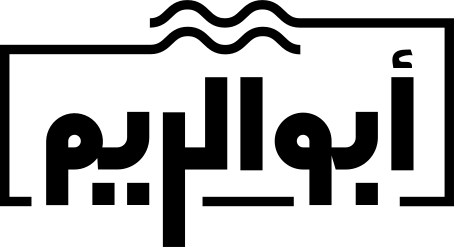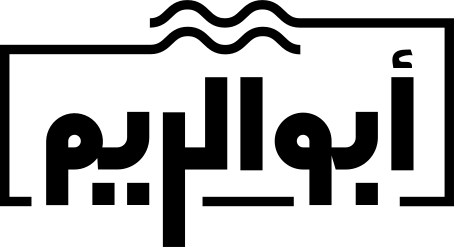[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشرت في مُلحق “السفير العربي” في 14 نيسان/أبريل 2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]منذ أيام، في صبيحة السادس من نيسان / أبريل الجاري، استفاق أهالي قطاع غزّة على مشهدٍ فظيع. فقد نشرت إحدى الوكالات الإخباريّة المحليّة تسجيل فيديو قصيرا يُظهر موظّفا حكوميّا من وزارة الأوقاف الفلسطينيّة مُحاطا بمجموعة من الشبّان المُلتحين الذين يلبسون الجلابيب، وهو يخطب في ساحة مدرسة أمام حشدٍ من الطلاب داعيا إيّاهم للتوبة إلى الله والعودة إلى طريق الحق وترك المعاصي. ولم تكد تمضي لحظاتٌ قليلةٌ تخلّلتها عبارات التكبير وأنغام الموسيقى الدينيّة الحزينة، حتّى بدأت طلائع الطلبة التائبين الذين كانت تنهمر الدموع من عيونهم بغزارة بالتقاطر إلى الموظّف وجماعته من المشايخ الشُبّان الذين كانوا يستقبلونهم بالأحضان. غرق المكان بالعاطفة الحارة، تعالت الأناشيد الحزينة، همّ بعض الطلاب بالسجود على الأرض، وأعلن الموظّف أن الشيطان طُرد شرّ طردة من قلوب هؤلاء الأطفال وأنّ الله ورسوله فرِحان بهما أيمّا فرحة
الأيديولوجيا الخلاصية
الفيديو الصادم للكثيرين انطوى على مستوى غير مسبوق من الإسفاف الممزوج بالترهيب. لكنّ المُتابع لأخبار القطاع في الفترة الأخيرة يعرف أنّ وزارة الأوقاف أطلقت مع جمعيّات شبابيّة سلفيّة، يغلب عليها الطابع الوهّابي، حملة واسعة النطاق تحت اسم “المُلتقيات الدعويّة” الهادفة إلى هداية الناشئة وإعادة من ضلّ الطريق منهم إلى جادة الصواب. وفي واقعةٍ أخرى سجّلها أهالي بعض الطلبة في مدرسة ثانية مثلا، جرى وضع طالبٍ في كفن أمام زُملائه في ساحة المدرسة وأهيل عليه بعض التراب لوعظ الأطفال عن أهوال العذاب الإلهي الذي سيطال الأشقياء الخالية قلوبهم من الإيمان والتقوى! لماذا تُؤرّق الشياطين هؤلاء من “حماس” إلى هذا الحد؟ ولماذا وصلت غزّة إلى هذا المربع البائس؟ وما الذي يعنيه مشهد التوبة والدموع في السياق الأوسع لمآلات مشروع الإسلام السياسيّ كما جسّده الأخوان المُسلمون؟
يقوم جوهر مشروع الإسلام السياسيّ على أيدلوجيا دينيّة خَلاصيّة تستهدف بناء المجتمع المسلم من خلال الدعوة، ونقله إلى مرحلة جديدة تتجسّد فيها سيادة شرع الله على الناس. من هنا، فقد كانت “الأسلمة” حجر الزاوية في استراتيجية جماعة الأخوان، عبر مؤسّسات التعليم والإعلام، مستفيدين من أموال الريع النفطي والتبرعات لإنشاء اقتصادٍ خاص عماده الكتيّبات رخيصة الثمن التي كانت تروّج لنظريّات إسلاميّة في المعرفة والعلوم، كما تجسّد في دخول مناهج “الاقتصاد الإسلاميّ” إلى الجامعات وانتشار خُرافة “الإعجاز العلميّ للقرآن” في أوساط واسعة من المُتعلّمين.
وبالإضافة لذلك، جعل الإسلاميّون إضفاء الطابع الإسلاميّ على تفاصيل الحياة اليوميّة واحداً من أكبر استثماراتهم، وذلك من خلال الدعوة إلى لبس الحجاب، والتشدّد إزاء مسألة اختلاط الجنسين، والعمل لتكثيف السيطرة الرمزيّة على الفضاء العام عبر إظهار الشعارات الدينيّة والصور والرايات في كلّ مكان يُمكن الوصول إليه.
الذي جرى في غزّة مُؤخّراً يُمكن تسجيله من هذا المنظور إذاً كفصلٍ جديد من فصول الاستراتيجيّة التقليديّة الهادفة إلى الأسلمة. لكنّ هذا لا يمنع في الوقت نفسه من التذكير بأنّ عمليّة الأسلمة تجري قبل كلّ شيء في سياقاتٍ سياسيّة واجتماعيّة مُحدّدة، وأنّ تغيّر هذه السياقات بأيّ مقدار، أو دخول عناصر جديدة عليها، سيعمل في النهاية على تغييرٍ في وظائف عمليّة الأسلمة ذاتها.
ضبط المجال الديني
في السنوات الماضية وقع تغييران مهمان، الأوّل أن “حماس” تحوّلت منذ سيطرت على غزّة عام 2007 إلى سلطة تُدير دزّينة من المُؤسّسات البيروقراطيّة التي تحفظ الأمن وتجبي الضرائب وتنظم أحوال الناس الدنيويّة المُختلفة. وتلك كانت لحظة فارقة لأنّها البداية الفعلية لافتراق النموذج الحالم الذي جرت تربية الآلاف على اعتناقه، عن النموذج الذي بدأ يظهر في الواقع الحيّ.
اكتشف مريدو الجماعة مع الأيّام أنّ الشريعة لن تُطبّق، وأنّ جماعتهم النورانيّة لن تملأ الأرض عدلا وقسطاً، لأنّ أصحاب الحظوة فيها قد بدأوا باستغلال سلطتهم أبشع استغلال ليُراكموا المزيد من المال عبر جباية الضرائب والانخراط في أعمال “البزنس”، والاستيلاء على الأراضي العامّة، وتشجيع أنماطٍ استهلاكيّة جديدة من التبذير، وتحويل العمل الخيريّ إلى مجرّد ستار لكل هذا.
ولأنّ “حماس” لم يعد يسعها التراجع عمّا ذهبت فيه، ولأنّ أوراق القوّة التي كانت تملكها حين كان خطاب دعوتها خطاب مظلوميّة جذّابا سُحبت منها بالكامل مع وصولها إلى السلطة، فلم يكن أمامها للحفاظ على تماسكها سوى إعادة تدوير بضاعتها الدينيّة القديمة لإرضاء واحتواء هؤلاء الذين خاب أملهم وأُجهض حلمهم، وبدأت نوازع التمرّد على جماعتهم الأم تكبر في نفوسهم يوما بعد يوم.
نشطت وزارة الأوقاف في غزّة منذ العام 2007 بشكلٍ خاص في عمليّة إعادة ضبط المجال الديني من خلال إطلاق الكثير من البرامج الدعويّة ومشروعات تحفيظ القرآن، ووضعت آليّة لضمان السيطرة على أكبر عددٍ من مساجد غزّة من خلال التحديد المُسبق لموضوعات الخطب الدينيّة فيها، وتحديد الخُطباء المُعتمدين المسموح لهم بالصعود إلى المنابر، وخاصّة مع تصاعد جاذبيّة أفكار المجموعات السلفيّة الجهاديّة التي ارتكز خطابها بشكلٍ أساسيّ على لوم “حماس” لعدم تطبيقها للشريعة. وعلاوة على ذلك، لم تمنع الوزارة نفسها من تبنّي حملاتٍ مُثيرة للجدل أحيانا، مثل حملة “ترسيخ القيم والفضيلة” التي أطلقتها في شباط/ فبراير2013 لمكافحة ما أسمته “العادات الغربيّة الدخيلة على مُجتمعنا من ملابس غربيّة غير ملتزمة وقصّات الشعر الأجنبيّة الغربيّة”، وهي الحملة التي يمكن النظر إليها كمحاولة لمجاراة الضغوط المتزايدة على الحكومة من قبل قواعد “حماس” الأكثر سلفيّة لتبني سياساتٍ أكثر تشدّدا. وبهذا المعنى، فقد واجهت “حماس” فشل الأسلمة بالمزيد من الأسلمة، وراحت هذه العمليّة تكتسب أكثر فأكثر وظيفة “الميكانيزم الدفاعي” بدلاً من وظيفة التعبئة الموجّهة لاستقطاب المزيد من الأنصار التي كانت تقوم بها في السابق.
التغيّر الثاني كان في التطوّر النوعيّ والانتشار الواسع لوسائل التواصل الإلكترونيّ والرقمي. فقد أدّى هذا إلى إحداث صدعٍ كبير في منظومة احتكار مشروع الإسلام السياسيّ لجزءٍ مُهم من عمليّة إنتاج الخطاب الديني في المُجتمعات الإسلاميّة، بعد أن أصبحت النوافذ على العالم أكثر عددا وأوسع رحابة، وغدت الأرضية أسهل لنقاش القضايا العامّة. وقد أعطت هذه الموجة المُستمرة من انتشار الإنترنت في الوقت نفسه الفرصة للمنافسين التقليديّين للإخوان أو للجماعات التي خرجت من عباءتهم بغضّ النظر عن الاتّجاه الذي اختطته لاحقا. منابر كثيرة للترويج لأفكارها وبثها في أماكن جديدة لم تكن تطالها من قبل. وراح طغيان التكنولوجيا مع الوقت يجعل من “تعليب” الخطاب الديني في صورة مُنتجات أثيريّة مُتشيّئة (مثل تغريدة على “تويتر” أو دعاء على “الفايسبوك”) عمليّة أكثر سهولة، وهو ما فتح الطريق لدخول لاعبين جدد إلى الحلبة. فلم تعد الدعوة إلى الله بحاجة الآن إلى علمٍ شرعي أو قدرات استثنائيّة في الخطابة واللغة بل إلى امتلاك الإكسسوارات الدعويّة الملائمة، والسوق قد أصبح مشبعاً بها تماماً.
ولذلك، فقد كان لافتا أنّ الحملة الأخيرة لوزارة الأوقاف استلهمت بشكلٍ كامل أساليب بعض الدعاة السعوديّين الجُدد التي ازدهرت خلال العقدين الماضيين، والتي لا تُركّز على مضمون الخطاب الوعظيّ نفسه بقدر ما تُركّز على “مشهديّة” الحدث الذي تجري عمليّة الوعظ فيه. فالدعاة هُنا لا يطرقون أبواب المنازل ولا يلتقون بمريديهم في حلقات المساجد المُغلقة، ولكنّهم يحشدون الناس في الساحات العامّة ليلقوا فيهم خُطبا عاطفيّة تطغى عليها المُؤثّرات الحسيّة والبصريّة التي تتوسّل قذف الرهبة في قلوبهم تارة واستدرار عاطفتهم الحارّة تارة أخرى.
من هنا، فإنّ التشديد المُضطرد على الأسلمة يعكس في جانب أساسيّ منه رغبة محمومة لمجاراة المنافسة الشديدة في سوق المُنتجات الدينيّة الكبير الذي تعرضت مراكزه التقليديّة للتآكل، وأصبح أكثر سيولة وتشعباً، حتّى لو كان ثمن هذه الرغبة اندفاع “حماس” للانشغال في استثمار الأموال والوقت والموارد البشريّة، والمزايدة على القوى السلفيّة الوهابيّة والتماهي معها في الوقت نفسه في إنتاج خطابٍ دعويّ رث لتطارد بها شياطينها المُتخيّلة، متغافلة عن شياطين الفقر والعوز والبؤس التي تُدمي وجه غزّة وأهلها كلّ صباح.
الأسلمة في أحد وجوهها هي استراتيجيّة لملء الزمان والمكان اللذين أصبحا قاحلين بطريقة تستعصي على الوصف. فعندما فقدت غزّة روحها، لم يعد الدين صرخة للمظلومين فحسب، بل تنهيدة لأولئك الذين يعيشون على إيقاع الملل الشديد في أيامهم التي تفتقد لأيّ معنى والتي لا تلوح منها أي بارقة أمل. تأتي الأسلمة لتضيف إلى الفراغ فراغاً جديداً، ولتصنع عالما متوهّما من السكينة لجماعة تزداد انعزالا عن الواقع يوماً بعد يوم. لا ينتاب المرء الحزن على رؤية الأطفال الذين وُضعوا في ظرفٍ يحطّ من كرامتهم وينال من مشاعرهم البريئة فحسب، بل ينتابه الخوف أيضا من أن يفتح كلّ هذا الخراب فمه في يومٍ ما ليُطلق وحوشه الضاريّة من أرض تتصارع فيها شياطين الخيال وشياطين الواقع معاً.. والله وحده يعلم كم سيكون ذلك المشهد مرعباً.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]