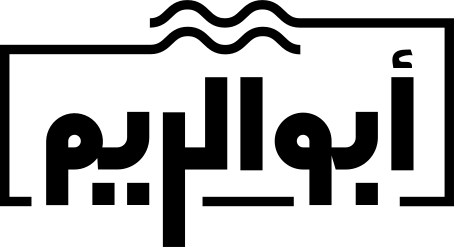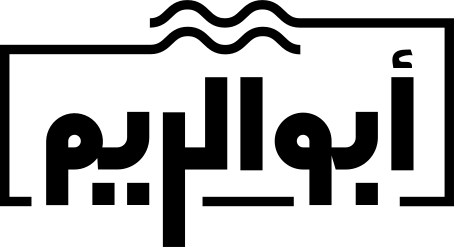[vc_row][vc_column][vc_column_text]نُشرت في جريدة “الأخبار” اللبنانية في 16 نيسان 2013[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]رحلتْ «المرأة الحديديّة» أخيراً. وقد لاحقها إلى العالم الآخر سيلٌ جارف من الانتقادات والتهكّمات ولوعات الاستذكار لأيّامها المشؤومة، كما لاحقتها، بالطبع، صلواتُ التبجيل المحموم من مُتعاطفين ومؤيّدين لمشروعها «التاريخي». مجلّة اليمين الاقتصادي العريقة، «الإيكونوميست»، وفي اتّساق كامل مع خطّها الفكري، نشرتْ صورة تاتشر على غلافها ووسمتها بـ«مقاتلة الحريّة»، فيما انتشرت نكتة أطلقها الساخطون على مسيرة تاتشر تقول، في استحضار واعٍ لنهجها الاقتصادي: «الجحيم تخضع لعمليّة خصخصة الآن». الجدل الذي ارتفع حول تاتشر، ومن قبله حول تشافيز، الذي وصلتْ أصداؤه إلى بلادنا، يُمكن أن يُغري المرء بالقول: إنّ الصراع الاجتماعي ما زال يُحدّد جزءاً كبيراً من نظرتنا إلى واقع حياتنا وعالمنا. أقترح، بدلاً من الحماسة المُفرطة أو الهجاء الظالم للمثالب الشخصيّة لأولئك الذين ترتبط أسماؤهم بمشروعات تغيير اجتماعي نوعيّة، فهم السياق الذي انبثقوا منه وعملوا فيه. أجادلُ بأنّه لفهم هذا السياق، ينبغي للمرء، أن يتخفّف من بعض أعباء «الحسّ الديمقراطي». مقاربة حركة المجتمعات من منظور صندوق الاقتراع وحده تُعمينا عن رؤية صراع القوى الاجتماعيّة والوسائل التي تستخدمها لتحقيق سلطتها السياسية، وبالتالي عن شكل ومعنى وجودنا الاجتماعي الذي تُحدّده لنا منظومة هذه السلطة.
استعادة السلطة الطبقيّة لرأس المال
أُنتخبت مارغريت تاتشر رئيسةً لوزراء بريطانيا في أيّار 1979. وفي آب من العام نفسه، عُيّن باول فولكر مُحافظاً للاحتياطي الفدرالي الأميركي وأمامه مهمّة واحدة: خفض مُعدّل التضخم المرتفع عبر سياسة نقديّة تقضي برفع سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق. لكن، قبل ذلك، أي منذ أواخر الستينيّات، بدا أنّ الاقتصاد الرأسمالي في أميركا وأوروبا على حدّ سواء قد دخل أزمة عميقة أطاحت نموذج «المقايضة الكنزيّة» الذي هيمن على الاقتصاد بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية.
تقوم أطروحة كينز الرئيسيّة على أنّ قوى السوق ستعاني اختلالات في عمليّة توزيع الموارد مما يتطلّب تدخلاً حكومياً نشطاً عبر السياسات الماليّة لضمان مستوى التشغيل الكامل. في ظلّ المقايضة الكنزيّة دُشّن التحالف بين العمل ورأس المال في أوروبا، وشهدت مستويات التشغيل وأنظمة الضمان الاجتماعي والصحّة انتعاشاً غير مسبوق، وامتلكت اتحادات العمال القوة لفرض شروطها في سوق العمل في مواجهة رأس المال، لكنّ هذه الصيغة بدأت بالتآكل، وبدا أن قانون ماركس الرئيسي حول تناقص ربحيّة رأس المال يعمل باطراد بدءاً من عام 1966 حين كان معدّل الربحية هذا يبلغ 24% مُنخفضاً إلى النصف ببلوغ عام 1982. في إنكلترا مثلاً، كانت حكومة العمّال التي أنتخبت عام 1974 في أعقاب إضراب عمال المناجم الشهير، تواجه، إضافة إلى معدلات النمو المُنكمشة وارتفاع التضّخم، أزمة مالية طاحنة تُهدّدها بالإفلاس. حزب العمّال ذاته، الذي يُفترض أنّه يمثّل مصالح «اليسار» البريطاني، وافق على وصفة صندوق النقد الدولي عام 1975، لتبنّي سياسات تقشّف قاسية في المالية العامّة. لقد عمل حزب العمّال، آنذاك، ضدّ مصالح قاعدته الاجتماعيّة، التي انتفضت ضدّه حتى نهاية السبعينيات، التاريخ الذي وصلت تاتشر فيه إلى الحكم بدعم كبير.
بالنسبة إلى دارسي التطوّر الرأسمالي في العقود الأخيرة، يمثّل «انقلاب فولكر» عام 1979 التاريخ الرمزي لعهد النيوليبراليّة الجديدة. طلابُ الاقتصاد حول العالم يعرفون تلك العلاقة العكسية الشهيرة، التي يُعبّر عنها منحنى فيليبس، بين مستوى التضخّم والبطالة. حين تتخذ السلطات النقديّة قراراً باستهداف التضخّم عبر رفع أسعار الفائدة، عليها أن تدفع ثمن ذلك ارتفاعاً في مستويات البطالة وانخفاضاً في معدلات الاستثمار. كان قرار فولكر، الذي استوحته تاتشر في ذات الوقت، أكثر من سياسة نقديّة في الواقع، كان حرباً بشكل أو بآخر. لقد أُدخل الاقتصاد الرأسمالي في أميركا وإنكلترا بالكامل في حالة ركود خلال الثمانينيات، لصالح تعضيد مصالح الرأسمال الذي كان يرى أن معركته تستلزم إنهاء إرث دولة الرفاه، والقضاء على اتحادات العمّال (عبر استغلال نسب البطالة المرتفعة) وإعادة هيكلة الاقتصاد على أساس برامج الخصخصة التي طبّقتها تاشر في كلّ المجالات تقريباً.
الديناميّة التي أطلقها رفع أسعار الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي آنذاك تكشف عن وجه آخر للطريقة أعيد من خلالها تشكيل العلاقة بين رأس المال والعمل. حين ترفع سعر الفائدة فأنت تمنح أرباب الصناعة الماليّة الفرصة ليحشدوا المدّخرات ويعيدوا ضخّها في الأسواق على شكل قروض ومنتجات ماليّة أخرى على حساب الاقتصاد الحقيقي. هذا يفسّر اليوم الصعود غير المسبوق للقطاع المالي والصناعات المرتبطة به في بنية الاقتصاد الرأسمالي، ويفسّر الأهميّة التي تحتلّها «توزيعات الأرباح» لحملة الأسهم كنمط للإثراء الشخصي في نظر قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى في الغرب. لا يُمكن لشيء أن يكون أكثر كشفاً من الأرقام، ففيما كان الـ1% الأثرى في الولايات المتّحدة الأميركية يملكون 35% من مجمل الثروة هناك قبل السبعينيات، انخفضت هذه النسبة إلى ما يقرب من 20% خلال السبعينيات، عقد الأزمة، قبل أن ترتفع أعلى من مستواها القديم مع تسيّد النيوليبرالية. بالنسبة إلى جيرارد دومينيل ودومينيك ليفي، الباحثين الفرنسيّين اللذين درسا بالتفصيل الطور النيوليبرالي في الرأسماليّة الحديثة، ليست النيوليبرالية، في المحصّلة الأخيرة، سوى مشروع سياسي استهدف إعادة السلطة الطبقيّة لرأس المال، ليس على مستوى الاقتصاد الغربي فحسب، وإنّما عبر العالم أيضاً.
تشافيز وأشباح تشيلي
لم أكن مُتحمّساً لموجة صعود اليسار في أميركا اللاتينيّة في العقد الأخير. وفي الحالة الفنزويليّة، كانت شكوكي أعمق حيال مشروع إشتراكي بديل، بالنظر إلى بنية الاقتصاد الفنزويلي القائم على الريع. تقول نظريّة الاقتصاد السياسي الشهيرة حول «الدولة الريعيّة» إنّ هذه الدولة، وبالنظر إلى اعتمادها على الريع، تميل لأن تعمل باستقلال عن مجتمعها المدني، بحيث يتحوّل الحاكم إلى مجرّد مانح للعطايا لرعايا لا مواطنين، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من ميل استبدادي لدى السلطة، وإفراغ الاقتصاد من أيّ مضمون حقيقي، كاقتصاد متحمور حول قاعدة صناعيّة أو زراعة متطوّرة.
كان تشافيز قد استغلّ موارد بلده النفطيّة، وارتفاع سعر النفط في السنوات الأخيرة، لتكوين تحالف اجتماعي مُرتكز على الطبقات الشعبيّة والشرائح المتدنية من الطبقة الوسطى. كان هذا يُساعد تشافيز على ردّ محاولات خصومه لإسقاطه، لكنّه، على الجانب الآخر، كان يُشجّعه على اتّخاذ خطوات لجعل سلطته غير مُقيّدة، وعلى اختراق قواعد «اللعبة الديمقراطيّة»، وقد كنتُ أنظر إليه بريبة شديدة لحين تعرّفي على سلفادور الليندي.
في 11 أيلول عام 1973 كان قصر لاموندا الرئاسي في العاصمة التشيليّة سانتياغو مُحاصراً بقوات عسكرية يقودها قائد الجيش أوغست بينوشيه، وهناك، قُتل سلفادور الليندي بعد رفضه الاستسلام. كان الليندي سياسياً تشيلياً إشتراكياً، انخرط في الحياة السياسية لبلده بفاعلية، وترشّح لمنصب الرئاسة أكثر من مرّة وفشل، قبل أن ينجح في انتخابات ديمقراطية، على الطريقة الليبرالية، عام 1970. برنامجه ذو الميول اليسارية لم يرق جماعات مصالح الأعمال ولا الولايات المُتّحدة بالطبع، فدُبّر له انقلاب عسكري دموي فتح الطريق أمام دكتاتوريّة بينوشيه، التي دامت أكثر من ربع قرن، لكنّ القصّة لم تنتهِ هنا، بل بدأت، بالتحديد، مع «فتيان شيكاغو»، وهم مجموعة الاقتصاديّين التشيليين، الذين أوكل لهم بينوشيه عام 1975 إعادة هيكلة الاقتصاد التشيلي واستعادته إلى الحظيرة النيوليبرالية.
قصّة «فتيان شيكاغو»، كما يرويها ديفيد هارفي، الأكاديمي الماركسي المعروف، في كتابه عن النيوليبرالية، مثيرة بالفعل. في الخمسينيّات موّلت الولايات المتّحدة، في أجواء الحرب الباردة، برنامجاً تعليميّاً لمجموعة من الطلبة التشيليّين في جامعة شيكاغو في علم الاقتصاد، لمواجهة التوجهات اليسارية الطاغية في أميركا اللاتينيّة. هيمنت هذه المجموعة على الجامعة الكاثوليكية الخاصة في سانتياغو، وارتبطت بمجتمع الأعمال التشيلي الذي موّل أنشطتها البحثيّة عبر مراكز بحث مُختلفة. فتح هذا الطريق أمامهم لتقلّد مواقع في حكومة بينوشيه، ليبدأوا برنامجاً واسعاً لخصخصة القطاع العام وفتح تشيلي للاستثمارات الأجنبيّة، بوحي من أفكار ميلتون فريدمان، أيقونة جامعة شيكاغو، وصاحب المدرسة النقديّة، التي تُمثّل الأساس النظري للنيوليبراليّة، وهو البرنامج الذي انتهى بسقوط تشيلي في أزمة الدين التي ضربت أميركا اللاتينيّة في 1982.
الصراع الاجتماعي والديمقراطيّة
ليس هذا بياناً ضدّ الديمقراطية، وإنّما هو دعوة إلى التجاوز، تجاوز تلك النظرة الضيّقة التي تُقارب نجاح كل مشروع للتغيير الاجتماعي من منظور مطابقته للقواعد الإجرائية للديمقراطية الليبرالية كما استقرت في الغرب. إنّ الديمقراطية الليبرالية تبدو الشكل الأكثر نجاعة لإخفاء تناقضات الصراع الاجتماعي القائم عبر استيعاب هذا الصراع ضمن مؤسّسات جرى تأسيسها تاريخياً لمصلحة اليمين، كما في حالة المشروع النيوليبرالي المُتسيّد في الغرب وعبر العالم. ضمن هذه الدينامية المُستمرة لفرض الشرط الليبرالي، جرى تحويل طبقات اجتماعيّة لها مصالح مُحدّدة إلى مجرّد «هيئة ناخبة» تذهب إلى صناديق الاقتراع على نحو دوري دون أن يكون لهذه العمليّة أيّ معنى على صعيد انحيازات المؤسّسة القائمة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، فاليسار واليمين في ظل النموذج الغربي للديمقراطيّة يلتقيان عند منطق «إدارة» الشأن العام بمنطق الاحتراف المهني، أو الإدارة الخبيرة، أو منطق «السياسة بلا سياسة» كما يقول عنها الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك.
لقد جرت عملية «لا تسييس» جذريّة للفضاء العام في ظل النيوليبرالية، والقضاء على أيّ نوع من أنواع الجماعيّة، وهو ما يتجسّد في تجزئة النضالات السياسيّة والحقوقيّة اليوم في الغرب (المثليّين، النسويّة، أنصار البيئة، الطلبة .. إلخ) وتحوّلها إلى جزر معزولة بسبب غياب سرديّة كبرى تلمّ شتاتها في مشروع متكامل لتجاوز الاستعصاء التاريخي الذي وصلت إليه الديمقراطيّة في ظروف الطور النيوليبرالي للرأسماليّة. قد يكون تشافيز مُستبداً شعبوياً بالنسبة إلى كثيرين، وقد تكون تاتشر امرأة حديدية بلا شفقة، لكنّهما في المحصلة، نتاج مشروعين للهيمنة الاجتماعية والسياسية، لا يكفي صندوق الاقتراع لفهمهما على نحو كافٍ، فضلاً عن تقويمها من وجهة النظر هذه.
ليست عمليّة القبول العام عمليّة منفصلة عن سياق سعي قوى بعينها إلى الهيمنة عبر المُجتمع المدني، واستدخال قيم بذاتها وتحويلها إلى «Mainstream» أو جعلها جزءاً من الحسّ العام، كما أكّد غرامشي. لقد أنفق الرأسمال في أميركا ملايين الدولارات على مراكز بحث متّصلة بكليّات الأعمال في هارفارد وستانفورد، فضلاً عن الأموال التي تُضخ في الإعلام، لصناعة قبول قيم السوق كقيم طبيعيّة لدى الجمهور، وفي ضوء هذه العمليّة تبدو الطبيعة الإجرائيّة للديمقراطيّة كنظام سياسي مجرّد تفصيل بسيط. أيّ مشروع حقيقي لليسار اليوم، في الظروف التاريخيّة القائمة، بما فيها ظروف أزمة النظام الرأسمالي، وفي بلدان مثل بلداننا، حيث نشهد افتتاح عهد السياسة مُجدّداً بعد مُصادرتها لعقود، يجب أنّ يدرك أنّ المهمّة ليست الانخراط في شروط الترتيبات الديمقراطيّة في صورتها الليبرالية، وإنّما في التعبير عن المصالح الاجتماعيّة وصياغة مشروع للدفاع عنها وفرض برنامجها ووضع تصوّر شامل لنموذجها التنموي المُحتمل في الاقتصاد أيضاً. لا يجوز لغواية الذهاب إلى صندوق الاقتراع دوريّاً أن تحجب عنّا حقيقة السياسة كتعبير صافٍ عن الصراع الاجتماعي.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]